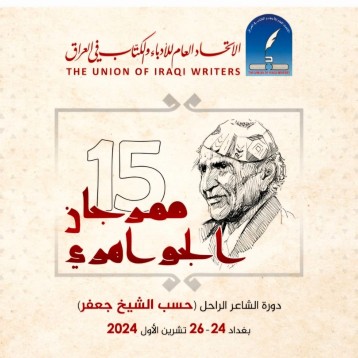جنان الحسين
صحت أمي من نومها على الرغم من استسلامها المطلق ليلة أمس لأوجاعها؛ فزعة من نُواحي، وصراخ أبي الذي نهش رؤوسنا، وكأن نارًا شبّت للتّو تحت قدميه؛ منهمكا في رمي ملابسنا على الأرض حتى أفرغ الخزانة من محتوياتها، ولم ينتبه لبكاء ضيفتنا الجديدة!
أخذها أخي الصغير بحنو إلى صدره وهو يهدهدها، كي تكفّ عن البكاء: انظر يا أبي؛ لقد أنجبت أمي ليلة أمس عروسا جميلة، وسميناها ميرفت كما كنت تتمنى، عيناها واسعتان، تُحوّطهما رموش كثيفة، وشعرها ناعم، ويداها حانيتان… لم تظهر على ملامح أبي أي علامة تدل على ابتهاجه؛ رد باقتضاب خال من الدّهشة: مبارك.. رغم أنه كان يقول لأمي دومًا: كم أتمنى أن تنجبي لنا ملاكًا يشبه ميرفت أمين، كم أحب هذه الجميلة! وهو ينظر إليها متبسّمًا من خلف نظارته السميكة.
جثمت المخاوف على صدري، حتى كادت تخنق أنفاسي! أبي لم يكن عصبيا بهذا الشكل، أو عنيفا نحونا، ففي داخله حب متساو للجميع، رغم قسوة الحياة، ورغم أننا أسرة كبيرة، وعدد الإناث يفوق عدد الذكور، إلا أننا نتكدّس في غرفة ضيقة وكئيبة، متوسطة العلو، داخل حي فقير من مدينة حلب القديمة خالية من الأثاث، إلا من خزانة مخلوعة الأبواب، وفراشان كبيران بدون ملاءة؛ مضاءة بلمبة صفراء وسط سطح أصيب منذ زمن بعاهة مستدامة، وجدران كأنها خاضت حرب السفر برلك!. لا أعرف لِم أختي الوسطى والتي هي أشدّنا نحالة وطيبة، عندما تغمض عينيها تصبح شقيّة! أعرفها منذ أبصرت عيناها الدنيا، مولعة بالقطط، ولا تنام دون قطتها السوداء، رغم تشاؤم أمي من لونها، وموائها الدائم. لم أفهم سر ارتدائها دومًا ثوبًا ضيقًا وطويلًا!؟، ربما لتخفي قِصَرها كما نصحتها جدتي لأبي ذات مرة، فهي الوحيدة التي تساعد أمي في أعمال البيت، وإعداد الطعام؛ وتظل لصيقة أبي طالما تواجد بيننا، لكن؛ يومها دخلت المطبخ ولم تفصح عن سر اضطرابها، ودون أن ترحب بعودة والدي على غير عادتها! تشاغلت عنه بقلي البيض لإخوتي الصغار، فهي تعده بطريقة لذيذة، وقطتها تؤرجح ذيلها، وتحوم في زوايا المطبخ.
انتهى والدي من حملة التفتيش؛ ولم يجد شيئًا! وبدا عليه التعب ولم تعد به القدرة على حمل جسده، تقدم مني بنزق بضع خطوات بعينيه المتطايرتين شررًا، وصفعني بكفه المرتعشة، ثم خرج ويداه فوق رأسه، ناظرًا للسماء منفّسًا عن غضبه: إلى متى ستظل هذه البنت مهملة!؟.. لن يسمحوا لها بالدخول إلى قاعة الامتحانات دون تلك البطاقة اللعينة. كنت أسمع صوت الهواء وهو يسحبه بقوة إلى رئتيه المنهكتين كأنها لحظة خروج الروح.
كانت المرة الأولى التي أتذوّق فيها طعم الوجع من أبي؛ تمنيت لو أني بكيت لكني حبست دموعي في مقلتيّ متصلّبة في زاوية الغرفة كدمية بلاستيكية! أنظر إلى قدميّ أمي المبللتين بدم المخاض، وأرغب بالموت. اقتربت تلك الشقيّة من أمي بعد أن تنحنحت مرتين، وهي تعبث بأنفها: أنا أعرف أين بطاقة أختي، لمحتها البارحة، لكن.. لا أعلم من دسّها تحت فراشك!
ركضت أمي وهي تسند بطنها بكلتا يديها، قلبت الفراش وصاحت بصوت مرتجف: ها هي البطاقة! وجدناااااها.
انفرجت أسارير أبي قليلا، وزال عنه بعض الغضب، سحبني بيده المرتجفة، باتجاه الشارع الرئيس، علنا نحظى بسيارة أجرة، تقلنا لمركز الامتحان.
كان أهل الحي جميعهم نيام، وكان صوت فيروز ينداح من مذياع السيارة، كأنه يسابق رفيف قلبي، الذي لم يكن يحمل داخله سوى أمنيّة واحدة، هي أن أصل مركز الامتحانات الإعدادية قبل نفاد الوقت.
أوصلنا السائق أمام مركز الأرسوزي بسرعة جنونية، بعد أن مازح أبي: إذا خالفتني شرطة المرور ستدفع الغرامة أنت يا عم، تبسّم والدي بوجه السائق قائلا: تكرم عينك… تقدمت من أبو هيثم آذن المدرسة مذعورة، أشد أصابعي في عنف: صباح الخير، رد صارخا: “ليش كل هل تأخير؟! كل الطلاب صاروا داخل القاعات؛ شو هل جيل! طلاب آخر زمن”…. صدمت من كلامه، وتراجعت تجاه والدي الذي كان يدور حول نفسه في الشارع، متجمد العينين تجاه باب المدرسة، صاح أبو هيثم ثانية وهو يومئ لي بيده: “تعالي …تعالي… وين راجعة، أنا رح دخلك لقاعتك، لسا في خمس دقايق”. أخذت أجرجر قامتي المنهكة من الخوف والسهر تجاه سلالم الطابق العلوي، وأنا أحمل داخلي هدوءًا كاذبًا.
ضجيج الطلبة كان يخفت شيئا فشيئا، صاح المراقب بحنق: “صح النوم يا خانم؛ لسه بكير؛ ياعينيييييي وجايه بالشحاطه كمان؟! فوتي لمقعدك فوتي؛ بدنا نوزع ورق الامتحان خلصينا”… نظرت من النافذة بروحي المتورمة، حاولت أن أنادي أبي لأخبره أني داخل القاعة، لكن صوتي غاب تماما؛ وزاد إحساسي بالاختناق، وغامت من حولي الأشياء.
*عن ضفة ثالثة