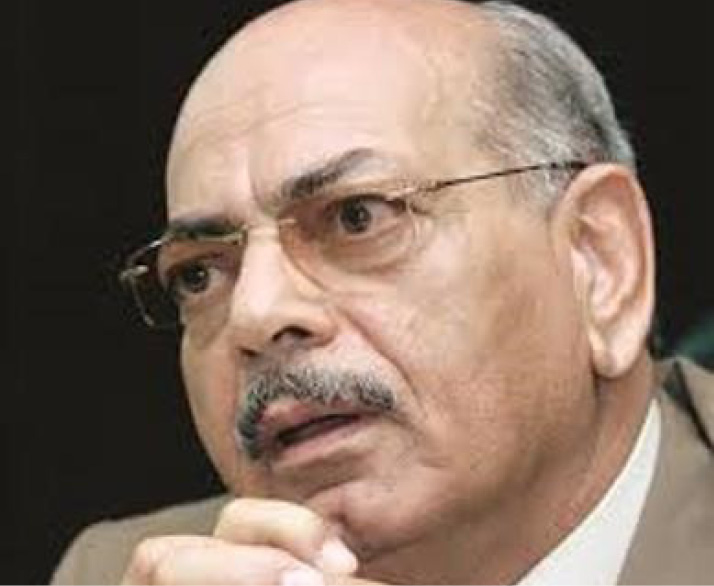حاوره: محمد الحمامصي*
انطلاقاً من أوائل سبعينيات القرن العشرين تواصل تجربة الشاعر والناقد العراقي د.علي جعفر العلاق العطاء إبداعا ودراسة ونقداً وحضورا فاعلا متميزاً في الحراك الثقافي العربي، فقد قدم للشعر العربي اثنتي عشرة مجموعة شعرية شكلت خصوصية في سياق التجربة الشعرية العربية، استحق بها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل الشعر، الدورة السادسة عشرة 2018-2019، حيث أكدت لجنة الجائزة «تميزه وإسهامه المتواصل في تغذية الشعر العربي المعاصر بما هو متجدد في صور بلاغية مدهشة ومخيلة واسعة وصلت ما بين تراثنا الحضاري وواقعنا الثقافي، ولدوره في تعميق الحوار الشعري بين الهويات والثقافات المختلفة، مما أسهم في تطور القصيدة العربية ووقوفها راسخة في صف القيم الكونية من عدل وكرامة وإخاء.»
وفي النقد قدم العلاق ما يزيد على ست عشرة دراسة جلها كانت حول الشعر والرواية، وقد كانت تجربته الشعرية والنقدية موضع اهتمام الكثير من النقاد والدارسين، وكُتِبتْ عنهما اثنتا عشرة رسالة وأطروحة للماجستير والدكتوراه، في الجامعات العراقية والمصرية والأردنية. هذا إضافة إلى عمله الأكاديمي ومشاركته عضوا في العديد من لجان التحكيم الشعرية والنقدية العربية منها مثل جائزة الملك فيصل، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة الإبداع الشعري العربي بالقاهرة.
حيثيات منح العلاق لجائزة سلطان العويس أكدت على تميزه بتقديم نصوص حافلة بأسئلة إنسانية كبرى وحالات شعرية متنوعة، صاغها في لغة مقتصدة مكثفة، مستلهما ذاكرة الطفولة والقرية وأساطير بلاد الرافدين، وتفاصيل الحياة اليومية لبناء رؤية عميقة تنضح بمعاني الفقد والانكسار. وقد كان له دور متواصل في تجديد القصيدة العربية، والتنويع في بنيتها وأغراضها، فأضاف طاقات بلاغية وإيقاعية أسهمت في إثراء مخيلتنا الجمعية، وحققت قدرا من الإدهاش الجمالي.
التقينا العلاق بمؤسسة العويس بإمارة دبي وكان هذا الحوار حول هذه التجربة الثرية بعطاءاتها شعرا ونقدا وحضورا في الحراك الثقافي.
بداية يلقي العلاق على المراحل المفصلية في مسيرته الممتدة تقريبا على مدار أكثر من أربعين عاما، يقول: حين أتحدث عن مفاصل دالة في تجربتي الشعرية فلا يمكنني أن أتجاوز مجموعتي الأولى «لا شيء يحدث .. لا أحد يجيء» الصادرة عام 1973، التي فاجأت الكثيرين بما جاءت به من جرأة في اللغة، وخرق للمألوف في بناء الصورة. هذه المجموعة التي وصفها الشاعر فاروق يوسف بأنها فتح في الشعرية العراقية.
والمفارقة أنها صدرت في حمى الصراع من أجل قصيدة المعنى، والموضوع، والفكرة. كان الهتاف اليساري والهتاف القومي كلاهما يملأ المشهد الشعري في العراق. في ذلك الجو كنت أسعى، ومنذ البدايات، إلى قصيدة خاصة كانت تبالغ أحياناً في تجريبها اللغوي، ومجافاة المعنى الأيديولوجي. كنت، كما قال الراحل فوزي كريم، لا ألتفت إلى الآخرين، بل أعود باللغة إلى براءتها الأولى لتكون أشد بدائية. وهكذا حملت تلك المجموعة الكثير مما يشير إلى القصيدة التي أسعى إلى كتابتها. وظللت، في المجموعات التالية، أحاول بإصرار تعميق ما بدأته في المجموعة الأولى. وهنا يمكنني الإشارة إلى مجموعات بعينها لأنها اسهمت في تقريبي من قصيدتي التي تمثلني إلى أكبر حد ممكن: في مجموعتي الثانية «وطن لطيور الماء» 1975 مثلاً، بلغ شغفي الصوفي بالطبيعة ذروته. في حين مثلت «أيام آدم» انعطافة إلى الحقيقة الكونية القاهرة من خلال الجسد وسطوة الزمن عليه. وكانت مجموعة «ممالك ضائعة» صرختي الكبرى وأنا أرى الجمال يتلاشى والفراديس تضيع تباعاً، كما أن مجموعة «ذاهب لاصطياد الندى» تقطير للغة والتماعاتها البعيدة. وكنت في «نداء البدايات» و»حتى يفيض الحصى بالكلام» ثم «وطن يتهجى المطر» كمن يستنهض شعرية الطفولة وتفاصيلها التي كانت وما تزال تومض وتختفي في أقاصي الخيال والذاكرة. أما مجموعتي الأخيرة «طائرٌ يتعثّرُ بالضوء» فهي توسيع لمبنى النص وتعدد خصائصه الإيقاعية والدلالية.
وحول رؤيته لحركة الشعر العربي انطلاقا من أن فترة السبعينيات شهدت حالة تمرد على جيل الريادة بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وصلاح عبدالصبور، وشهود الثمانينيات حالة تمرد أخرى متمثلة في قصيدة النثر. والآن هناك حالة أقرب للصراع بين أشكال القصيدة، يرى العلاق أن حالة الصراع هذه بين الأشكال الشعرية ظاهرة لا تمت بصلة متينة إلى الإبداع الذي يتطلب، كما أعتقد، العمل على النص الشعري بكد ودراية ومحبة. بدلاً من الصراع الذي يأكل كثيراً من عزلة المبدع وانصرافه إلى الاشتغال على مشروعه بعيداً عن الصخب وضجيج المناكفات. إن قصيدة النثر، نص إبداعي حقيقي، ويمثل المنجز النثري لكتابها الموهوبين جانباً مهماً من حيوية القصيدة العربية، غير أن الكثير مما يكتب تحت هذه اللافتة قد لا يكون قصيدة نثر حقيقية، بل هو نثر جميل، لكننا قد نجد نظائره في أي نص إبداعي آخر، أقول هذا الكلام وأنا من الذين احتفوا بقصيدة النثر، ممثلة بنماذجها المتقدمة، وقد كتبت في كتابي الجديد «المعنى المراوغ»، عن اثنين من كتابها المميزين: سركون بولص وأمجد ناصر. وقبل هذا الكتاب كنت قد كتبت عن محمد الماغوط وميسون صقر.
ويشير العلاق إلى أن القول بأن قصيدة النثر ممثلة للتمرد الشعري، أو ذروة الحداثة الشعرية قول يجافي الحقيقة، فهي ليست جديدة، على حداثة القصيدة العربية. إنها أقدم من قصيدة التفعيلة. فما كتبه أمين الريحاني وجبران خليل جبران مثلاً، وهو التمهيد الأمثل لقصيدة النثر وأن كان بتسميات مقاربة كالنثر الشعري أو الشعر المنثور، سبق قصيدة التفعيلة، التي كتبها السياب وجيله، بفترة ليست قصيرة.
وعن تأثير دراسته الأكاديمية ودراساته للشعرية العربية وانشغالاته الأكاديمية وبالعديد من المهام كرئاسة تحرير مجلة «الأقلام» وغيرها على تجربته الشعرية سواء سلبا أو إيجابا، يؤكد العلاق أن «البحث النقدي في الشعرية العربية، أو التأمل في تحولاتها جعلني على تماس دائم مع جزئيات العمل الشعري وديناميكية حركته، وزودني بالوعي التفصيلي به مما ترك النوافذ مفتوحة، وتبادل الخبرة قائماً بين ما أكتبه وما أكتب عنه. ويمكنني القول إنني كنت أسهم في أثناء عملي الأكاديمي في تنمية عقلية جديدة وذائقة مختلفة، لأجيال تنهض وتتساءل وتقرأ وتكتب. كما كنت، من خلال البحث والمؤتمرات، أسعى إلى تحقيق ما يتطلبه التدريس من بسطة معرفية بالعصور وما أنتجته مخيلة الأسلاف وعقولهم الخصبة. أما العمل في مجلة الأقلام فقد وجدت فيه خلاصاً من محنة الوظيفة التقليدية ورتابتها، كنت، في المجلة، أتحرك في صميم الحياة الثقافية، وعلى تماس حي ويومي مع منتجي النصوص والمشتغلين على دراستها أو المنخرطين في العمل النقدي تأملاً وممارسة. وهذا التعدد في الاهتمامات قد يحد، نظرياً، من مساحة الكتابة، لشاعر ما، لكنه لا يحد من إضافاته النوعية التي لا يعوضها الكم مهما كان حجمه.
ويفسر العلاق ظاهرة الجمع بين: الشعر والاكاديمية والتي تكرّرت مع شخصيات: أدونيس، عبدالعزيز المقالح، سلمى الجيوسي ونازك الملائكة وعبدالله الغذّامي وغيرهم، لافتا إلى أن هذه الظاهرة كانت ترافق الآداب في كل زمان ولدى الأمم جميعاً. وهي ناتج طبيعي بل حتمي لعملية الإبداع ذاتها، فهذه العملية تخلف في النفس الكثير من الأسئلة، والتأويلات والتصورات، ووجهات النظر حول الموهبة، والإبداع، ومحفزات الكتابة. وذلك كله يدفع بالشاعر إلى الكشف عنها عن طريق الكتابة النقدية. إضافة إلى ذلك فإن القصيدة لا تتسع للكثير من هذه الأفكار نظراً إلى استعمالها لغة خاصة، تضيق بالشرح والتعليل المنطقي، وتقوم على الإيجاز والتورية والاستعارة. وهكذا يرحّل الشاعر هذا الفائض عن قصيدته إلى لغة أخرى، هي لغة النقد ليقوم هذه المرة بدور نقدي بعد أن كان يقوم بدوره شاعراً. وهناك عدد من الكتب التي تفرغ مؤلفوها إلى تفحص هذه الظاهرة، أعني الجمع بين الشعر والنقد في الذات الواحدة. أول ما أتذكره في الشأن كتاب الشاعر والناقد العراقي علي المرسومي بعنوان: «الشاعر العربي الحديث ناقداً: أدونيس والمناصرة والعلاق انموذجاً»، وكان هذا الكتاب، في الأصل، رسالة دكتوراه تناول فيها الكاتب التجربة النقدية لدى هؤلاء الشعراء الثلاثة. كما أن الناقد العراقي الدكتور خليل شيرزاد أصدر كتاباً عن الشعراء النقاد تناول فيه تجربة عدد من الأسماء العراقية التي جمعت بين هاتين الممارستين. وأتذكر أيضاً كتاباً للشاعرة التونسية ريم العيساوي عن تجربة الشابي ناقداً، وكتاباً آخر للناقد د. فاروق سليم عن المعري ناقداً.
وبسؤاله: لك آراؤك الطليعية، وموقفك النقدي الذي يحتفل بالتجاوز والتجديد، غير أنك في كتابة الشعر مازلت مخلصاً لقصيدة التفعيلة، كما أن قصائدك تحتفي أيما احتفاء بالموسيقى والإيقاع، كيف تفسر هذا الأمر؟ يقول العلاق: ربما ينطلق هذا السؤال من قناعة مسبقة، أو رأي محسوم سلفاً، يرى أن قصيدة النثر هي بدء الإبداع ومنتهاه، وأما ما عداها فهو شعر منقوص، مشكوكٌ في شعريته، ولن يبلغ نضجه الجمالي إلا ببلوغه مرتبة قصيدة النثر. وأنا، هنا، لا أجاريك في هذا الرأي المتحمس، فهو رأي يفتقر إلى الواقعية، ويستعصي على الفحص والبرهنة. وأعود إلى ما قلته في البداية. يبدو الأفق الشعري أحياناً وكأنه ملبد بغبار النثر وهو نثر يبدو في بعض نماذجه نثراً جميلاً، لكنه لا يرقى إلى ما عرفناه من قصائد النثر العالية. النثري لا الشعري هو الذي يتسيد مشهدنا الراهن تقريباً، وهذا ينطبق على قصيدة الوزن وقصيدة النثر في نماذجهما الشائعة اليوم. وبرغم ذلك ما تزال قصيدة الوزن حاضرة بقوة، وتقدم من عناصر الشعرية ما يمكن فحصه والبرهنة عليه لغوياً وإيقاعياً. إن ما كتبه محمود درويش، على سبيل المثال، برهان شعري لا يمكن دحضه. كما أن مجد أدونيس الشعري لا ينهض، في معظمه، إلا على قصائد الوزن الكبرى: هذا هو اسمي، الصقر، الرحيل في مدن الغزالي، مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف، إضافة إلى قصائد الوزن في أغاني مهيار الدمشقي، والمسرح والمرايا، وفي ديوانه الكبير «الكتاب» بأجزائه الثلاثة.»
ويضيف: بالنسبة لي، لا أرى في الإيقاع زينة أو حلية شعرية، مع أن الأمر قد لا يكون كذلك لدى البعض من كتاب قصيدة التفعيلة. لذلك فإن الإيقاع مكون شعري وبنيوي، يدفع بالنص إلى نضجه الجمالي والدلالي وتماسك نسيجه. وفي المقابل فإن كتابة القصيدة بالنثر لا تضمن مستوى شعرياً عالياً بالضرورة. بل يتوقف ذلك على قوة الموهبة ووعي الشاعر بلعبة البناء الشعري واشتراطاته الصعبة.»
ويرى العلاق أن المشهد النقدي العربي لا يمكن الحديث عنه في هذا الحيز الضيق، كونه مشهدا مركبا وعلى شيء من التعقيد. رؤى متباينة، اتجاهات لا رابط بينها، أجيال تتصارع، منهجيات شتى. ويوضح: لا شك أن هناك أسماء نقدية لافتة في مشهدنا النقدي، غير أن الحديث عن جيل من النقاد يبدو حديثاً مفرطاً في التفاؤل، لأن مصطلح الجيل لا يقوم إلا على المشتركات من الرؤى والمناهج والمقاربات التي لمسناها عند الكثيرين من نقاد الأجيال السابقة.
سلوكان خاطئان، يتوزعان
على جبهتي الكتابة الشعرية
وحول رؤيته لمتابعة حركة النقد تجليات الحركة الشعرية وبشكل خاص قصيدة النثر وموقفه من حضورها الواسع بين شتى الأجيال الشعرية، يلفت العلاق إلى أن النقد لا يفعل ذلك دائماً. فهو، في الغالب، نقد مكتف بذاته، ومفتون بالحديث عن نواياه ونرجسياته برطانة يتعذر فهمها أحياناً. وربما يمكنني القول إن لقصيدة النثر حظوة أكبر لدى النقاد، إما لأن الحديث عنها يصعب التثبت منه كالرقص في الظلمة، أول أنه لا يخلو من شبهة المجاملة أحياناً. أما قصيدة الوزن، فانفض عنها الكثير من النقاد، لأن الحديث عنها يتطلب من الناقد الوعي بالإيقاع، ونظام التقفية، والتوازنات التركيبية، والتنوع الإيقاعي، ولعبة البحور المركبة، والطاقة الصوتية للغة. أخشى أن أقول إن كتابة النصوص النثرية أو الكتابة عنها، صارت مهمة سهلة كما يبدو لدى نقاد كثيرين. فهي تكاد أن تكون كتابة إيمانية، تبشيرية، من دون براهين نصية في أحيان كثيرة. أما الحضور الواسع لهذه النصوص فربما يصلح، أحياناً، حجة عليها وليس لها. وما أخشاه أن هذا الإقبال الكبير على كتابة النثر ليس ناتجاً، كما يبدو، عما تتكشف عنه من سحر، أو نباهة، وإنما عن إغراء السهولة، أو التبسيط الذي دفع البعض إلى الإقبال على كتابة قصيدة النثر من دون وعي لصعوبة هذه القصيدة ومتطلبات كتابتها.
ويبدو لي أن هناك سلوكين خاطئين، يتوزعان على جبهتي الكتابة الشعرية، قصيدة الوزن وقصيدة النثر، ويبسّطان ما يكتنف الإبداع عادة من مشقة خلاقة. قصيدة موزونة يكون التزام النظم فضيلتها الوحيدة، ونص نثري لا فضيلة له إلا ترك الوزن ومجافاة الإيقاع.
وأخيرا وعن متابعته حركة الشعر في العراق اليوم ورؤيته لها مقارنة بمراحل سابقة، يقول العلاق: بالنظر لغيابي عن العراق منذ 1991 حتى الآن فإن معرفتي بالمشهد الشعري ليست معرفة تفصيلية بالقدر الكافي للأسف الشديد. كما أن هناك جزءاً لا يستهان به من الجسد الشعري العراقي يكتب خارج العراق، بعد أن توزع الكثير من الشعراء العراقيين، منذ خمسين عاماً تقريباً، على المنافي القسرية أو المختارة. أما ما يكتـب في داخل العراق فهو شعــر المحنـة بامتيـاز، محنـة البلد الذاهــب إلى الغيـاب أو التشظــي. ومـع ذلــك يظل للشعرية العراقية سحرها العصـي علـى التفسيـر طـوال العصـور. فهـي برغـم الغربــة والضنك والحـروب والقمــع، تظـل بيئة شعريـة ولادة للشعـراء المميزيـن والشعـر الجديـر بالبقـاء.
- عن موقع ميدل أيست أون لاين