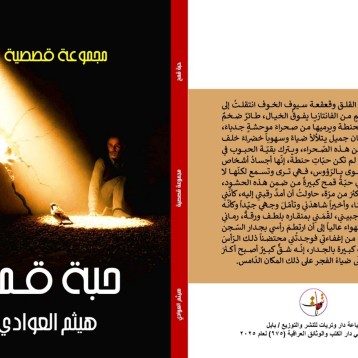أحمد الشيخاوي
إنه وبتأمل المشهد الشعري العربي الحديث، في شقّيه الفصيح والنبطي، نخلص إلى جملة من الحقائق، خاصة في ما يتعلق بمحاولة خلق المقارنة ما بين هذين النوعين التعبيريين، مع الوعي الكبير بواقع الانتشار السريع والهستيري والعفوي للقصيدة النبطية، على حد تعبير إخواننا المشارقة، كون التسمية تختلف معنا نحن، وفي معجمنا نحن المغاربة، لتأخذ عنوان الزجل، وتجدّف ضمن أفلاك دلالاته، ولوضع طرحنا في سكته الصحيحة، فلنقل أو لنسلم بإبداع اللهجات، وما يطبع مناخاته من شعبوية واضحة وقابلية أكبر للتجاوب، ربطا بإشكالية الأمية المستشرية والمتفاقمة والمتمكنة وبأرقام قياسية في أوطاننا الرازحة تحت نير العديد من مظاهر التخلف، لذا غالبا ما نلمس هيمنة هذا الأخير على الشعر الفصيح، ما يفسر هجرة كثيرين إلى فضاءاته، وفي أقل الأحوال، تبنّي الممارسة المزاوِجة بينهما، وفي تقديري، العملية تكون أجدى وأنجع، عندما يكون الانتقال نكوصيا، في معناه الإيجابي، بالطبع، أي الهجرة من الفصيح إلى العامي، لا العكس.
تلكم هي التجارب القوية المتأسسة على فعل النهل من الإرث الشعري الفصيح الدسم والثري المنعكس بالإيجاب، على المنجز الممهور بإبداع اللهجات، في توصيف أدق، منّا لها، تماما مثلما أسلفنا.
ولعل من بين أهم تلكم التجارب الغنائية التي تزكي ما تمت الفذلكة له، من لدنا، بهذا الصدد، نطالع ما أنجزه الشاعر الغنائي اليمني المتمرّس، رفيق الرضي في أبهر محاولاته لسكب عصارة حياتية كاملة، في عروق هذا الجنس المحبوب والأكثر مقروئية، باعتماد ما أبدعه في ثلاثة أجزاء تحمل العتبة ذاتها: راعي الذود في إحالة إلى الطقس الإيكوثقافي، الذي تفتي بتعاليمه روح البداوة، ولقد آثرنا تأويل كل جزء على حدة، إيمانا منا بأن لكل منها عوالمه الموغلة في الوجع الإنساني والخصوصية والفرادة التي تميزه، والوالجة في صلب مكونات هويته.
بيد أن ثمة حقيقة ساطعة سطوع الشمس في وضح النهار كما يقال، بهذا الشأن تتجلى في كون جماهيرية إبداع اللهجات، ليس دائما ما تعود إليها، لذاتها ولطبيعتها، وإنما في معظم الأحيان تعزى إلى قيمة المنتوج الشعري الغنائي، والتي هي من قيمة وخبرة صاحبها، بكل حيادية، ومن دون شك.
يعتبر الحفاظ على نوافذ الأمل مفتوحة ومواربة في شعر وزجليات الرضي، فلسفة وخلفية فارقة، عن وعي واتقاد حسٍّ، بما يغذّي هذا سليم العلاقة بالأنثوي، الذي هو جزء لا يتجزأ، من ثقافة الانتماء، بطبيعة الحال، مثلما تتشرب أبجديات ذلك، سواء ذاته الشاعرة أو أناه الغنائي.
يقول:
{ما دام والشوق له أسباب
والقلب في عشقته ما تاب
لا رد بالنفي والإيجاب
عمل فؤادي بأسبابه
ردي على القلب أنسامه
وحاولي مثلي إفهامه
وراجعي يا شذا أحكامه
فتح لكم قلبي أبوابه
صبا لكم فؤادي أو شاب
يا سيد الحسن يا الجذاب
لو كان من صخر قلبي ذاب
من سحر خلي وإعجابه
أعلى على القلب أعلامه
الخد دفتره والأعيان أقلامه
على صوته وأنغامه
لها قلبي وإطرابه
تملكني حضر أو غاب
وعقلي يتبعه ما ثاب}(1).
إنها صورة الشاعر العاشق الذي يتنفس من العشق، من عنق الزجاجة، وهنا تحضرني قصة مجنون ليلى، حين حج به والده، طالبا له الاستشفاء والمعافاة، من نوبات جنونه، جراء تتيمه بليلى، حين أخذ يطوف بالكعبة وهو ينشد سائلا الله أن يزيده حب ليلاه:
دعـا المحرمــون اللـه يســتغفرونه
بمكـــة شـعثاً كي تمحَّـى ذنوبهــا
وناديــت يا رحمـــن أول ســــؤلتي
لنفســي ليلـى ثـم أنـت حســـيبها
وإن أعـط ليلـى في حياتي لَمْ يَتُبْ
إلــى اللــه عبـــدٌ توبــةً لا أتوبُهــا
يقـــر بعينـــي قربهـــا ويزيدنــــي
بها عجباً مــن كان عندــي يعيبُهــا
فيا نفسُ صبراً لستِ والله فاعلمي
بأول نفـــسٍ غــابَ عنهــا حبيبُهــا
أتراه عاش متلذذا بالذي رحنا نشفق عليه منه، بعدّه جحيما، فيا لمعادلات العشق هذه، ويا لغرائبية صنيعها بالقلوب والعقول!؟
ويقول الرضي، أيضا:
{يا ارع الشرّ لا تسقيه لو اصفر
لا تشغل الناس بأحواله وأحوالك
الشرّ ما اسقيت يتزايد ويتكاثر
وأنت من دهر ما تتغير الحالة
إن زانت الناس تتضايِق وتتكدّر
ولا انت يا صاح واحد باذل أمواله
يا زارع الشر ما بتحصد إلا الشر
سعيت بالشر عندك زانت افعاله
الخير أحيان يتقدّم ويتأخر
ولا ظهر منه إحسانه وافضاله
وكل موقف صفا يشكي يتعذّر
غدرت بالخال والجِيران والخالة
يا زارع الشرّ مهما جرت لا تغترّ
كم غرّ قارون قبلك كُثرة امواله
تريد تظهَر وبِين الناس انت أصغر
يا كِيف يَرضى بتحقِيره وإذلاله
الوعَد كالرعد والأسرَار له تظهر
وانت مشغُول في خالَك وأشغاله
الحرّ يا صاح لا يكذِب ولا يفتر
والحرّ يا صاح ما تتغيِّر أقواله}(2).
يتبين بوضوح أن شاعرنا، ينحاز وبكل خفة ظل وشفافية روح ويقظة عقل، إلى الذود بصوته القوي المعهود عن المنظومة القيمية في أبعاد ما يمكن أن تحدثه من تغييرات إيجابية في حياة الأفراد والمجتمعات.
فقرطاسه من صلصالية الانتماء إلى شجرية الإنسانية، وأحرفه من نور الشاعر الحكيم المتصالح والمسالم في كل شيء.
فإذا به ينأى بذاته وتجربته، عن أي عاجية أو سفسطة وتخاريف مفسدة للذوق والأذهان، على حد سواء، ديدن كثيرين ممن يقحمون أنفسهم في المشهد إقحاما غير ضروري.
نستشف كامل هذا، من كريستالية معجمه، والمرايا التي يتفحص فيها وجهه، إبان الفعل الإبداعي، والتي يأبى إلاّ أن ينعكس على أسطحها الصقيلة، المحمول على روحه النقية والطاهرة والعاشقة والمعتدلة.
يبدع فيبهر، بل ويربك، بما يعرضه من فسيفساء شعرية غنائية تترنّم بعوالم الانتماء والأنوثة، مسقطا من عالم هذا على عوالم ذاك، والعكس بالعكس، تماما.
إنه ارع الخير في المحيط الصغير والوطن والعالم، حسب إملاءات نفسيته الحرة والأبية، التي تعي تمام الوعي، المندورة إليه، من جوانب رسالية، يغدق عليها من أضرب الجمال، الزخم الذي يجعل منه واحدا من أبرز فرسان الحداثة الشعرية، في هذا الباب.
ويقول:
{كل ما في قلبي الموله غرام
في بقايا الروح يا روحي شجن
يا جفاها شبّ في كبدي ضرام
ويا فؤادي اغتم من هجرك وأن
لا تردّي قارب أشواقي حطام
ارزأت بالطرِف من طِرف الوجن
كلما ابعدْت في بحر الخصام
هام في نجواك وجدانِي وجن
أشهِد إن الهجر يا خلي حرام
بعدما أحللْت في الروح الوهن
قلبي المجروح متولّه وهام
نظرتك يا زِين للمُضنى سكن
كُلما اوفدْت مِن لحظك سهام
ما يرِف الجفن مِن عينِي ولن
وكُلما أومضت مِن خلف الغمام
طار قلبِي نحو أنوارَك وحن}(3).
مثلما يقول كذلك:
{يا سيل شلِّي معِك همِّي أحزاني
لا تترُكي شيء مِنه للزَمن يا سيل
يا سيل يجري بها فكري وأعياني
لكنها تنهمِر في صمت جُنح الليل
يا سيل كنِّه نطَق بالحالِ وجداني
يوم السَّمر والمراكِب عابره للنيل
يا سيل والدمع ع الخدينِ هتان
يا بُعدهم كُل غالي بَعدنا وخليل
فارقتهم يوم فارق نومِي اعياني
منِ حين أبعدت عن واد ثماد قليل
يا من لحالِي تغنَّى الطير واشجاني
ومن لحالِي وقلبِي يا دواه عليل}(4).
بنظير مكابدات العشق هذه، يلون الرضي أنساق شعريته الصادقة والمتدفقة على نحو زئبقي، من واقع منفى اختياري، استطاع أن يفجرّ فيه، كامل أوجه النضارة والجمال والهشاشة.
بحكم إقامته في دولة الامارات، بما يفتح تجربته على خبرة حياتية وإبداعية من طراز آخر وأشد اختمارا وجدّة.
لكنها شعرية تظل متزمّلة بروح البداوة، راعية لمعانيها عند المستويات الرمزية المنفلتة، المتقاطعة عند حدودها، أسئلة الأنثوي وقلق الانتماء.
إنه التصوير الفني البديع الذي تبرزه لوحات شعريته، سواء من خلال تجربته الفصيحة والتي أبكر بها ورسم ملامح مشروعه الشعري والأدبي، عموما، أو الكتابة الغنائية التي أسر بها جوارح التلقي، في دورة تواصلية تنهض على معطيات التمكن والسيطرة على ميكانيزمات الاشتعال، كما قواعد ثقافة احترام ذائقة وذهنية القارئ.
نقتبس له أيضا القول التالي:
{كيف أمكَن
أن أُحب وتُنكرين؟
كِيف أهمَلت
الأماني والحنِين
أنتِ من
أغلَق باباً للموِدّة
كان مفتوحاً
لنا منذُ التقينا
كيف أنكرتِ
الذي ما بيننا
لم تسمعي آهات
قلبِي والأنين
مثل قلبي
حين يعشق
مازال ينبضُ
بالحياة
غرّدت فيه
البلابِل واليمام}(5).
إنه نزيف الشعرية الغنائية، المستعر والمستعير من سخط الطبيعة ولعنتها إسقاطاته، حتى في أهدأ ثورات الذات العاشقة المنشطرة.
ختما، يمكن القول إن شاعرنا، نجح في إرباك وعي قارئه، واستفز ذائقته، بما يجعله مأخوذا، ومشدودا إلى الفنية البالغة في استنطاق الموروث والذاكرة العربية، ضمن أنساق تعبيرية تغرق في خطاب النيوكلاسيكية، كما تمتح من عبق جملة من التصالحات مع الطبيعة والآخر.
هامش:
(1) مقتطف من قصيدة “ما دام3″، صفحة2، ديوان “راعي الذود”، الجزء الأول.
(2) مقتطف من قصيدة” الصلح خير4″، صفحة9، ديوان “راعي الذود”، الجزء الأول.
(3) مقتطف من قصيدة” ألفي عام”، الصفحة152، ديوان” راعي الذود”، الجزء الأول.
(4) مقتطف من قصيد” يا سيل”، الصفحة214، ديوان” راعي الذود”، الجزء الأول.
(5) مقتطف من قصيدة” أعذرينِي”، الصفحة261، ديوان” راعي الذود”، الجزء الأول.