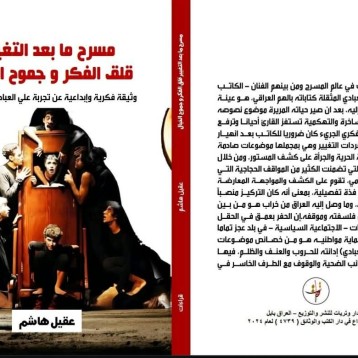تعترف باسكال صوما في تصدير روايتها “مورينيا”، الصادرة مؤخرًا عن دار سما للنشر والتوزيع في القاهرة، أنها تصرفت مع شخوص روايتها كـ”إله يتحكم في الكون”، فالكاتب إله برأيها، وهو مع ذلك يرفض الاعتذار لشخوص روايته الذين وضع لهم مصائر قاسية، والرواية هي الكون الصغير الذي يمكن أن يتحكّم فيه الكاتب بلاعبيه وقد لا يرأف بهم، وعلى هذه الطريقة في المحاكاة تغامر صوما في كتابة رواية ذات بُعد سوريالي تجريبي تتخطى فيها الأشكال الروائية التقليدية لنجد أنفسنا أمام رواية ما بعد حداثية من مجموعة سرديات، نظن للوهلة الأولى أن كل قصة لها مكانها وزمانها لنقع في النهاية على تقاطع السرديات كلها في حبكة روائية حرّة ومفتوحة على الغرائبية والمحاكاة الساخرة للواقع. على أن اعتراف صوما الآخر أنها أتمّت مهماتها مع شخوص رواياتها وبإمكانها مغادرتهم بعد أن حاولت إنصافهم والرأفة بهم لكنهم عاندوها، هو انعكاس لاقتراب الكاتبة من “الميتاقص” من خلال محاولة أنسنة الشخصيات التي هي كائنات من ورق وتحويلها إلى كائنات إنسانية.
“تغامر صوما في كتابة رواية ذات بُعد سوريالي تجريبي تتخطى فيها الأشكال الروائية التقليدية لنجد أنفسنا أمام رواية ما بعد حداثية من مجموعة سرديات، نظن للوهلة الأولى أن كل قصة لها مكانها وزمانها لنقع في النهاية على تقاطع السرديات كلها في حبكة روائية حرّة ومفتوحة على الغرائبية والمحاكاة الساخرة للواقع”
“لا تنسوا مظلّاتكم أنتم في مورينيا”، و”مورينيا” هي المدينة المتخيلة التي تدور معظم الأحداث فيها، لا يدخلها إلا من معه مظلة ومن اختار غيمة، ومن الفصل الأول تتبدّى لنا قدرة صوما على اجتراح تمظهرات عبثية وساخرة من الوجود كأنها تمارس اللعب بالكلمات في عملية تفكيك وتركيب تعكس نضج الكاتبة الفكري واتساعه في عالم يصعب تفسيره، عن التفاهة ككنز لا يفنى، والحق غير المنصوص لكل إنسان في القتل على الأقل مرة في الشهر، ويوم القصاص الذي تعلّق النساء فيه على حبال الغسيل مشانق للأزواج الذين أغضبوا حبيباتهم في الصيف، “ولها حرية الاختيار من أي عضو من جسده تريد أن تعلّقه”، وإلفيرا التي تريد فقط قطع أصابع زوجها “لا شيء يؤلم النساء كالأصابع. لا أحد يملك سطوة الأصابع على الأكتاف الصغيرة، وهذه الندوب فعلة هذه الأصابع”، والقطة (إحدى شخوص الرواية أيضًا) التي تحتاج إلى الافتراس وواضحة في الدفاع عن حقها بالأكل والمعاشرة، وبثينة التي فتحت بيتها لطالبي النصح، للرجال مقابل إهدائها فساتين قصيرة، وللنساء اللاتي تخلّصن من شعر رؤوسهن كنوع من الحرية واللامبالاة، “لم تكن الشعور القصيرة موضة بل مصيرًا. تختاره النساء ما بعد الخمسين، إمّا بداعي النسيان أو التمرّد أو حتى انتقامًا من رجال العالم. كان لكلّ شعرٍ قصير قصة طويلة وغالبًا مؤلمة”، وألبرتو الطبيب الذي اعترف بالخسارة فتحوّل إلى مهرّج وتمكّن من علاج سكان المدينة بالضحك بدل علاجهم في العيادة. ومع كل فصل تتكشّف الرواية عن قصة جديدة وشخصية جديدة لنُصدم في نهاية كل سردية بموقف يضع الشخصية الجديدة والهامشية في الوسط والحدث الهامشي كحدث أساسي يعيدنا في كل مرة إلى البداية من جديد، في تمرّد متواصل على النسق النمطي في الكتابة واتكاء على بنية الاسترجاع مع خلوّ التسلسل الزمني المعتاد، ومن دون استطراد، فكان الاختزال والتكثيف من أهم أعمدة عمارة باسكال صوما الروائية، والذي يجيء حتمًا من الإيجاز في أسلوبها الشعري.
إلا أن أهم ما يميّز كتابة باسكال صوما هو ذلك التداعي العفوي في الكتابة وكأن خيالها يعمل بسلاسة ومن دون تخطيط مسبق، لنجد أنفسنا أمام نوع من الواقعية السحرية التي يتدخل الخيال فيها بتلقائية وبغرائبية تشدّنا إلى التأويل المتواصل للأحداث، فموسم العسل بات يترافق دومًا مع أخبار عاجلة: “بائع عسل وُجد جثة هامدة أمام متجره أو في غرفته أو تحت شجرة”، بتهمة قتل النحل من أجل شهده، ولا أحد صدّق بائع العسل “غابي” أن استخراج العسل لا يعني موت النحل، إلى أن وُجد مقتولًا أيضًا، وحانة سان سيمون التي ارتبطت بكل مشاعر الألم والحب والقلق والأرق والنعاس والغربة والوحدة لا يدخلها إلا من معه بطاقة بلاهة، ونورا بدأت العمل فيها لإعالة إخوتها بعد أن هجر والدها أمها، وغيّرت اسمها إلى “بو علي”، حيث استدرجت “أشرف” (وهو نفسه “غابي” في حكاية بائع العسل) ذات ليلة ولما انفردا لوحدهما في الحانة وحاول اغتصابها قتلته بسكين في بطنه. لكن نورا التي اغتصبها والدها وهي صغيرة كانت ترغب بالانتقام من الرجال كلهم “لم تكن تشعر بأنها قتلته فعلًا. كان سكينها ينتظر منذ سنوات رجلًا ليقتله. في مرات كثيرة كانت تفكّر بقتل والدها، لكنها قتلت أشرف بدلًا منه. في قرارتها لم تكن تشعر بذنب كبير، كان قلبها مطمئنًّا شاعرًا بأن من قُتل هو والدها”، وحين عادت نورا في ذاك المساء وقد قتلت أشرف، وسمعت همسات والدها وأمها أفرغت غضبها فيهما ثم شكّت نفسها بسكين وماتت و”أشيع في المكان أن شبحًا مرّ في المدينة، أخذ أشرف ونورا، أما بو علي، فكان فكرة اختفت تمامًا”. وروّج رفاق غابي (أشرف) أنه قد قُتل بسبب بيعه العسل. أما نينا فتحتفظ في دُرج خزانتها بجثة زوجها وبقميص عشيقها غابي. وعلى هذه الطريقة من السرد المتشابك والقص داخل القص تكتب صوما سردياتها السوريالية المكثّفة بالإحالات الدلالية والمشهديات البصرية في حبكة واحدة خفية تثير فينا الدهشة في كل فصل وتتكشّف حكاية تلو أخرى.
“أهم ما يميّز كتابة صوما هو ذلك التداعي العفوي في الكتابة وكأن خيالها يعمل بسلاسة ومن دون تخطيط مسبق، لنجد أنفسنا أمام نوع من الواقعية السحرية التي يتدخل الخيال فيها بتلقائية وبغرائبية تشدّنا إلى التأويل المتواصل للأحداث”
تتبع باسكال صوما حركة الواقع بقصّ خيالي وتراجيدي في آن واحد، فلا يخلو فصل من فصول روايتها من التقاط أحزان عميقة من مجتمعنا، في توثيق للوجع والعتمة والوحدة بنسخ متعدّدة، “هناك نساء يولدن مقتولات، فيما تُقتل أخريات على مرأى من الجميع، وأكثر من مرة. يحدث ذلك كله ولا تنزل دمعة واحدة أحيانًا. التأنيث كان دومًا تصنيفًا للنقص. حتى ’الجريمة’ جعلوها تتأنّث حتى يبرأ الجميع، وتدان وحدها”، و”السجن هو الجسد. أجساد النساء سجونهنّ”. وفي السجن الذي هو نسخة طبق الأصل عن سجون بيروت “ليس مقرّرًا أن يخرج الناس من المكان أحياءً أو موتى، ليس مقررًا إن كانوا سيخرجون أو لا. لكنّ كثيرين كانوا يموتون من شدّة الصمت، أو يصابون بالجنون، أو الأمراض العقلية. حتى وسائل الانتحار لم تكن متوفّرة بالضرورة”، و”في ليلة المطر فرغ الشارع تمامًا، وبات غوستافو وحيدًا. شعر بألم في القلب، انتبه إلى كم هو وحيد، والأمر لا يقتصر على ليلة واحدة، إنها حياة كاملة بصباحاتها ومساءاتها. شعر بأنه منعزل وقد تُرك في العالم. كان راغبًا بأي شيء حتى إنه كان مستعدًا ليجري مع أي شخص حوارًا عن غلاء أسعار الجبن والطحين وكان جاهزًا ليبدي تعاطفًا وتفهمًا لأي قصة حزينة قد يرويها له أحد”.
وفي سردية مؤثرة جدًا لبحث “سام” عن أمه التي ابتعدت عنه حين قررت هجر زوجها، سيطلب “سام” أن تكون مهمته جمع الجثث في رغبة منه لمصادقة الموت بطريقة ما، “كان يفكّر في أنّ الجثث التي يلمّها قد تشفع له معها. وإن كانت ميتة حقًا، ربما يخبرها أصدقاؤها الضحايا إذا التقوها، عن صبيّ أخرق حزين لا مهنة له سوى جمع الجثث بعد المعارك. ربما يخبرونها أنه أسمر ونحيلٌ جدًا وأنّ له شامتين بارزتين في خدّه الأيسر”. سيدخل سام السجن محتفظًا برسالة مؤثرة من أمه تنهيها بجملة “كنت أود كثيرًا أن أحبك كما ينبغي”. والسجن يلجأ إليه من يطلبون العزلة، فالزنازين تحوي أبطالًا من الحرب، قرروا تمضية حياتهم في غرفة وعدم رؤية أحد. تحوي أيضًا نساءً هاربات من الجحيم وأطفالًا غير راغبين في الحياة، فيرسمونها على شكل موت. هناك أيضًا مسنّون وغريبو أطوار وراقصات باليه ومغنّو “راب”. كثيرون كانوا يعانون من ذنوبٍ لا تعدّ جرائم، لكنّهم كانوا محتاجين إلى قصاص، إلى نهاية ما. وعند الخروج إلى الحرية سيلتقي سام بأمه خارجة مثله من العالم الذي اختاراه للعزلة، السجن.
“تستولي الفانتازيا على جانب كبير من سرد صوما وترتبط بالبُعد الفكري للكاتبة، فكانت لها وظيفتها الواقعية والسيكولوجية بحيث سخّرتها الكاتبة لأغراض فنية تتضمن النقد والمحاكاة والسخرية المفعمة بالألم في إخراج مشهديات بصرية ملتصقة بالوجود تعكس روح المدينة ومعاناتها”
سنعثر أيضًا على أجزاء حوارية بلغة شفافة في معظم فصول الرواية تشكّل ركيزة للنفاذ إلى العوالم الداخلية للإنسان في تكريس للواقعية من مكان آخر، نقرأ في إحدى الحواريات: “- لقد خسرتِ امرأة وطفلًا/ – لقد خسرتُ الرغبة. الرغبة أهم من الأطفال/ – هل جئتِ لتجدي الرغبة هنا؟”. وفي تمثيل عميق للآلام التي يُحدثها الآخرون فينا وكأنها فعل القتل، فيما نبقى على قيد الحياة نقرأ في حوارية أخرى: “- هناك دومًا قاتل أو قاتلة في الباحة الخارجية للجريمة، قاتل لا يحمل سكينًا ولا مقصلة. يحمل فقط قلبًا باردًا وعلبة سجائر/ – القتل يأتي غالبًا قبل الموت بساعات أو أشهر أو حتى سنوات”.
في رواية باسكال صوما الأولى “أسبوع في أمعاء المدينة”، التي حازت جائزة وزارة الثقافة اللبنانية للرواية الناشئة، الكثير من الفانتازيا؛ هنا أيضًا تستولي الفانتازيا على جانب كبير من سرد صوما وترتبط بالبُعد الفكري للكاتبة، فكانت لها وظيفتها الواقعية والسيكولوجية بحيث سخّرتها الكاتبة لأغراض فنية تتضمن النقد والمحاكاة والسخرية المفعمة بالألم في إخراج مشهديات بصرية ملتصقة بالوجود تعكس روح المدينة ومعاناتها، ما يذّكرنا بـ”أشباح” أندريه بلاتونوف في إخراج صور للمجتمع الروسي آنذاك، وهو ما تمكنت صوما من النفاذ إليه في تصوير مجتمعاتنا الهشّة متكئة على خلفيتها الشعرية بكتابين سابقين لها “تفاصيل” و”فاصلة” وفي ذلك تقول في روايتها الحالية: “ضعي فاصلة. النقطة علامة للموت والنهاية. فلنجعلها فاصلة. فاصلة صغيرة في عالم مملوء بالنقاط النهائية”!
عن الضفة الثالثة