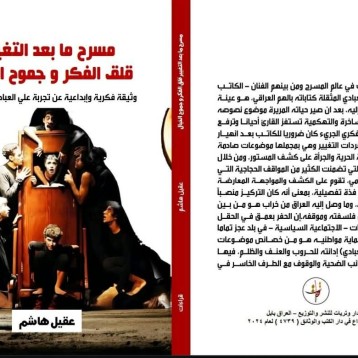د. سمير الخليل
يتشكّل الخطاب الشعري في مجموعة (المزامير) للشاعر علاء المسعودي بالإرتكاز على تنويعات تعبيريّة في الوجود وأسئلة الوجود والبحث عن الجمال المطلق الذي يصل إلى لغة وإشارات التصوّف والعرفان الذاتي، لكنّها ليست صوفية مغلقة وغنوصية غامضة بقدر ما يعبّر عن تأملات وانتباهات في الإنسان والحب والتعبّد و(الآخر) ودوره، والأمكنة، والتناص مع مثابات السّور والأساطير والتفكر العميق.
يقدّم المسعودي نصوصه الشعرية وتنويعاته على مستوى الثيمات والرؤى من خلال لغة شفيفة محلّقة، ولم يلجأ إلى اللغة الشعرية المتداولة والمستهلكة فالأداء اللغوي على مستوى الفيض قد أخذ بعداً تعبيرياً مهيمناً على معظم نصوص المجموعة، ولعلّ موضوعة الجمال بمعناها الكوني المطلق هي المهيمنة وهي العنوان، فضلاً عن جمال التصريح والتأمّل وجمال العشق الروحي وجمال العَود بعد الزلل، وجمال الأمكنة، وجمال الأسئلة، ولعلّ كل هذه المعطيات التعبيريّة على مستوى الاشتباك مع المضامين هي التي اقترحت تسمية العنوان الكلّي للمجموعة (المزامير) وهي كناية عن طبيعة (المزمور) ودلالته الدينية والوجودية والإنسانية، بوصفه المدوّن الذي يقدّم مساحة مشعّة من التراتيل والتوصيفات ورحلة الذات من المجهول إلى المعلوم أو رحلة البحث عن الجمال والسبيل والمقاصد الرصينة.
يمزج الشاعر علاء المسعودي في معظم نصوص المجموعة بين اللّغة والصور والثيمات الشعرية مؤطرّة بانتباهات وتجلّيات تقترب كثيراً من النسق الإنساني والعرفاني الغرض منه البحث عن الجمال من خلال هذه التجلّيات، وصولاً إلى نوع من الإدراك والتيقّن عبر مجاهدة النفس ومجاهدة هذه الرحلة والتوّقف عند لحظات التوق والضعف، ومن ثمّ خلق قوّة يقينية لعبور مسافة القلق، ونجد في النصوص لاسيما في نهايتها ما يشبه الرسالة الضمنية التي تنتهي بانتصار الانتباهات، وقوّة وعي الذات وتوظيف الشعري في التهجدّات، مهمّة لا تبدو يسيرة للوهلة الأولى لكن حضور التوق الجمالي لدى الشاعر ألغى تلك المسافة وأصبحت النصوص متصالحة مع بوحها وانبثاقاتها، وتأسيساتها، وفيوضات الإحساس التي شكّلت منظومة شفيفة من الصور والإحالات، والإيحاءات العميقة والرؤى المنتجة للفكرة المحلّقة، والقصديات المضمرة، والتوق إلى رسم ملامح الرؤية التي ترتكز على تطويع الشعر باتجاه قصديات اليقين والتأمّل بكل أبعاده السايكولوجية والوجودية واليقينيّة، ويوظف الشاعر تناصّاته الدالة مع إشارات دينيّة وسور منتقاة، وتعالق مع تناصّات أخرى في التاريخ والميثولوجيا والبحث بنسقه الذي تنطوي عليه رحلة كلكامش في البحث عن الخلود، ومأثرة هذه النصوص أنها وازنت بين الشعري والمعرفي وأوجدت صلة بين الجمالي واليقيني من دون إسراف أو ميل أحادي وهذه الخاصيّة تتطلب وعياً في التوظيف وتعبّر عن موقف ومرونة تعاطيه مع الحقيقة والفكر والجمال، وإنّ التجليات العرفانية لا يمكنها أن تكون في عزلة عن حركة الحياة والواقع وحقائق الوجود وتوق الإنسان إلى الجمال بكلّ معانيه وأشكاله ومثاباته، فلجأ الشاعر إلى لغة تجمع بين المقاصد والعذوبة وتدعو إلى التأمّل والاستبصار الدال.
ويسعى الشاعر إلى تحويل مزاميره وكأنها أناشيد تعبيرية كما ألمح في عتبة الاهداء: “إلى مَنْ بين مهدي ولحدي لهم أزمِّر”. (المجموعة: 5)، ويتحوّل الترميز إلى نوع من التوق ولذا نجد الآخر مخاطباً دوماً من لدن ذات النص إذ يمكن تأمّل هذه التجلّيات في التوق والبحث والجمال في نص يحمل عنوان (لسمائي الخفاش وللناي الحَجَل):
بمتاهات ودهاليز / لا أوّل فيها.. ولا آخر.
قذفني من رحم التيه / ولآخر سرٍّ فيه.
بل من عدم لسواه / كي أبحث عن ترميز ملكي
أفتح منه ملاذاً / ليس فيه أرتاج أو قيد.
طال النظر لسفوحٍ خاويةٍ / واهتزّ بي الجبل
ليدكَّ عروقي دكّاً / وخبا في احشائي قزم
رعديد أوّاه / وتحفّت روحي / توقاً للغائب عنها… (المجموعة: 7- 8).
نلمح في النص لغة تقترب من الإشارات الصوفيّة ونلمح توقاً دائماً لإثارة السؤال، والبحث عن اليقين على وفق متواليات من الصور والإحالات من دون الوقوع في لغة مباشرة بل إنَّ الشاعر يحيل إلى معانٍ ودلالات من خلال توظيف هذا النوع من النسق اللّغوي لكي يصل إلى ذرى التأمّل الوجداني، وتقديم صورة الوصول إلى اليقين بعد هذا البحث عن الذات والآخر والبحث عن المكوث من خلال الرحلة حيث تبدأ القصيدة بالمتاهات والدهاليز لا أول لها ولا آخر، ويدبّ الوجد في البحث عن السبيل وسط متاهة الأسئلة، وهناك اشارات إلى هذه المكابدة الدالّة: “طال النظر لسفوح خاوية / واهتزّ بي الجبل
ليدكّ عروقي دكا / وخبا في احشائي قزم”.
أي أن الوصول إلى ذروة التيقن يمرّ من خلال هذه المكابدة، والنظر والتأمّل، لكي يتسم هذا التيّقن بعبرة البحث والسؤال، ويصبح المعنى أكثر انفتاحاً على تحصيل الشيء بالشيء ولا شيء، يأتي من فراغ خاوٍ.
وحين يتناول قلق الشاعر ومكابداته يضع عنواناً يتضمّن مفردة العروج وما تحيل إليه من مضمر صوفي في نص (عروج الشاعر):
قد اشتهي عنباً / وقد…. / ألقي كرومي خارج العتبة
وأجول في بستان ذاكرتي / أفتّش عن دنان الشعر
عن بعض من الأزهار / عن سحرٍ / وعن هضبة..
من فوقها ألقي مزاميري / وألواحي / كي يتفجّر الينبوع / أو…
كي ترقص الأفعى / فتمطر غيمة سوداء / فوق بحيرة بلهاء
ساحلها يموج / بدوحة السّغبة”. (المجموعة: 16- 17).
ويصوغ الشاعر هذا النص المعبّر باستخدام أسلوب أو تقنيّة قصيدة القناع ويتحوّل إلى بوح على لسان الشاعر، وعلاقة الشعر بالتجربة الحسيّة والبحث عن اللّذة، وصولاً إلى (النيرفانا) الشعرية، وعلامة على الرؤى والتأمل بمظاهر وبواعث هذا التوق ويحيل الشاعر إلى مفردات إشارية وإحاليّة واضحة الدلالة، مثل العنب والكروم ودنان الشعر، والأزهار، والهضبة والمزامير، ورقص الأفعى، والغيمة، والبحيرة البلهاء، ودوحة السّغبة، وفي خضم هذه الإحالات والشعر يختزل الشاعر تجربة البحث عن الرؤى من خلال هذا التقمّص وطقوس البحث عن لذّة الوهم، ولعلّ جمالية هذا لم يسقط في المباشرة والتقريرية في تقديم غواية الشاعر وطقوسه وغرقه المجازي في البحيرة البلهاء، فكان الشاعر إحالياً ورمزيّاً في تصوير وتجسيد هذا الإغواء المقترن بإبداع الشاعر الذي وجد وهمه الذاتي المرتبط بكتابة الشعر، وكأنّ الشعر لا يؤخذ إلاّ وسط هذه المتاهة، ويصف الشاعر نهاية هذه المكابدة بأن النفس لابُدَّ أن تعود لترفض هذا الجنون:
“لكني أصبو إلى النفس / التي تأبى مطاريح الجنون
ودوحة السغبة….”. (المجموعة: 22).
ويجلّى النسق الصوفي في نص (من وهجي) وهو أقرب إلى المناجاة، أعني مناجاة الذات والتطلّع إلى التوق العرفاني ومخاطبة المخلوق:
أيها المخلوق / هل من طينة صاغك الله الهوينا!!
أم ترى من عسلٍ صبّك؟! / في قارورة حمراء
فاستكملت في وهج سطوع / فانزوينا / وتعاليت علينا!!
أيها المخلوق / من نرجسٍ بالدرّ وبالفيروز معجونا
ومن تبر سناك !! / فأنا الحالم / في اليقظة أنّي قد أراك
وأنا الناظر تطويني الشراك”. (المجموعة: 86- 87).
ويمكن الاستدلال على أنّ هذا النص يتضمّن أسئلة للمخلوق وضعفه وغروره إزاء الملكوت الأعلى، فقد اعطاك الله كلّ الملكات التي اصابتك بالغواية ولم تدرك جوهر العطاء!! فلماذا الوقوع في الشراك؟ وبقيّة القصيدة تسير على وفق هذه القصديّة التي تحمل خطاباً في التأمّل وإدراك الموقف والعودة إلى اليقين.
ويقدّم الشاعر مجموعة من المقطوعات تحمل عنواناً مركزياً مشتركاً هو (مزمور) ويضع لها ارقاماً وعددها (12) مزموراً وقد يكون لهذا الرقم دلالة مرجعيّة، وانطوت هذه المزامير أو المقطوعات على نسق من التوق والسؤال العرفاني، ففي المزمور نقرأ:
كم في جنونك من جنون / أنا حاضر في قمّة الوجع المخضّب بالشجون
أنا خارج من أفق هذا الكون / تحملني مرايا روحي الثكلى
وتخذلني العيون…” (المجموعة: 97).
ونجد براعة الاستهلال الذي يقرن الجنون بالشجون، ويقدّم صورة للقلق الذي تكابده الروح الباحثة عن اليقين، واستشراف الوجود، والإشارة إلى التكوين الكوني والروح الثكلى تنوء، ولكنّ الخذلان مصير من يمسك خيط وجوده ويغادر الجنون باتّجاه البصيرة، وعلى الرغم من المحمول الصوفي والعرفاني نجد الشاعر يبدي حرصاً وقصديّة في انتقاء عذوبة اللّغة، وتشكيل الصور الشعريّة المتواترة، والابتعاد عن الصيغ المباشرة التي تميل إلى البعد الأحادي في التعبير.
ويظلّ الشاعر مشدوداً إلى أنماط وفضاءات الجمال ويصوغ بعض النصوص والمقطوعات وهو يتغزل بالمرأة بوصفها جزءاً من هذا الجمال الذي يغلّف الكون، ويثير متعة التوق، ويخلق انزياحاً في دلالات الحب ومعانيه وتجلّياته المختلفة التي تدلّ كلّها على هذا التوّهج، وقد اتّخذ من مفردة الوجد مفتاحاً للكشف عن هذا الجمال ومراتبه، واتسّاق اجزائه للتعبير عن الجمال الكلّي والتوّهج المطلق في مقطع تضمنه الجزء الذي سمّاه (آيات من النثر الحكيم):
“الوجد: حضرة مقدّسة يطؤها الرهبان…
الوجد: باحة لقيس وليلى..
الوجد: مخاض ساخن .. تطفئه الدموع…
الوجد: نار بردها وسلامها على العاشقين
الوجد: باحة الملائكة…”. (المجموعة: 114).
ونلحظ تحولات هذا النص تتمركز حول التوق المتجسّد والمرتكز على (الوجد) بوصفه حركة الروح الباحثة ويتساوى فيها الرهبان والعشاق و(قيس وليلى) والحزن الذي يتحوّل إلى طاقة من التطهير، ويختم بدلالة علويّة حين يصف الوجد بأنه باحة الملائكة في اشارة إلى المعنى العلوي ليقين التوق الحقيقي إلى كلّ اشكال الجمال ورسوخ كينونة الوجود المتعالي.