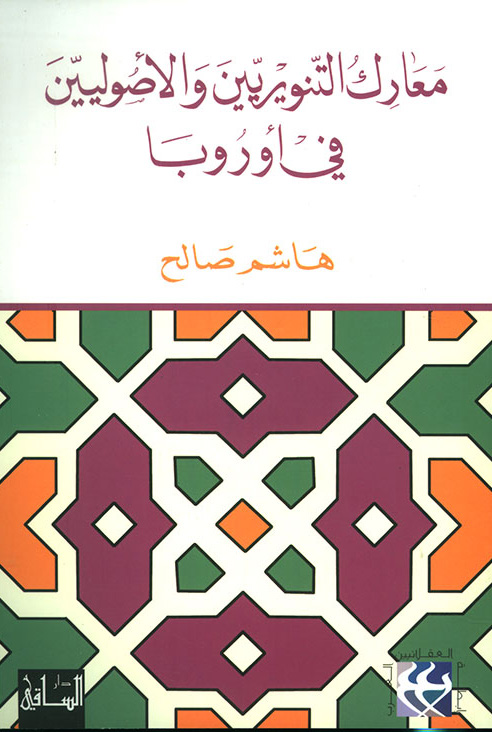د. وسام حسين العبيدي
حين أجاب “إيمانويل كانت” -الفيلسوف الألماني (ت: 1804م) – عن سؤال ما هو التنوير؟
بقوله: (إنه خروج الإنسان عن مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد) لم يترك الجواب مُرسلاً بلا تحديد لهويّة ما سمّاه بالقصور العقلي، بل أردف ذلك ببيانِ أبرز سمةٍ لذلك القصور، وهو قوله بأنه (التبعية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوك في الحياة أو اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص الوصيِّ علينا) وهذه التبعية/ الوصاية، كانت الآفة الفكرية الطاغية على ما قبل عصر التنوير، أعني به عصر النهضة الذي تأسّس على مفاهيم مثل “المحاكاة” و”الإحياء” لآداب وعلوم الحضارتين اليونانية والرومانية، وجعل كل ما صدر عن تلك الحضارتين معيارًا ومثالاً يُحتذى من أدباء ومفكري عصر النهضة، وبموجب ذلك كان للتنوير أنْ يُعمل إزميله في هدم تلك المفاهيم، ويرفض البالي منها، ويُعيد النظر في الموروث بوصفه جزءًا من ثقافة أمةٍ عاشت في زمنٍ غابر له ظروفُهُ الفكريةُ والاجتماعيةُ والسياسيةُ التي أسهمت في تكوينه بهذه الصورة، فهو إذن ليس نتاجًا كاملاً يصحُّ أنْ يكون معيارًا لكل زمان ومكان، وبالنتيجة لا يصحُّ إلا النقد لذلك الموروث، فهو السبيل الوحيد للإفادة من ذلك التراث، وجعله مادةً قابلةً للأخذ والردّ بحسب ما تتطلبه مستجدّات البحث العلمي والتفكير المنطقي الذي ينمو هو الآخر ويزداد عمقًا وثراءً في معطياته، أما نظرة التقديس للماضي، فهي لا تقدِّم شيئًا سوى الجمود والتقليد هروبًا من مواجهة الحاضر، وسريعًا ما تؤول على أصحابها والأمة التي تترعرع فيها، بالضياع في وهاد التخلّف في مختلف نواحيه.
وحين نقرأ الواقع الفكري العربيَّ، نجده ما زال إلى الآن، لم يتطلّع بحزم وثقةٍ إلى تنويرٍ في مختلف مناحي الحياة والمعارف التي يخوض فيها، فمبدأ “التقليد” أو “المحاكاة” واقتفاء النماذج السالفة على نحو المقاربات التي تمس الشكل أو المضمون، والانكباب على التراث بقضِّه وقضيضه، هي السمة الأبرز والأكثر تمظهرًا من غيرها، على الرغم من محاولات النقد لذلك التراث، التي افتقرَ بعضُها إلى آليات دقيقة تتجنّب الوقوع في فخِّ الانبهار بالمنجز الغربي – على عِلّاته- فتعرفُ ما الذي تلتقطه منه، وما الذي تدعه للزمن، إلا أنّها على الرغم من ذلك، فهي أفضل حالاً من الطمأنينة الكسولة التي أشاعها المحافظون على التراث وهيبته من أنْ يمسها أحد، بل أكثر من ذلك، أنّها – أي تلك المحاولات النقدية للتراث- كانت سببًا لردِّ الفعل في إنعام النظر ومزاولة التحقيق فيما أثير من إشكالات على ذلك التراث، الذي يعبّر هو الآخر -بوصفه خليطًا متجانسًا في بعض نواحيه وغير متجانس في بعضه الآخر- عن مستوى ثقافة الأمة وتحصيلها الفكري في حقبةٍ زمنيةٍ سابقة، فهو – التراث- ليس معصومًا من الخطأ، وممارسة نقده – بحسب المفكر محمد عابد الجابري- ليس من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو ميت ومتخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقافي. ومثال ذلك ما أثاره طه حسين من إشكاليات حول صحة الشعر الجاهلي، وما استتبعَ ذلك من ردود – على الرغم من سلفيّة بعض الردود وافتقارها البُعد الموضوعي- أعادت النظر في تلك المنطقة الرخوة من التراث ورصّنتها عبر التحقيق والبحث الذي كان بفضل تلك الإشكاليات المثارة من طه حسين وقبله من مستشرقين؛ وبهذا يستحق لمن يضعضع ثقتنا بذلك التراث أنْ نرفع له القبّعة؛ لما سيدفعنا إليه من بحثٍ واستقصاء وإعمال فكرٍ فيما أثاره من إشكالات – بغضِّ النظر عن الدوافع والغايات التي دومًا ما نتشبّثُ بها ونترك أصل القضية من دون معاينة لها- وإذا كان ردُّ المحافظين على أولئك المُجدِّدين أو الساعين لإشاعة التنوير في الفكر العربي، بكونهم أيضًا لم يسلموا ممّا شخّصوه من عيوب تراجع بموجبها منسوب الفكر وارتدَّ إلى التراث يعبُّ منه وينهل، إذ انساقوا يقلِّدون الغرب فيما ثار عليه وتحرّر من إساره، فهو ردٌّ ينطوي هو الآخر على نفسه، ولا ينطلي إلا على السُذَّج فكريًّا، فالتقليد بصفةٍ عامة، ليس مبدأً سيئًا في كلِّ تمثيلاته، إذ تقليد الآخر – أيًّا كان الآخر- في الجيِّد من أفكاره وسلوكيّاته، وتقليد الغرب فيما تحرّروا منه من سلطة الكنيسة “الإكليروس” الخانقة لأفكارهم فيما يخص العلوم النظرية والتطبيقية، يُعدُّ تقليدًا للمحتوى الجيد والمضمون الذي ينسجم ورُقِيَّ النزعة الإنسانية لدى الإنسان، وهذا الأمر لا يتضادُّ وجوهر الأديان السماوية التي دعت الإنسان أنْ يتحرّر من أوهامه، ويحتكم إلى عقله في كل ما ينبغي الاحتكام إليه، لاسيّما ما يتعلّق بقضايا البحث العلمي في مختلف مساربه المعرفية، ومن النافع جدًّا حينها أنْ نُعيد النظر في تلك النقطة المفصلّية من التاريخ الأوربي الذي اندلعت فيه المعارك الفكرية الكبرى لروّاد التنوير مع الأصوليين، بوصفها خطوة عقلانية لفهم التاريخ البشري، ومن دون ذلك الأمر، سنقع أيضًا في فخ اللاعقلانية من جديد، حين نعتقد بحسب قول هاشم صالح في كتابه (معارك التنويريين والأصوليين في أوربا) المهم في هذا السياق: “أن الحضارة نزلت عليها كهدية من السماء، أو أنَّ العنصر المسيحيَّ الأشقر هو وحده القادر على إنتاج الحضارات لأنَّ هذه الحضارة وُلِدَتْ لديه لا لدى شعبٍ آخر”؛ ولهذا أرى من المفيد جدًّا في سياق السعي لإشاعة تنوير في الفضاء العمومي العربي، أنْ نستلهم من تجارب كلِّ من حاول تنقية التراث وجعله سببًا للرقيِّ عبر تلك المراجعات النقدية لمحمولاته الفكرية، وأنْ نقف عبر ما أثير على أولئك المُجدِّدين في أزمانهم، من إشكالات، والتقاط الخيوط الرفيعة التي تجمعها في بودقةٍ واحدة، لا تخرج عن إطار الإجماع أو القداسة أو غيرها من المضامين المعبّأة بدلالات الهيمنة والمُطلقيّة في صفاتها. ولعل واحدًا من تلك الشواهد التي يُمكن لنا استحضارها في هذا السياق، ما ذكره السيد محمد باقر الصدر في كتابه (المعالم الجديدة للأصول) من حالة ركودٍ فقهي ساد بعد وفاة الشيخ الطوسي (ت: 460 هـ)، سببُه ما كان عليه الأخير “من تقدير عظيمٍ في نفوس تلامذته رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد، وجعل من آرائه ونظرياته شيئًا مقدّسًا لا يُمكن أنْ يُنالَ باعتراضٍ أو يخضعَ لتمحيص […] وهذا يعني أنَّ ردَّ الفعل العاطفي لتجديدات الشيخ قد طغى متمثِّلاً في تلك النزعة التقديسية على ردِّ الفعل الفكري الذي كان ينبغي أنْ يتمثَّل في درس القضايا والمشاكل التي طرحها الشيخ والاستمرار في تنمية الفكر الفقهي”، ونجد صدى ذلك التقديس في كثير من العلوم التأسيسية عند العرب، مثل علم النحو الذي برع فيه سيبويه (ت: 180 هـ)، فكان لمن اشتغل بعده أنْ يعكف على هذا الكتاب ولا يرى ثمة أي موجبٍ للتأليف بعده، وحسبنا قول المازني (ت: 247 هـ): ((من أَرَادَ أَن يعْمل كتابا كَبِيرا فِي النَّحْو بعد سِيبَوَيْهٍ فليستحي))..!
وإذا كانت هذه النزعة – التقديس- تصلُ إلى حدِّ أنْ يمتنع الآخرون هيبةً من مناقشة الآراء والنظريات لعلماء وصلوا باجتهادهم وكسبهم، فمن الطبيعي أنْ يتركّزَ مفعول هذه النزعة ويشتدُّ حماسُ أصحابها حين ينبري بعض العلماء – من أي مذهبٍ كان- لمناقشة ما يتّصل بالمصادر الممثِّلة للشريعة بالدرجة الأساس، وتكون عاقبة أولئك أنْ يطالهم من الخاصة المندرجين في إهاب القداسة، فضلاً عن العامة من الأتباع لأسيادهم فيما يصدرون عنه من أقوال وأفعال، كلُّ ضروب التنكيل المعنويّة والمادّية، ولعل محنة الكبار من ممثِّلي الثقافة العربية التي شهد القرن العشرون فصولها الدراماتيكية، بدءًا من طه حسين وما تعرّض له من حملة ليس آخرها ما كان مع نصر حامد أبو زيد في السياق الثقافي العربي، أو ما حدثَ مع الشيخ محمود أبو رية، والسيد فضل الله في أواخر القرن العشرين وأخيرًا مع السيد كمال الحيدري – في القرن الواحد والعشرين- في السياق الديني، توفِّرُ لنا الأدلّة على طغيان تلك النزعة في صميم الثقافة العربية، وفي الوقت نفسه، تُعطي الحافز لمواصلة السعي لتمهيد أرضية صلبة لاستنبات تنوير عربي يُحاول فضّ شرنقة الجمود، ويُفتِّت – ولو بطيئًا- من حجارة الأفكار السلفية التي عفا عليها الزمن، وبالمقابل يتحرّك الناس نتيجة الأزمات التي ترتّب وقوعها على أثر ذلك الجمود، فالأمم – بحسب قول هاشم صالح- “ينبغي لها أنْ تدفع الثمن باهظًا قبل أنْ تُمسِك بأول الخيط الذي يؤدّي إلى النور [..] وينبغي لها أنْ تشهد كارثة حقيقية لكي تنبت فيها فكرة واحدة أو حتى نصف فكرة ذات معنى”، ويُقرّر هاشم صالح في كتابه المهم (الانسداد التاريخي) أنَّ تباشير تلك الكارثة لا تأتي جزافًا من دون بوادر عملية، لعل أبرز تلك البوادر هو السؤال، وإثارة السؤال في قضايا الفكر، ليس بالأمر الهيّن، فهو بحسب قوله: “محروس بالرجال، هناك قوى كاملة بعددها وعُدّتها مستعدة في كل لحظة للانقضاض على من تسوّل له نفسه أنْ يقترب ولو مجرّد اقتراب من منطقة السؤال، هناك جيوش كاملة من المراقبين والشيوخ والحراس والموظفين، هناك أمة بأسرها كانت قد بنت مشروعيتها، وأسست كيانها وهويتها على طمس السؤال، على تقييد السؤال بالأغلال، على تحويل السؤال إلى جواب”. وطرح السؤال يُدلِّل عدم قناعة السائل بما هو موجود من حوله؛ لكون الأجوبة لا ترتقي ومتغيرات العصر، وغير ذلك من دلالاتٍ تُؤذِن في الأخير إلى عصر تنويرٍ مُؤسَّسٍ على تلك الضرورات الفكرية، وليس ترفًا، أو تزجيةً للوقت، ومن هذا المنظور جاءت صرخة “كانت” التنويرية لتقول: “اعملوا عقولكم أيها البشر! لتكن لكم الجرأة على استخدام عقولكم! فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور والمكتوب. تحركوا وانشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل إيجابي متبصر”.