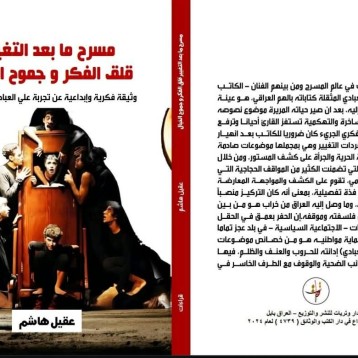عبد الحفيظ بن جلولي
لا يعتبر الحديث عن الرواية ترفا مفاهيميا يُتداول في أقبية المدرّجات وصرامة المخابر، أو مجرّد فكرة أنتقيها من هنا وهناك لأقدّم مداخلة، بالعكس يبدو لي أنّ الحياة بمدرستها المفتوحة على الواقع، على فنجان رواية وسطر قهوة، هو ما يمنح لذة الكلام حول نباهة السرد حين تشتهيه الحكاية.
تعتبر الرّواية الجنس الأدبي الذي يستحوذ على مساحة واسعة من السّرد، يطال تفاصيل التّفاصيل، ممتدّا بين الكلمات ليجعلها تتكلم عما يتجاوز الشّعر والرّسم والنّحت، إنّها الفرصة التي تمنح اللسان الكلام صامتا عبر وسيط اللغة، ليقول حركة الفواعل السّردية في انتشارها عبر الأمكنة المتعدّدة التي تشكل المسرح الذي ينبثق على أرضيته الحدث، وهي بذلك تأخذ العالم وفق قطائع تتناسب مع طبيعة الحكي لتتحوّل تضاريسا تتلاءم وتتالي المشاهد المخيالية العابرة لتجريد اللغة وصلابة الحركة في الواقع.
الرّواية بين فعل الذّات وفعل الخيال:
الرّواية ليست فرصة لترسيم كلام اليومي عبر صفحات ورقية، أي تبييض الواقع وفق ما تتطلّبه الورقة، الرّواية هي التّفاعل الخفيّ بين الخيال الذي يتدفّق به البياض والأشكال الشّبحية التي يهرّبها الرّوائي من موقعه القائم بين عالم الواقع وعالم الخيال إلى سكون الصّفحة، وحين يشعر برجفة الورق يبدأ في حوار تلك الأشكال التي ليست سوى هو متشظيا في ذوات متعدّدة، هل هذا يعني أنّه هو بالذّات والصّفات؟
لا يمكن الجزم في ذلك، ومن يحاول أن يجد الرّوائي بين طيّات الورق أو السطور، فهو قارئ متربّص بعملية الكتابة لا يريد منها سوى ما تقوله هواجسه حول النص باعتباره مؤامرة ضد الواقع بتجانسه الأخلاقي والسياسي والثقافي. يتساءل بعضهم عن سبب كتابة الرّواية، ويرى بأنّها تُكتب تسجيلا لمشاعر الرّوائي على ألسنة الشّخوص، ويستشهدون بمقولة، لعلي عزّت بيجوفيتس: «كل رواية هي سيرة ذاتية»، وفي حقيقة الأمر إنّ مثل هذه الآراء حول فعل الكتابة الرّوائية إنّما يختزلها إلى مجرّد «تسجيل»، أي إنّها بعيدة كل البعد عن الخيال وتنصّله من الواقع الذي يساهم في إنتاجه، إذا، هناك علاقة بين الواقع والخيال تنسف فرضية السّيرة الذّاتية التي يتمّ تأكيد وجودها يقينا في الرّواية، طبعا لا يمكن أن تخلو رواية من ذلك ولكن عبر تسريبات قد تمرّ عبر لا وعي الكاتب ذاته، لأنّ الكتابة الابداعية ينبت جذرها من عالم غامض يتشكل في ما وراء الذّات في حضورها الغائب لحظة الكتابة.
الرّواية وأطلس الجغرافيا:
من لا يملك مفاتيح الكلام في تخصّص ما، يفسد العلاقة بين القارئ وذلك المجال، لأنّ الجهل بميكانيزمات حركة الأشياء، الرّواية مثلا، يجعل المتحدّث يوظف بعض المفاهيم التي تُخرج هذا الجنس من واقعه التّخييلي والوظيفي إلى مجالات أخرى، ومن ذلك، يرى بعضهم أنّ من وظائف الرّواية «التّعريف بالبلدان»، ويستشهد برواية رسول حمزاتوف «بلدي»، ويرى أنّها من أجمل ما كتب عن تاريخ البلدان وحياة الشّعوب وهي «إحياء لتاريخ الإسلام في داغستان»، والحقيقة أنّ الرّواية في جوهرها، أي رواية، وهي تقدّم التّاريخ أو المكان أو شعب من الشعوب، لا تقدّمه مفصحة عن نفسها باعتبارها كتابة محدّدة بمنهج، ولكنّها هي تسرد حكاية تتطوّر فيها الأحداث متشابكة مع مفردات واقع ما قد تتداخل فيه العناصر المذكورة السّالفة، وبالتّالي يصبح البلد هو «المكان» الذي قد يتّسع في دلالاته ليشمل كل مكان معني بالحدثية التي يخضع لها في الرّواية، وهكذا مثلا تصبح داغستان في «بلدي» إحالية بالضّرورة إلى أمكنة أخرى تنبع من أخيلة المتلقين المندمجين في أفق الرّواية، وكذا الشّعب، يندرج في مجالية الشّخوص، أما التّاريخ فيتفكّك إلى وحداته الأولى مشكلا زمن الرّواية، وبهذا نستطيع أن نتكلم عن عالم الرّواية من منظور تقني له أدواته التي لا تنحرف بالتلقي إلى حافّة التداخل بين الحقول المعرفية.
لماذا نقرأ الرّواية؟
يبدو لي أنّ هذا السّؤال يعبّر عن طبيعة مجتمع تغيب عنه الأسئلة الجوهرية ولا يلامس إلا تلك المتعلّقة بالمعيش حتى ولو كان المجال خيالا وتخييلا، لأنّ المجتمعات المتطوّرة التي تعي أهمّية السّؤال في إنجاز الموضوعات التي تساهم في تشكيل وعيها انطلاقا من وعي بماهياتها، تغدو الرّواية فيها من العناصر التي يحتاجها الواقع كي يؤدّي مهمّته الإنجازية للأثر الوجودي، الذي تتفاعل فيه وجودات الأشياء والمخيال المستمد من الذّاكرة، والتفاعل الذهني مع اللاموجود، باعتبار أنّ هذا التّفاعل يشكل أحد روافد الواقع، ومن هنا كان سؤال الفيلسوف جان بودريار: «لماذا يوجد عالم واقعي واحد وعوالم متعددة من الخيال؟»، إذا، الخيال محايث للواقع، ومن هنا ينتفي سؤال الماذا تلك اللصيقة بقراءة الرّواية، لأنّها ترتبط أساسا بفعل القراءة الواجب حضوره في الذّات المتطلعة إلى أفق التّجاوز، ومنه تحوز قراءة الرّواية شرعيتها باعتبارها منفذا مهمّا إلى الخيال بحسبانه مادّة الاختراق نحو المناطق التي يعجز العقل عن إدارة حركتها أو تصور طبيعتها.
تقود هذه الماذا بعض التّفكير في الرّواية إلى اعتبار قراءتها طاردة للملل، في حين يعتبر العقل الواعي بأهمّية الخيال في تكوينه أنّ عدم قراءة الرّواية هو الجالب للملل، لأنّ فرضية الملل لا تكشف سوى عن جانب «التّرفيه» والتّسلية» في الرّواية، فيختزل عالم مكثف بالدّلالة ومفتوح على التأويل إلى مجرّد كلمات تجتمع في تراكيب لتؤدي معنى ينحصر في «التّسلية»، ومن منطلق التّسلية، يؤكد بعضهم على أنّها تقرأ في الإجازات، وهو تأكيد ينبثق من رؤية مجتمع برمّته لمفهوم القراءة، مجتمع لا يعتني بتكريس تقاليد ناظمة لعادة تعتبر ديدن العقل العارف، الباحث عما يمكن أن ينقده من رتابة المنطق الصّارم في الإحاطة بما هو موجود وكائن إلى ما هو غير مرئي وغير موجود، وبالتّالي تتشكّل خطوط عالم محايث للواقع منفصل عنه ومختلف، تمثل الحركة فيه مجالا لانبعاث الرّؤى القادرة على تمتين علاقة الواقع باللاواقع باعتباره فضاء الفن والجمال المبحوث عنهما في مسار تاريخية الإنسان.
النص بين فراغ الكتابة وخبرة القارئ:
تفكر بعيدا عن هامش الرّواية بعض الرّؤى حين تعتبر الرّوائي مخفي في روايته، أي أنّه يكتب ذاته، مثل هذه الرّؤية إنّما تصدر من قارئ يحكم على الرّواية ومن ثمة على كاتبها، في حين أنّ قراءة الرّواية هي إنتاج لرؤى تتعلق بالقراءة ومنظورات المتلقي المنبعثة من مستوى ذوقي، وبالتّالي يبحث القارئ في الرّواية عن الفن والجمال، عن كيفيات تأثيث السرد بجماليات الخيال، فيصبح النص منفصلا عن كاتبه لا باعتباره ميّتا، ولكن باعتبار القراءة منفصلة عن الشّخص الواقعي، فهي تتعلق بالشّخوص الورقية التي لا علاقة لها بالكاتب سوى من حيث إنه موجدها، ومن هذا الموقف حين ننتقل إلى نقد الرّواية، تصف بعض المواقف العملية النّقدية بأنّها ذاتية، وما مسمّيات النّقد المبدئي أو المعرفي سوى قضايا شكلية، لأنّ النّاقد له موقف شخصي من النص، موافقة أو رفض أو قبول أو اختلاف، والحقيقة أنّ رؤية كهذه إلى نقد الرّواية تمثل مدى بخس العمل الفنّي أهميته التّغييرية في الواقع وفي الذّات، لأنّ النّقد عملية تقوم على أسس ومبادئ توفّر آليات وأدوات لمواجهة النص باعتباره مُنتج تراكمات نصية، أي إنّ عملية حفرية في طبقات متعدّدة ومتراصة عميقة بغية الكشف عن قصدية محتملة للكاتب، فالذّاتية هنا هي تعبير عن وجهة نظر في النص وليس موقف شخصي من النص، لأنّ وجهة النّظر تتوافق ومبدأ الإمتاع في الأدب، أما الموقف فيختزن شحنة الرّفض. هناك من يقول بأنّ النّاقد ملتزم بثقافته ومعارفه أكثر مما هو ملتزم بالنص الذي يقرأه، فما معنى الالتزام هنا، بطبيعة الأمر، النّاقد ملتزم بما يعرفه وما يؤهله لقراءة النص وتفكيكه بغية النّفاذ إلى طبقاته المضمرة للوقوف على القصدية المحتملة للكاتب، وبالتّالي يصبح معنى «التزام النّاقد بثقافته ومعارفه أكثر من التزامه بالنص» لا مكان له في مستويات قراءة النص، لأنّ الذي يقع في دائرة النّاقد الأولى واهتمامه هو النص، وإلا ما توجّه إليه، لأنّ كل نص محكوم بذائقة القارئ، فتجد إمّا الإقبال عليه أو الصد عنه، لكن ليس بمزاج خالي من عناصر التعامل مع النص، بل وفقا لاعتبارات تتعلق بالنص وتجربة القارئ.