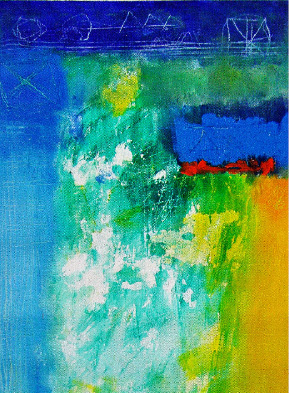سمية العبيدي
التصقت بالجدار وهي تضم يديها الصغيرتين خلف ظهرها بقوة حتى تكاد تهصرهما كأنها تخاف أن يمسهما شيء من ملحقات الجنازة المتسلسلة، ولم تبال بما يخدش الجدار منهما فهي لم تعد تحس بهما إطلاقاً، كانت الفتاة التي ظلت إحدى ضفيرتيها الغاليتين نصف مجدولة لأنها أسرعت تخرج من غرفة الصف الخامس الابتدائي كيما تحضر كغيرها مراسم التشييع البسيط من جهة والمفجع من جهة أخرى، كان الشحوب يفترس وجهها ويتمكن من عينيها اللتين تنتقلان بين نعش صغير من الجنازة متعددة النعوش وبين جدار كُتب عليه اسماهما بكتلة صغيرة من بقايا البناء – تقوم بما يقوم به الطباشير – وبينهما رسمت وردة بيضاء جميلة، كانا أول أمس قد رسما الوردة معاً ثم كتب كل منهما اسمه على ذلك الجدار وهما يضحكان لاهيين للحظات عما هما فيه من وضع غريب يغرق في الأسى، متناسيين كل ما جاء بهما وعائلتيهما الى هذه البقعة من أرض الله والى هذه المدرسة التي يجري توسيعها والتي احتضنت عدة أسر – لا يربط بينها الا تشرد النزوح – كامٍّ تفرد صدرها الرحب لاحتواء أولادها المكلومين وتضمهم في عباءتها، أول أمس رسما الوردة وكتبا الإسمين وها هو هنا يرقد في ذلك البيت الخشبي الصغير والأخير المحمول على كواهل المتعبين ويبتعد عنها وهو الصديق الوحيد الذي حظيت به هنا في هذه المدرسة التي باتت بيتها ومستقرها وحيها الى أجل غير مسمى . وكل من فيها من أناسي غدوا أهلها وذويها، كانت عيناها محمرتين متورمتين من أثر البكاء إذ سمعت بالخبر من فم الكبار ورأت إن القصف قد طال ثلة الباحثين عن قوت اليوم الساعين وراء اللقمة المليئة بالمن لا السلوى والذين كان أحدهم رفيق لعبها في باحة المدرسة التي لجأت اليها بعض العائلات الكريمة مضطرة.
انكبت على وجهها في الفراش الأرضي الذي دبرته امّها بالكاد وظلت تبكي بحرقة وبصمت الحجارة حتى سرقها النوم من حزنها المتنامي مشكوراً، وفي ضحى اليوم التالي خرجت من الصف الخامس تبحث عن سلوى في باحة المدرسة المزدحمة بالنازحين من أماكن شتى، وهي تجول وقفت مستندة الى الجدار الذي كتبا عليه بالأمس وفجأة رأت الحجارة الكلسية التي كتبا بها اسميهما، أسرعت بالتقاطها من الأرض وخبأتها في جيب تنورتها الصوفية المخططة طولا وعرضاً، لم تخرجها من جيبها بل نامت وهي تحتضنها بيدها الطفلة وأخذت تهدهدها كما تفعل ام لوليدها حتى تغفو عيناه وينام قريرا.
كان الطريق طويلا ومتشعباً وكانت تحمل فوق رأسها ما تسنى لامّها أن تجمعه من أفرشة ظنتها تكفي ولم تكن كذلك لأن إتجاه المسير كان شمالا حيث البرد أشدّ والجليد محتمل حملت هي الأفرشة إذ لا ولد ذكر للعائلة أما امّها فقد حملت أختها الصغيرة ذات العامين وجرّت وراءها ذات الخمس سنوات ووضعت على رأسها سلة كبيرة فيها الطعام وأدواته وأوانيه. ثم كان الرحيل الى المجهول. في الطريق رأوا مثلهم عائلات اخرى تمضي الى اللا مكان يفترس الهم قلوب كبارها اما الصغار فما في قلوبهم مبهم ككل شيء آخر حولهم فهم يلتقطون الأحاديث من هنا ومن هناك ويعلمون أنّ سوءا ما يحل بهم وبأُسرهم ولكنهم لا يفقهون أبعاد ما هم فيه فعلا. الأب يتقدمهم حاملا بيديه الإثنتين أثمن ما لديهم (الماء) فهو أُس الحياة وشريانها .. حاويتين ثقيلتين يراوح بينهما وينزلهما الى الأرض بين حين وحين آخر. كان الأب يشبه وعلا متعباً عليه أن يجتاز المسافات ويطوي الأرض ليقود العائلة الى بر الأمان غير أن الوعل أفضل منه بكثير فقد كان لديه حس الإلهام الذي فطره الله عليه وكانت لديه التجربة أما الأب فلم يملك من ذلك شيئاً، لذا كان الخوف على اسرته وعياله رفيقه في سفره هذا الى المجهول.
كانت الاسر تمشي كلا على انفراد وكلما تقاربت أُسرتان جرى بين أفرادها حديث سريع عن المأوى والقصد فلربما يعرف بعضها مكاناً آمناً، وربما انفصل فرد بين حين وآخر متوجهاً الى بناء متوحد ليرى مدى صلاحيته لإيوائهم ولو ليلة واحدة. كانت الساعات تمضي والأرجل تشتكي غير أن شكواها لا يستجيب لها أحد. فأوقات الراحة هي زمن تناول بعض الطعام وشرب جرعة من الماء على عجل. ويمضي الطريق بهم صعدا الى بقعة غريبة عنهم وهم أغراب عنها. ولكن الهم واحد فيلتحم المصير وتتولد علاقات جديدة ورفقة طيبة أواصرها الحزن المشترك وارتباك المصير.
وفي منعطف وتحت شجرة كبيرة صدر من الأب ورفيق درب آخر رب اسرة اخرى أمر بالتريث والنزول لتناول وجبة سريعة والتقاط الأنفاس، كان عليها أولا أن تنزل حملها الثقيل عن رأسها الذي غدا يتمايل فوق رقبتها الصغيرة التي تكلست من ألم وشد حركت يديها الصغيرتين …لتوازن الحمل قبــــل رفعه وإنزاله وإذا بيدين اخريين تمسكان الحمل معها لتعينها فيما أرادت وتنزل معها الأفرشة الى الأرض التفتت لتشكر .. وإذا بطفل لا يزيد عنها في العمر الا أشهراً هب َّ لنجدتها إذ لم ير أحداً بقربها ليعينها، ولد في نفسها عرفان لهذا الطفل ونشأت صداقة زمن البراءة الحلوة. حين وصلت العائلتان الى هذه المدرسة وجدت عوائل اخرى سبقت اليها خصصت غرفة الصف الخامس لإسكانهم فأصبحا جارين يعملان معاً ويلعبان معا وحين تأتي سيارة الماء يذهبان معاً ليملآ حاويات الماء لأُسرتيهما فتعمقت فيهما روح الصداقة وشربا الهم معاً فانسجما وأصبحا شقيقين روحا.
تحدثا عن مدرستيهما ومعلميهما ومدينتيهما الصغيرتين وكلّ ما خطر بذهنيهما الطفلين ولعبا معاً ألعاباً ذهنية وسردا قصصاً وألغازاً وأحاجي ورسما أشجاراً وأزهاراً وأطفالا وبيوتاً ثم بعد أيام اخر رسما وردة بيضاء وأحاطاها باسميهما الجميلين مثلهما …. لكنه انصرف عنها الآن تاركاً اسمه على جدار المدرسة مثل شبح طيب مضى ناسياً ظله فوق الجدار العتيق.