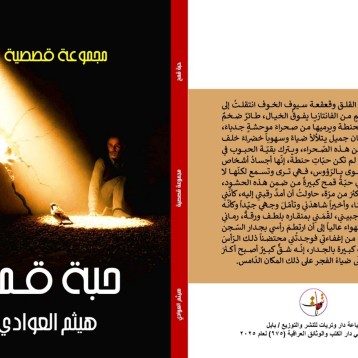الدكتور عادل الثامري
ينسج المتكلم في قصيدة “دروس في الغواية” للشاعر كريم شغيدل خيوطا متعددة من التجربة الإنسانية عبر سلسلة من دروس تتحدى السرديات التقليدية للغواية والذاكرة والبقاء. يدمج النص صورا علمية مع استعارات روحية لخلق لغة شعرية فريدة تتحدث عن الوجود في العصر الحالي وفي الوقت نفسه تحافظ على صلات بالموروث. وباستعمال مبتكر من الصور الشعرية الكيميائية والطبيعية والحربية، تستكشف القصيدة العلاقة المركبة بين الصدمة الفردية أو الشخصية والذاكرة الجمعية، وتقدم عالما تخضع فيه العناصر الأساسية للوجود مثل الهواء والحب والذاكرة للفساد والتحول.
تتجلى وظيفة التلقين في القصيدة بتكرار لازمة “لقّنيني” التي تؤسس لبنية القصيدة وتعمق دلالاتها على مستويات متعددة. فعلى المستوى البنائي، تعمل هذه اللازمة كعنصر يقسم القصيدة إلى مقاطع متتابعة، خالقة إيقاعاً خاصاً يربط بين تجارب متباينة. أما دلالياً، فيقلب التلقين مفهوم التعليم التقليدي رأساً على عقب، اذ يطلب المتكلم دروساً في الغواية والنسيان والحماقة، مؤسساً لمعرفة مضادة تتحدى المفاهيم السائدة. ويكشف هذا الطلب على المستوى النفسي عن توق عميق لنوع خاص من التعلم، يجمع بين الرغبة في المعرفة والحاجة للتحرر من أعبائها، مما يطرح إشكالية فلسفية حول طبيعة المعرفة ذاتها. وبهذا يتحول التلقين إلى رمز للعلاقة المعقدة بين الإنسان المعاصر والمعرفة، وتتحول المفاهيم السائدة وتتشكل من جديد: فالغواية تصبح معرفة، والنسيان حكمة، والحماقة ضرورة، مؤسسة بذلك لرؤية جديدة للعالم والذات تتجاوز الثنائيات التقليدية وتستجيب لتعقيدات التجربة الإنسانية المعاصرة.
تفتتح القصيدة بإعادة تشكيل جذرية لقصة التفاحة في السرد التوراتي ، اذ يقدم الشاعر موقفاً مغايراً عبر التصريح بعدم الاهتمام بفعل القضم (“لقنيني درسا في التفاحةِ؛/ لستُ معنيا بقضمِها”). هذا الموقف يتجاوز الثنائية الدية للخطيئة والمقاومة، ليؤسس علاقة أكثر تعقيداً مع مفهوم الغواية. فالتفاحة هنا لا تكتفي بكونها رمزاً للخطيئة الأولى، بل تتحول إلى استعارة للوعي والاختيار في مواجهة الإغراء المعاصر. يكشف هذا التحول في معالجة رمز التفاحة عن أزمة روحية معاصرة، تبدو فيها الأطر الدينية التقليدية عاجزة عن استيعاب تعقيدات المعاناة الإنسانية الحديثة. فعدم اكتراث الشاعر بالفعل المادي للأكل يحول التركيز من الخطيئة الجسدية إلى الأبعاد الميتافيزيقية للمعرفة والاختيار. وبهذا تصبح التفاحة رمزاً لتحول الغواية نفسها في السياق المعاصر، اذ تتجاوز ثنائية المقاومة والاستسلام لتصبح قوة مزدوجة قادرة على الخلق والتدمير معاً. وعلى المستوى الشعري، يوظف الشاعر التفاحة كنقطة انطلاق لتأسيس لغة شعرية جديدة، محولاً الرمز الديني إلى استعارة معاصرة. ويمتد هذا التحول ليشمل طبيعة المعرفة نفسها، متحولة من المعرفة المحرمة إلى المعرفة الضرورية، ومن الخطيئة إلى الوعي. كما تتحول طبيعة الغواية من الإغراء الخارجي إلى التأمل الداخلي، ومن المادي إلى الروحي. وتتغير العلاقة مع المقدس من الطاعة العمياء إلى الوعي النقدي.
تمزج صورة “رحم النخلة” عدة موتيفات . فالنخلة كرحم قادر على إنجاب قديس يستحضر قصة مريم القرآنية حين تلقت رزقها من النخلة، كما يستدعي التبجيل العربي القديم للنخلة كرمز للحياة والخصب. لكن استحالة أن تنهي هذه الولادة المعجزة المعاناة (“لا تنتهي حتى بولادة قديس من رحم النخلة”) تؤسس لشك عميق تجاه المصادر المعروفة للعزاء الروحي. تتحول الصورة إلى تعليق نقدي على عجز السرديات الدينية الموروثة عن معالجة المعاناة المعاصرة، اذ تتحول النخلة من رمز للخصب والحياة إلى شاهد على العقم الروحي في عالمنا الحديث. وهكذا يتحول الرمز المقدس إلى نقيضه، فالنخلة التي كانت مصدراً للحياة والمعجزات في التراث الديني تصبح دليلاً على استحالة الخلاص في عالم فقد قدرته على إنتاج المعجزات.
تقدم القصيدة صورة مزدوجة للمتكلم “كيميائي” و”عشّاب”، اذ يتجلى في دوره الأول كعالم مخبري يتعامل مع المشاعر كمواد قابلة للتحليل والمزج، محاولاً بذلك ترشيد العواطف الإنسانية المعقدة بواسطة المعادلات والتجارب (“أمزج أحماض المشاعر بفلزات التوتر”)، بينما يرتبط دوره كعشّاب بالتقاليد القديمة للشفاء الروحي والفهم العميق للنفس البشرية. هذا المزج الفريد بين العلم الحديث والممارسات التقليدية يخلق توتراً يعكس محاولة الإنسان المعاصر للتوفيق بين العقلانية والروحانية، اذ تمثل التفاعلات الكيميائية العنيفة الاضطراب العاطفي الداخلي، في حين يشير مزج الأعشاب إلى البحث عن انسجام أعمق مع الطبيعة والذات. يظهر المتكلم بوصفه خيميائيا معاصرا يسعى جاهداً للسيطرة على العواطف بأدوات العلم (“لأحسنَ نسل الحب”)، لكن هذه المحاولة الطموحة تكشف في النهاية عن استحالة إخضاع المشاعر الإنسانية، وخاصة الحب، للمنطق العلمي البحت، مما يجعل من الممارسات المختبرية – من مزج وتحليل – استعارة لمحاولة الإنسان المستمرة لفهم وترويض ما يتجاوز بطبيعته حدود الفهم العقلاني، في سعي لخلق معنى في عالم معاصر يتأرجح بين صرامة العلم وعمق التجربة الروحية.
تقدم القصيدة تصويراً عميقاً ومركباً للحرب كتجربة تتجاوز فهم الحياة والموت، ويجد المتكلم نفسه عالقاً في منطقة وجودية غامضة، لا هي بالحياة الكاملة ولا هي بالموت النهائي (“درسًا في الحرب التي قُتلتُ فيها وبقيت كسرةٌ مني عالقة”). هذه الحالة البينية تخلق توتراً مستمراً بين الوجود والعدم، وتتحول الحياة نفسها إلى سلسلة لا متناهية من الموت والبعث (“فأحيتني حرب أخرى لأُقتل فيها وأموت”). في هذا السياق، يتحول البقاء على قيد الحياة من كونه انتصاراً على الموت إلى شكل من أشكال العذاب المستمر، يشبه في طبيعته العقوبات الأسطورية الخالدة التي لا تنتهي. تستخدم القصيدة صوراً شعرية قوية لتجسيد حالة التفتت والتشظي التي تخلقها الحرب، اذ تترك كل معركة جديدة شظايا من الذات معلقة في فضاء الدمار. هذا التمزق لا يقتصر على البعد المادي الجسدي فحسب، بل يمتد ليشمل الهوية والروح، وتصبح الذات مبعثرة عبر سلسلة من الوفيات والبعثات المتكررة. مع كل حرب جديدة، لا يأتي الشفاء، بل يزداد التفتت عمقاً وتعقيداً، مما يحول تجربة البقاء إلى شكل من أشكال الصدمة المزمنة التي لا تنتهي. يتجلى هذا التمزق النفسي والوجودي بشكل خاص في صورة “الجوع الذي يكسر القلب”، وهو جوع يتجاوز مجرد الحرمان المادي ليعبر عن شوق عميق للخلاص والاكتمال. هذا الجوع يمثل رغبة جارفة في إنهاء دورة العنف المستمرة والعودة إلى حالة من السلام. يصبح القلب المكسور هنا رمزاً مزدوجاً، يجمع بين الألم الجسدي والدمار العاطفي الذي تخلفه الذكريات والصدمات المتراكمة. تطرح القصيدة في النهاية رؤية للبقاء والمقاومة، اذ لا يأتي البعث الجديد بالراحة أو الخلاص، بل يحمل معه يقيناً قاسياً بحتمية موت جديد (“لأُقتل فيها وأموت”). ومع ذلك، يستمر المتكلم في العودة إلى الحياة، في تجسيد لشكل عنيد من المقاومة التي ترفض الاستسلام للفناء الكامل، حتى مع علمها أن كل حرب جديدة ستسلب جزءاً آخر من الذات. وهكذا تتحول تجربة الحرب في القصيدة إلى حالة وجودية مستمرة من الصراع بين إرادة البقاء وحتمية الفناء، في جدلية معقدة تعكس عمق المأساة الإنسانية في مناطق النزاع.
إحدى أكثر الصور إثارة في النص تظهر في العبارة: “تجاعيد قتلى هرموا في العراء”. هذه الصورة السريالية، التي تصور جثثًا تواصل التقدّم في العمر تحت تأثير العراء، تخلق موقفا من ضحايا الحرب غير المدفونين والصدمات النفسية غير المعالجة. الموتى يشيخون، مما يوحي بأن الموت نفسه لا يمنح الهروب من مرور الزمن وتأثيرات الحرب. تصل التسلسلات إلى ذروتها في العبارة: “وبي عطشٌ إليكِ”، اذ تتحوّل صور الحرب إلى رغبة. هذا التحوّل يشير إلى أن حتى أبسط الرغبات الإنسانية تصبح مشبعة بتجربة الصراع. يحمل العطش هنا معنى مزدوجًا، فهو يعبر عن الحرمان الجسدي والشوق العاطفي في آنٍ واحد.
تختم القصيدة بطلب اخر هو تعليم العبودية لقنيني درسا في العبودية”؛ هذا الطلب ليس رغبة في الخضوع بقدر ما هو اعتراف ضمني بالعجز عن التحرر الكامل. الحرية هنا ليست بالضرورة حلاً أو شفاءً، بل قد تحمل تناقضاتها الخاصة، مما يجعل “العبودية” مجازًا لاستيعاب الألم أو قبوله كجزء من التجربة الإنسانية. يتحدى النص السرديات التقليدية التي تقدم الحرية كدواء لكل الآلام. يشير إلى أن الألم الشخصي، خصوصًا عندما يكون حادًا ومتجذرًا، لا يمكن تجاوزه بوصفات عامة أو حلول مثالية. هنا، يتجلى شعور المتكلم باليأس من جدوى السرديات الكبرى، مثل التحرر أو الهروب وأخيرا يعمّق الإحساس بعبثية الهروب: ” فمرويا ُت التحرر ليست وصفات ناجعة / لشفاء آلامِك الحادة /. آلامُك لا تنتهي” والسفر “سواء سافرنا إلى مدن الثلج ” وهي صورة رمزية للبرودة أو السلام أو التجديد، لا يخفف من الآلام. كما أن البقاء في الغرفة، التي ترمز إلى الحميمية أو العزلة، يظل محفوفًا بنفس الألم. وتعبر “نظرات الاحتراق” عن التوتر العاطفي المشترك بين المتكلم والآخر، اذ يصبح الألم مشتركًا ولكنه غير قابل للتلاشي.
تُقدّم قصيدة “دروس في الغواية” للشاعر كريم شغيدل رؤية مركبة ومؤلمة لتجربة الإنسان في عالم معاصر مليء بالتحولات والاضطرابات الروحية والجسدية. وعبر الاستعارات الكيميائية والحربية والطبيعية، ينسج الشاعر عالماً تتداخل فيه الآلام الشخصية مع الذاكرة الجمعية، ويبرز كيف أن الصراع بين الجسد والروح، بين الماضي والحاضر، لا يمكن أن يُختزل إلى حلول جاهزة. في هذا السياق، تصبح الغواية والحب والحرية مفاهيم مشوهة ومعقدة، اذلا توفر الإغراءات أو الأيديولوجيات السياسية جواباً شافياً. تدعونا القصيدة للتأمل في تقلبات الوجود، وفي الأسئلة الكبرى التي تبقى دون إجابات، لتُظهر أن الألم والوجود هما جزء من دورة مستمرة، يتسم فيها الإنسان بالعجز أمام التغيير، لكنه في الوقت ذاته يواصل المحاولة لمواجهة التحديات الوجودية.