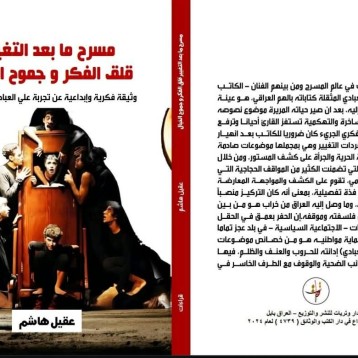إذا كانت الحرية مدينة الفلسفة، فإن المثقف هو زعيم تلك المدينة، وقائدها، وهو حامل لواء التنوير، بيده شعلة الوعي، يطوف بها أرجاء مدينته، باحثا عن العتمة، كي يحرر يحتلها بضوئه الساطع، طاردا الظلام منها.
المثقف هو الكائن الاشكالي، الغامض حد الوضوح، الواضح حد الغموض، يملك ما لا يملكه أحد غيره. مفاتيح المعرفة التي أعطيت له، يمكنه بها فتح الأبواب دون استئذان. ولكون أن المثقف، كان وحيدا في الساحة، يمارس طقوس المعرفة ونشر الوعي، بين أوساط المجتمع. فهو صاحب رسالة، ووجوده مرتبط بتلك الرسالة، وقيمته كإنسان أولا، وكمثقف ثانيا تعتمد على مدى قدرته على إيصال تلك الرسالة إلى متلقيها، وقدرته تلك تعتمد على ما يملكه من آليات تواصلية مع المتلقي. ولعل قدرته على فهم ذلك المتلقي، والتضاريس القاسية التي عليه السير فيها، والطرق الوعرة والخطرة التي لابد من السير فيها، هي أبرز ما يواجهه المثقف من تحديات ومحن. فهو أمام خليط غير متجانس، أمام أفكار مشتتة ومقيدة، بعضها يعشق تلك القيود ويضحي نفسه من أجل أن يبقى مقيدا بها. قيود الأعراف والموروث، قيود المدينة والقرية، والعشيرة والطائفة… كلها قيود على المثقف أن يكون خصما لها، وسلاحه الوحيد هو القلم والكلمة. وفي ظل تصاعد موجهات الرأي العام عبر الفضاء الافتراضي، وبروز فئات وأفراد أخذت زمام المبادرة من خلال القدرة على تحييد الجمهور ومن ثم دفعه ليكون تابعا لها ومنقادا لتوجهاتها عبر ما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولعل ما ساعد تلك الفئات وأعني أصحاب الصفحات التي تملك أعدادا كبيرة من المتابعين الذين تتشكل أراءهم ومواقفهم من خلال ما تبثه تلك الصفحات، وهو اعتمادهم على آليات تتناسب مع المرحلة الجديدة، وعبر استقراء ما يرغبه الجمهور ويريده، فهم استطاعوا أن يصلوا إلى المكامن الداخلية للجمهور، واللعب على الأوتار الحساسة له. فكتبوا ما يريده ذلك الجمهور، وما يتمنى سماعه، حتى لو كان مزيفا وغير واقعي، حتى لو كان لا أخلاقيا ولا قانونيا. بالمقابل، نجد المثقف، لازال حارسا لأفكاره وحاميا لأوهامه التي لا يريد الاعتراف بأنها أصبحت من الماضي، لازال بعض المثقفين، يعيشون في أبراج من النرجسية والتعالي على الناس، لدرجة أن بعضهم يكتب بلغة متعالية، تغلب عليها مصطلحات منحوتة، ومقولات فلسفية وعلمية لفلاسفة لا علاقة لهم بالواقع وما يحتاجه، بل إن بعضهم تبرأ من واقعه ومجتمعه، كأن يتخلى عن اسمه ويختار اسما غير مألوف أو ينتمي إلى ثقافة أخرى، أو كأن يقلد شاعرا أمريكيا كان يقضي معظم أوقاته عاريا! ورغم كل ذلك، فإن هذا النمط من المثقفين، لازالوا يعتقدون بأنهم الورثة الشرعيين لحاملي شعلة التنوير، التي لم ولن يشعلها أحد ما دام الوعي يشكله المراهق والصبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومادام المثقف، تقهقر إلى جدران ذاته التي أصبحت من الماضي، وحق على المجتمع بدلا عن السير خلف المثقف، زياته في المتحف!
سلام مكي