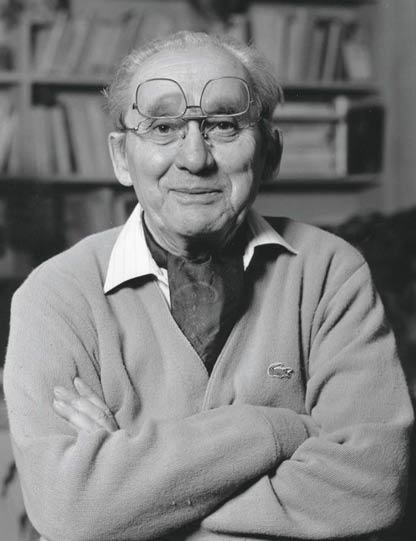قيس مجيد المولى
أحيانا لايتم التركيز على أشياء بعينها أي لايضع الشاعر له خلفية قبل بدء الإنتاج ولربما أن تشتت الرؤى والأفكار يوديان إلى تشتت الغرض الذي من أجله يُكتب النص ،ولاشك أن هناك إيحاءات للذهن وإيحاءات بصرية وسمعية وكلها قد تستقل بمعانيها أو تتداخل بعضها مع البعض في المضمون الإفتراضي الذي يقرره كاتب النص سواء بالرمز او بالإيحاء أو بالتسلل البطئ من قبل المتلقي للمعنى الأُحادي التعبير أو مايسمى المعنى الخاص وهو اعتقادٌ بأن النص الحداثوي لابد أن يمر عبر تلك الآصرة عندما يتم تغييب وبقدر محسوب عاملا الزمان والمكان والإستعارات المفرطة والتشبيه المُمل والإيقاعية الأرغامية وكذلك محاولة الإنتقال بالمعنى قسريا إلى المعنى الرنان بالقفز فوق الإحساس بالكلمات ولا بقدراتها التعبيرية العاطفية أو ضمان إنسيابيةٍ أمثل لها إن أُستخدمت السخرية أو أُستخدمَ شكلٌ من أشكال الدراما الحزينة التي تُلتقط من السمع والبصر والذائقة الخفية ، لقد أشار رتشاردز بأن الكلمة تستطع أن تحمل ظلالا مختلفة من المعاني وأن مضامينها تنبسط أو تتحرك حسب ماتقدمة وما سوف يتلى بعدها من ألفاظ أي أن هناك وأثناء عملية الخلق تطوران متصاحبان تطور في اللغة يصاحبه تطور في الشعور مما يدفع بكاتب النص إلى معاينة جديدة لإسترساله وإلى التفريق بين النمو التلقائي والنمو المستحدث بإرادة المتغير الجديد في اللغة والشعور وهذا يعني أن الشاعر قد وجد مجالا جديدا لفقدان الطمأنينة أي السماح لبنية النص بتبني صراعا جديدا ليس بالضرورة أن يتفق مع عروضه التي قدمها مبكرا ، ونعتقدَ بأن النص بشموليته سيصب ضمن هذا المعنى.
إدراك الخصائص المحورية
أن الشاعر يعي ذاتيا كيفية فهم الأنماط السلوكية للكلمة وكيفية سرد بياناتها اللاإرادية وهو تبلورٌ فجائي يزيد المخيلة عمقا ويحررها من ثقلها غير المناسب وهذا يعني إنقاذها من البقاء في عاطفة مطلقة أو ضمن معرفة مقنعة بالقياسات والضوابط ،
ولعلَ إدراك تلك التراكيب وتلك الرؤى وتلك التصورات للحداثة الشعرية يتطلب من المتلقي فهما أوسع لطبيعة الجمال إن كان مخبوءا في الإيحاء أو في الغموض أو حتى في التغريب مادام الشعر منتجا غير ثابت مما تنتجه الحواس.
إن الإحساس باللحظة المناسبة يعني إدراك مالايُدرك من الخصائص المحورية لهذا العالم والتي تعكسها إداء أي من الموجودات المستخدمة حين يحسن إنتقائها وأتقانها بل وحين يحسن نقلها لمكانها المناسب عبر تجديد تشوهها بتشوه مناسب لتخلق جمالها الذي تختاره ضمن قائمة الموضوعات الأبدية المفعمة بالحزن والموت والغياب
وهو عمل يترتب عليه أن يطرق الشاعرُ أكثر من باب في ذاته ليجد أن الجمال في كل مكان بدون أن يقرر أن ما يكتب عنه واقعاً أو أسطورة.
لحظة القبول ولحظة التكيف
ترمز المخيلة أحيانا عندما تبدأ بتصور المشاهد ثم خلقها إلى كشف مناطق الإرتباط وخاصة حين تقترب من أحداث متماثلة وبالتالي فأن أي تكرار من قبل المخيلة لتلك المشاهد ينشيء عنه إستلام صور مقربة للشيء المكرر أو بالأحرى الذي يقع عليه التكرار ، وهنا نعني بالتكرار هو تأثير مشهد ما على المخيلة الشعرية يرغمها لعمل إجراءات معينة على هذا المشهد ضمن مفهوم مبدأ الإرتباط ولا يشكل إرتباطات متصلة ومتتالية بل هي إرتباطات مجزأة بفعل تأثير الشعور وكذلك الطريقة التي يتم التفكير بها وكذا نوع المصادر التي توحي لنا بما يثير الإستعداد لقبول المجهول وهو أشبه بالمران النافع لعملية الإستبطان أي أن المخيلة أحياناً تتشكل من مجاميع من الصور المتقاربة المتباعدة في الوضوح وهي ضمن هذا الوصف تبدو سلبية للوهلة الأولى وتكون إيجابية حال ظهور المنبه الملازم الذي يكشف عن توافق مابين لحظة القبول ولحظة التكيف التي تحدثها الإنعكاسات النفسية والمعرفية والأسطورية بعد فترة من الإنطفاء وهذا الإنطفاء يكون انطفاءاً مؤقتاً أثناء عملية الخلق الشعري لأسباب متنوعة من بينها عدم القناعة بما يصل إليه الشاعر أثناء كتابة النص أو الإصرار على البقاء في حيز واحد لإنتاج فكرة مركزية واحدة أو محاولة التخلص من مشهد دخيل وعدم القدرة على إحلال بديل عنه رغم مساهمة البعض من الملكات العقلية كالذاكرة مثلا في إستجلاء الماضي وتقديمه بخصائص جديدة .
إسناد الذاكرة
إن الصور الذهنية وكذا ضروب الفرضيات التي تشترك بها أجزاء من العقل لتقديم نوع من الإسناد للذاكرة لإعطائها مساحة أوسع في عملية التذكر وهو مايعني الدخول للأشياء المبهمة ورؤيا المناطق الأكثف إبهاما أي إختيار نقطة ما للإستدلال على شكل ذلك الإبهام ونوعه وهذا لاينطبق على الصور فقط وإنما ينطبق أيضا على شعور المخيلة بالأصوات والألوان وهو أيضا بمثابة المران الذي يمكن بواسطته التدليل على شيء من خلال الصوت المناسب له بدلا من الصوت المعرف به وتجسيد هذا الشيء في معنىً ما أو نغمة أو لون وتلك العمليات عمليات مشابهه لما تقوم به حواس الإنسان ، وهو كما ذكرنا ينطبق على المخيلة إن إعتبرنا أن لكل شيء مستلماته لتشخيص الأشياء والقبض عليها من قبل وظائف الحواس بالرغم من وجود ( في الشعر خاصة ) أشياء غير مطابقة للخصائص التي نتحسسها في الحياة ناهيك أن الأشكال تخضع لحالة من التحولات ( المغلق – المفتوح- المتناظر – المتعاكس – الدائري … ) ولكن هذه الأشكال تخضع لبيانات جديدة تصهرها بأشكال جديدة بحيث تعطي أبعادا غير منظورة وقابلة في نفس الوقت على التحلل والإحلال وخلق النظام الغامض الذي يشكل مدخلا للهروب من الواقع والمألوف المستبد في الذاكرة الموروثة لتبدو بعد ذلك تلك الأشكال أشكالا منسقة وهنا أن الشكل المنسق لايعني وضوح هيكليته المكون من المفردات والأصوات وإنما وضوح قدراته التنسيقية مع مايختاره الشاعر من مؤثراته العاطفية وينسجم إنسجاما كليا ومفيدا مع تلك الأشكال التي تعني المواد الأولية التي يختارها الشاعر أو بالأصح تختارها المخيلة والتي تعمل بالضد لا على وحدة بعينها وإنما العمل بمفهوم الإنتباه الموزع والذي يعبر في أحايين كثيرة كونه ضرب من ضروب النشاط المصاحب لقدرة المخيلة على تفكيك إتجاهاتها لتتمكن من التحول السريع بين المشاهد بعيدا عن بؤرة الإنتباه المركزية وتبدوعملية التداخل وهي عملية يقدرها الشاعر على أنها خيط ما بين الصور العقلية وحاسة معينة أو هي ربط لأفكار بحاسة ما وأكثر الأشياء التي تقع ضمن هذه العملية التصور اللوني والتصور العددي وتصور المتتاليات والمتشابهات ولكن أهم تلك التصورات هي تلك التي تقع خارج تصور العقل وأهميتها تكمن في أنها صورا متنقلة تختفي وأحيانا تمحى ولكنها تعاد تلقائيا بتأثير ما وبقدرة جديدة وبتصور فعال ورموز مجسمة وهو مايعطي لعملية التخيل طريقا أخر الى مراكز اللاشعور للوصول للأشياء الدفينة والتي لايعيها غير وجدان الشاعر ورغبته بالسمو في عالمه ،عالمه في البدء بلحظة قبول نصه ثم إيجاد التماس الملائم لخلق لحظة التكيف والتي يراها إزرا باوند نداء الأعماق الذي يدعو للشاعر للإنسلاخ من العالم الظاهراتي والإنسياح الى عالم الباطن حيث السّحر والديمومة بعد أن تم تأمين متطلبات إسناد الذاكرة ،
الرؤية النقدية
يميل الشاعر أحياناً أن لايضع الرؤية النقدية موضع الإهتمام عند كتابته لنصه ، ومنها أن تكريس الزمان في النص أو السير بخطى المكان أو التفاصيل الشخصية والوقائع من الأسس الملزمة للشاعر لبلوغ مهمته الجمالية ،ولاشك أن هناك من يتصور بأن الشعر وظيفة طبيعية للإنسان وأيضا هناك نقيض هذا الرأي من أن الشعر (مهارة معزولة ) ،وهناك عبر تاريخ النقد الأدبي الحديث الكثير من التصورات والمساجلات عن المفاهيم المتضادة لكثير من المفاهيم الأدبية والكثير من الإشتراكات في مفاهيم أخرى تخضع إلى اليوم إلى النقاش من أجل بلورة كينونة ما للوصول إلى الحكم الصائب حول هذا المنتج أو ذاك ،
ولاشك أيضاً أن ليس هناك من أمر واضح وقطعي في الشعر وليست هناك معرفة ما لنص الشاعر إلا من خلال الشاعر نفسه وما يُفسر وما يتم تقديمه حتى من قبل المعنين إنما يمثل الجانب الخارجي للمحتوى الباطن ،هناك عروض نقدية إنطباعية لا تنظر الى المنتج الشعري بكيانه النهائي والمتكامل بل مجرد إلتقاط أنفاس الشاعر وفق المغالطات النقدية التي لاترتكز الى النقد الإبداعي فليس هناك من تأمل خالص في العمل وليس هناك مساحات أوسع من المساحات المحددة في ذهنية الناقد وليس هناك قدرة (لمحو الزيف وإتاحة المجال لما هو أفضل ) ،فأحيانا تُفهم السُّخرية في نصٍ ما بعقلانية وموضوعية وأحيانا تفهم بأنها الفوضى المُنتجة وهذا التضاد في الفهم أو لنقل في الرؤيا ينعكس كذلك على أي من الاستخدامات التي يلجا الشاعر إليها للتعبير عما تريد حريته سواء عن طريق الغموض أو التعامل مع الموروث أو بتقديم شكل أخر للأسطورة أو المغامرة على صعيد الموضوع أو المغايرة وتفكيك اللغة لأنه يرى من الضرورة أن لايعيد مشاهد مشابهة ومكررة وإن كانت مختلفة عن الواقع لأنه يريد أن يكون إختلافها عميقاً وواسعاً ولا يفضي لحقيقة ما لأن الشاعر حين يكتب يعيش معضلته الخاصة به وليست معضلة مايشتهي الآخرون نقادا وقراء وهو يبحث عن النسق الآخر الذي من خلاله يستطيع البوح بسره غير المعلن وبكشوفاته إزاء الكون وكل مايتصل بأحاسيسه ويراه قابلا لعرض اللامتناه واللامقبول أي أنه بإزاء إحداثِ شكل من أشكال الانفصال المقدس مابين فرضيات يقررها كيانه كوجود ومابين الرغبة في عدم الأمان لذلك الوجود ،
وهو شكل من أشكال الرغبة في التحرر المطلق من الفهم السائد عن الوجود الإنساني ، أن المعايير النقدية لاتلزم الشاعر بطبيعة لغة ما أو شكل شعري ما أو كيفية التعامل مع العاطفة أو الإنفعال وهو إزاء هذه القضايا مستمع جيد لاغير ،ولن يكون منفذا لما يطرح كي لايكون هناك كما أُنتقد دريدن (نقصا في شجنه ) وكما أُنتقد أديسون (نقصا في الحرارة والتدفق ) ،المغزى مما يراد هنا هو السعي لبعثرة أي شيء منظم وإحالته إلى إشارات لايستطيع النقد من تفسيرها.