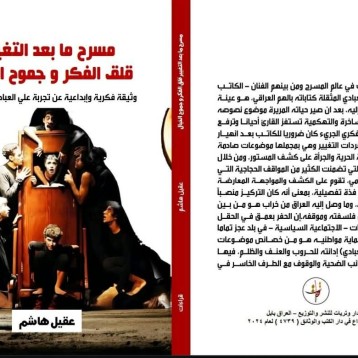صدام الزيدي
ينطلق الشاعر زاهر الغافري، في استدعائه لهذيان نابليون بعد موته، ضمن كتابه الشعري «هذيان نابوليون»، الصادر حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر في الأردن، من المشفى الذي أدخل الحوذيون نابليون فيه، وهي نقطة بداية لنص طويل ومختلف، فهناك، وفي تلك اللحظة، تحديدًا، بدأ نابليون يفقد كلماته، وكلما حاول أن يصرخ، يخرجُ من لسانه صوتُ آكل النمل، وهنا يتم استدعاء مكان هو أشبه بسجن صغير.
«ممرات هائلة» تنفتح وتتسع في نطاق مشفى صغير، يشبِّهها الغافري، على لسان نابليون بـ»متاهةٍ بين الأرض والسماء»، وثمة محاولات لنابليون في سياق تفكير وقتي، ضمن هذيان طويل، للخروج من النافذة، متوهمًا أن حياته كلها بدأت في مقبرة.
في موازاة هذيان اندلع توًا، يحاول نابليون معرفة ما يجري حوله، وفي داخله، من هلوسات وصرخات، لكن لا أحد في وسعه أن يسمع صرخات رجل مات، وبعقل مشدود إلى الفراغ المرغب والأكوان الصامتة في النفس البشرية بعد استسلامها للموت، ولأن صرخات جسد مسجىً لا تصل إلى مسامع الذين هم أحياء، في الجوار، تبدأ حالة الهذيان في التحول إلى تقنية المساءلة الصامتة، حينما، في موسمٍ لا يتحدثُ فيه أحد، يوجه نابليون سهام أسئلته المرعوبة من فكرة أن نذهب إلى عالم آخر، ولأنه بات مدركًا أن لا أحد يمكنه أن يسمع، وأن صرخاته لن تتجاوز المحيط المعتم في داخله، يتدخل هذيانه مناديًا على «راعية أكباش»، هكذا استدعى الكاتب الغافري الراعية، وكأنه من ناحيته، لكي ينجز نصًا جديرًا بالكشف الشعري، ومتحررًا من أي قيود وإكراهات وأنماط وهياكل مسبقة، قفزت إلى مخيلته، فكرة أن يصرخ متسائلًا ناحية راعية أكباش، في موسم صمت مهيب، وفي يقين أخير بأن جدرانًا من الفولاذ الصلب، هي المعادل الممكن للحديث عن «المصير»، وهي صورة شعرية مبتكرة لتدوين الفناء المرعب في الأغوار السحيقة لروح كانت، على قيد الحياة، تصول وتجول وتخطط وتحارب وتأمر وتنهى، أما في حالة نابليون الآن، فـ»المصيرُ لا يُشبه جدارًا من الفولاذ»، وكم هو بائس وخاسر أن يطلب رجل ميت من راعية أن تترفق بعظامه، وهنا، تتلاشى فكرة الجدار الفولاذي تحت متغير الانسحاق إلى رماد، فالعظام، التي تعد أقوى مكونات الجسد، هي في طريقها لأن تتفتت وتتماهى مع تراب الأرض، حيث المقبرة هي المصير لجسد مات.
رويدًا رويدًا، تزداد حمى الهذيان، وما من سبيل إلا بمواصلة هذيان غير مسموع، أمام أبواب مجازية لا تُفتح، ويا للأسف: من تتحدث الكتب عن انتصاراته (إذ يعدها نابليون نفسه، انتصارات)، يا للشفقة! إنه الآن مثل رجل أصيب بالجذام، يدرك فعلًا أنه الرجل الميت، وبالتالي ترتفع وتيرة السخط من مآل لا مفر منه: «ما هذه المزبلة، ومَنْ يحكمُ الكون، الله أم أنا؟ هل أنا نائمٌ في بئرٍ تُغطيني الطحالبُ؟ هل أمشي في الممراتِ مأخوذًا بأرضٍ لم تكنْ أرضي»؟
الممرضة المشتهاة
نابليون، وقد أمسى ميتًا، يقبع في ماخور على حد تعبيره المتخيل من قبل الغافري، في (مارستان هابط من السماء)، فيا للغرابة، كل تلك الكراسي الفارغة لا تجد طبيبًا واحدًا يجلس عليها! ومن هنا، يتجه الهذيان إلى لوكريثيا، ممرضة نابليون في الأيام الأخيرة من حياته، وثمة أسئلة من نابليون عن حصانه، وعن النسور التي كانت، كلما ركض، تجتمع فورًا في الطريق، وكما لو أنها في مهمةٍ سرية، ترافقه إلى أن يصل إلى الغابة، وفيما ترتفع حدة الهذيان، تتحول لوكريثيا (الممرضة المشتهاة) إلى (البقرة الوحشية)، غير أن لوكريثيا لا تجيب، وليست في الجوار، حتى أن نابليون نفسه يدرك هذه الحقيقة. ومع ذلك، يوجه أسئلته المحتشدة في اتجاه لوكريثيا: «لماذا أنا وحدي في هذا الليل البارد»؟ لكن الأسئلة كلها لا تجدي نفعًا، ولا تجد طريقًا إلى أذن لوكريثيا الصمّاء.
ملحمة نابليونية مرعبة، في الخفاء، في مقبرة ما، وسط العتمة، وفي مكان غير مرئيّ، حيث تخندق الغافري، ممتشقًا قلمه، ومتلصصًا على هذيان الرجل الذي «دوّخ» العالم، ويستمر نابليون في صراخه الداخلي، صرخة تتبعها صرخة، وسؤال يتبعه سؤال، وحيرة تعقبها حيرة، ولا بد في ممات كهذا، من استعادة مجد الأيام، وسرد بطولات وفتوحات عسكرية حين كان نابليون هو القائد الذي تخافه الجهات، ويهابه العدو، وحين كان نابليون، في طفولته، ذاك الفتى الوسيم الذي «يفلق» الحجر.. أما الآن، فهو لا يملك سوى بضاعة الهذيان، مستعيدًا كل ذكرى جميلة، وأخرى مؤسفة، سخرية هنا، ومعركة هناك، أغنية هنا، ودهشة هناك، الممكن، وغير الممكن، المنطقي، وغير المنطقي، في سياق نص «ملحميّ» أنجزه الغافري، الذي استدعى صمت ممرضة نابليون، شعريًا، لا لتتحدث، ولا لتجيب على سيل الأسئلة المجنونة، إنما لتواصل صممها، وغيابها، في لحظة شرّقت أسئلة نابليون وغرّبت، تهكمت وضحكت، زمجرت واستسلمت لبرد المقابر، ليستمر نص هذيان جميل، لم يخلُ من حيرة، وفي المقابل، يدفق شاعريةً، أباحت أسئلة متناثرة تصطدم بجدار داخلي في روح رجل ميت، لا سلاح له الآن إلا الهذيان إلى آخر الصمت، وثمة استدعاء متقن للنبيذ، في السياق، إذ يسأل نابليون: هل حقًا النبيذ الجورجي أفضل من النبيذ الفرنسي». قبل أن يستدرك: «ولماذا أسمع هذه الإشاعات الآن»؟ لكنه في لحظة ضعف واضحة لا غبار عليها، يرمم ما تناثر من جزئيات سؤاله المتعلق بالنبيذ، فيعود ليتدارك الموقف، محافظًا على صراخه الداخلي، ومبررًا هذه الأفضلية في نبيذ جورجيا قياسًا بنبيذ فرنسا: «هل لأنها تمطر في الخارج؟»، وهنا تبرز براعة شاعر كتب ملحمة على طريقته، متجاوزًا المألوف والمعتاد والمتكرر والمتحجر من الكتابة في مشهدية الشعر العربي الذي يكتب الآن.
ويستمر نابليون في استذكار أهم محطات حياته، من بطولات، وفتوحات، وحملاته شرقًا، وفي اتجاهات عدة، ومنها حملته على مصر، حين تم قصف «أبو الهول»، وموسكو التي دخلها هو وجنوده فلم يجدوا فيها قطعة خبز واحدة، وكذلك حصار يافا، والطاعون، والجهل بالسر الساخر في البحر المتوسط.
اتخذ نص «هذيان نابليون»، الذي اتسع له حيز القسم الأول من الكتاب، تقنية النص المفتوح، بلغة شعرية بحتة، تتبعه نصوص قصيرة تحت عنوان «لعلنا سنزداد جمالًا بعد الموت»، وكأنّ الشاعر يجمع كتابين في كتاب، وعنوانين في عنوان.
في القسم الثاني من الكتاب، الذي يحمل عنوان: «لعلنا سنزداد جمالًا بعد الموت»، يؤنسن زاهر الغافري حياة برزخية غامضة، ويخرجها من مخابئها إلى العلن، على طريقة الرعاة الذين هم بلا بوصلة، يهربونَ جرار الآلهة، ويشربون الظلَّ، مُقطّرًا من الأشجار، فمن يدري: «لعلّنا سنزدادُ جمالًا بعد الموت/ فنسمعُ من يقول: انظر/ كيف تقفز الأسماك/ من عيونهم».
يبدأ الكتاب بمقدمة لأدونيس، بعنوان «الحجر وعين الملاك»، يستهلها قائلًا: نعم، «وصَلَ الحجر إلى عين المَلاك»، ذاهبًا إلى القول إن هناك «سكوتٌ» يكاد أن يكونَ كاملًا، على الواقع الدّينيّ ــ الثّقافيّ ــ الاجتماعيّ ــ السّياسيّ في البلدان العربيّة، في الكتابة الشّعريّة عند الأجيال الشّابّة من الشّعراء. وهنا يلفت «أدونيس» الانتباه إلى ما يعدّه هو «كتابة تتِمُّ بنوعٍ من التّوكيد على انعدام التّساؤل»: لُغَةُ هذه الكتابة، بشكلٍ عامّ، واثِقَةٌ، مُطْمَئنّة، وتعرف كلَّ شيءٍ، ماضِيًا وحاضِرًا ومستَقبلًا، ويبدو أصحابُها كأنّهم جميعًا «سادَةُ العارفين». أما الشّعر في هذه الكتابة، فهو قصورٌ للمتعة، وحدائق للتّشَرُّد العابث الحالم، ودروبٌ صَوبَ الأعالي، في مسافاتٍ بلا حدود، حيث «لا خرابَ من أيّ نوع» في بلدان ليس فيها غير الخراب من كلّ نوع. ولا مشكلةَ عند الشعراء، في البلدان ذاتها، ــ لا في اللغة، ولا في الحبّ، لا على الأرض، أو في السّماء، و»كلُّهم أنبياء قليلًا أو كثيرًا»، بشكلٍ أو آخر.
ولئن كان بينهم مَن يُعنى بهذا الخراب، يتابع أدونيس، فمن المُمْكِن وصفُ عنايته بأنّها سياسيّة، أو أيديولوجيّة، أو دينية: عناية يمكن وصفُها بالصّفات كلّها إلاّ الشّعر. وتتمّ، إلى ذلك، في سياقٍ قديمٍ تقليديّ، ومكرور.
اختراق السائد
وفي صدد مقاربة النص الذي أنجزه زاهر الغافري، في مجموعته الشعرية الأحدث، ينوه أدونيس أن الغافِريّ يدخل إلى هذا العالم طارِحًا على نفسه، وعلى قارئهِ، تساؤلات لا يعرف أحدٌ أن يجيب عنها، ذلك أنّه يدخل شاعِرًا، لا أيديولوجيًّا، ولا دينيًّا، ولا سياسيًّا. ومثل هذه التساؤلات، كما يعتقد أدونيس، أساس أولُّ لكل شعرية خلّاقة: «هكذا يدخل (الغافري) مُختَرِقًا تلك الثّقافة العربيّة السّائدة، والتي لا تفتح إلاّ الطّرقَ التي (تخدع الضّوء). يدخل كمثل ما فعلَ فنّانو الحداثة في الأشياء والأفكار ــ تكعيبًا وتجريدًا، ودادائيّةً، وكمثل ما فعل الأسلاف العرب الخلاّقون، تَصَوُّفًا، وتَفَلْسُفًا، شعرًا وعِلْمًا. يدخل فيما يَرُجُّ السِّياقَ الكِتابيَّ التَّقليديّ، سياق الكلمة والجملة. يُجَزِّئ هذا السّياق، يكسره، يزرع فيه التّناقضات والمُطارَحات والتَّجاذُبات. يُذَوِّبُ الأشياء والأفكار في نسيجٍ كِتابيٍّ آخر جُرِّدَت فيه الكلمات من وظائفها وعلاقاتها المَألوفة، وأسندَتْ إليها وظائفُ أخرى وعلاقاتٌ أخرى، مُعيدًا بهذا كلِّه، تكوين الواقع وأشيائه، تأسيسًا لفَهمٍ جديدٍ للعالم ولقراءةٍ جديدة، وتَذَوُّقٍ جماليٍّ جديد للشعر وللعالم».
وينوه أدونيس بالتّحرُّر الخلاّق من جميع القيود والإكراهات أيًّا كانت، في سياق النص الذي كتبه الغافري، وهكذا، بدلًا من إبقاء الأشياء أسيرةً للتّفسير والتّصوير، والسّرد، «يُعادُ تركيبُها، كأنّها تُخلَق من جديد». ولا يعود الشاعر يكتفي بأن يضيءَ ظاهِرَ الشّيء وما حوله، وما يُحيط به، فيما يبقى الشّيءُ نفسه في ذاته محجوبًا، كما هو خارج الإضاءة، في العَتَمة!، فـ»الإبداع تكوينٌ آخر»، وليس مسألةَ تفسيرٍ وتصوير وإعادةِ إنتاج.