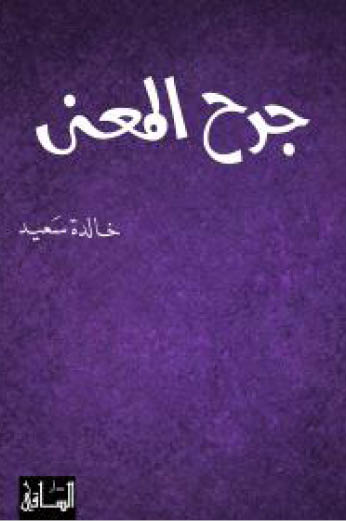الصحبي العلاني
في كتابه الشهير «الأثر المفتوح» (1962)، اعتبر الإيطالي أمبرتو إيكو (1932-2016) أنّ من أخصّ ما تتميّز به الأعمال الإبداعيّة الحديثة استحالة اختزال دلالاتها في تأويل وحيد، فهي دوماً قابلة لجديد القراءات إلى درجة أنّ كلّ متقبِّلٍ يمكن أن يستنبط منها ما يشاء من المعاني بحسب الرؤية التي يصدر عنها في نظرته إلى العالم. ولئن صارت الفكرة الجوهريّة التي تأسّس عليها الكتاب شائعة لدينا مألوفة بين نقّادنا بعد أكثر من نصف قرن على صدوره، فإنّه قد تضمّن بواكير أفكار أخرى طريفة لم تَحْظَ بالعناية اللازمة، في حدود ما أمكننا الاطلاع عليه من دراسات. ومن بين هذه الأفكار فكرة «الأثر المتحرّك» أو «الأثر في حركته»، وهي فكرة ظلّت إلى حدّ كبير من قبيل المسلّمات النظريّة أو الحالات الافتراضيّة القصوى، ولكنّ الناقدة خالدة سعيد أكسبتها بُعدها التطبيقيّ ونبّهتنا إلى عمقها المعرفيّ من خلال العمل الذي صدر لها أخيراً عن دار الساقي ببيروت تحت عنوان «جرح المعنى-قراءة في كتاب «مفرد بصيغة الجمع» لأدونيس».
أدونيس… هويّة مُلتبسة وأثر خصيب!
لم يختلف النقّاد والدارسون والمثقّفون العرب في تقييم أعمال إبداعيّة أو آراء نقديّة أو مواقف فكريّة مقدار اختلافهم في ما يكتبه أدونيس وما يقوله وما يصرّح به. فأدونيس (=الشخص/الأثر) يمثّل -من دون أدنى شكّ- موضوع جدل مستمرّ ومادّة خلاف لا ينتهي، بل إنّه يشكّل حالة سجاليّة قصوى لا نكاد نجد لها نظيراً في سياق الثقافة العربيّة الحديثة والمعاصرة. ولعلّ أغرب ما في هذه الحالة أنّ الخلاف بشأنها لا يتجلّى في مستوى تباين ردود أفعال القرّاء، فحسب، ولا ينحصر في دائرة تقبّلهم المتراوحة بين الضيق والاتّساع، فقط؛ بل إنّه خلاف متأصّلٌ تأصّلاً جذريّاً في تكوينيّة الباثّ ذاته، وفي صميم النصوص التي ما فتئ يكتبها والقول الذي لم ينقطع عن إنشائه.
ورغم ما في هذا الحكم الذي ذهبنا إليه من إطلاق وتعميم باعثيْن على الاستغراب، فإنّنا لا نرى أنفسنا في حاجة إلى تمحّل البراهين التي تقطع بصحّته. وهي براهين أكثر من أن تُحصى وأغزر من أن ننفق في استعراضها جهداً لا طائل من ورائه. ويكفينا في المقام الذي نحن فيه أن نشير إلى أربعة منها لا غير:
أوّلها (وهو الأشهَر من دون شكّ): أنّ «أدونيس»، الاسم الذي من المفترض أن يُطابق الهويّة وأن يستغرق الذاتَ وأن يحتويَ الكينونةَ ليس إلاّ «قناعاً» استعاره الشخصُ الثابتُ لدينا تاريخيّاً أنّه ولد باسم «علي أحمد سعيد إسبر» مطلع شهر يناير/كانون ثاني سنة 1930 في قرية قصّابين على أطراف مدينة جبلة السوريّة.
ثانيها: أنّ شخص علي أحمد سعيد إسبر، هذا الذي استأثر لخاصّة نفسه ولمُجمل أثره باسمٍ «جديد/قديم» مستمَدٍّ من أسطورة توزّعت بين التراث الكنعانيّ الفنيقيّ والتراث اليونانيّ قد خالف السُّبُل المسطورة وجافى الرسوم المعلومة. فهو لم يَذُبْ في التراث ولم يَغِبْ فيه رغم أنّه استمدّ هويّته «الجديدة» من التراث ذاته.
ثالثها: أنّ أدونيس/علي أحمد سعيد إسبر، أو، علي أحمد سعيد إسبر/أدونيس قد أوقعانا في ورطة المسافة بين «الوجه» و»القناع»؛ وأنّه/أنّهما أصابانا بالإرباك إلى درجة صار من المستحيل بعدها أن ندرك الفرق بين «الأصل» و»النسخة»، فقد غرس فينا بذرة الشكّ التي وجدنا بعدها أنفسنا، نحن القرّاء، عند تخوم صراعٍ ضارٍ بين «الثابت» و»المتحوّل»… صراعٍ لم تزده «صدمة الحداثة»، و»صدمة النصوص»، نصوص أدونيس، إلّا تأزّماً وضراوة.
رابعها: أنّ أدونيس (هذا الذي ذاع صيته، اسماً وشخصاً ونصّاً، والذي سار به الذِّكْرُ على الألسنة، وتداوله النقّاد، واختلف في شأنه المفكّرون، ووضعه على رأس قائمات التكفير المكفّرون، وهدّد بتصفيته والقضاء عليه الإرهابيّون) لم ينجح لمجرّد استعارته قناعاً من أقنعة الأسطورة ضارباً في القِدم؛ بل إنّ علّة نجاحه تكمن في قدرته المذهلة على خلق أسطورة أخرى جديدة من رحم القديم… أسطورة «مضادّة»… أسطورة «بديلة»… أسطورة «مفتوحة» لا نهاية للدلالة فيها… أسطورة لم يتوقّف أدونيس فيها عن الكتابة وعن «إعادة الكتابة» أو بالأحرى -وهو الأدقّ- عن «مواصلة الكتابة» تأكيداً منه لهويّته الملتبسة، هويّته الخصيبة المخصبة. وذلك ما أدركت كُنهه الناقدة خالدة سعيد عندما ركّزت في كتابها «جرح المعنى» على مجموعة أدونيس الشعريّة «مفرد بصيغة الجمع».
«على قلق كأنّ الريح نَصِّي…»
والحقيقة أنّ اختيار خالدة سعيد مجموعة أدونيس الشعريّة «مفرد بصيغة الجمع» دوناً عن سائر مجاميعه الأكثر شهرة ليس محض هوًى أو مجرّد صدفة، بل إنّه اختيار مقصودٌ حرّكته دواعٍ موضوعيّةٌ من أهمّها أنّ هذا النصّ لم ينفكّ عن التحوّل، فقد «نشره أدونيس […] للمرّة الأولى في طبعة فنيّة (مع رسوم للفنّانة منى السّعودي) عام 1973، ثمّ نشره عام 1975 في طبعة تمّ استكمالها من دون تغيّر كبير في بنية النصّ» (ص.7-8)، وتواصل نشره تباعاً في طبعات حملت إحداها إشارة «صياغة نهائيّة» (طبعة دار الآداب ببيروت سنة 1988).
وعلى رغم ما طرأ على النصّ من تطوّرات، تعترف خالد سعيد ذاتُها بأنّها «ليست بلا دلالة» (ص. 8)، فإنّها قد خيّرت أن «تقتصر على قراءة نسخة 1975 بطبعتها الأخيرة (1988) التي لم يُعَدْ طبعها إلا عام 2014، وهاتان الطبعتان هما الأكمل حتّى الآن (حسب رأيها)» (ص.8). وهي تعترف في خضمّ ذلك كلّه بأنّ «مفرد بصيغة الجمع» هو «من نصوص أدونيس المتعدّدة الأبعاد، المتواشجة، المبنيّة على التراسل والتّصادي، القابلة للنموّ قراءة أو كتابةً» (ص.8).
والذي يعنينا ممّا تقدّم كلّه -على رغم ما يوقعه فينا من إرباكٍ وظنون- أمران على غاية من الدقّة واللّطافة:
أوّلهما: أنّ خالدة سعيد تُقدّم في أولى صفحات كتابها «جرح المعنى» إشكاليّةَ القراءة على إشكاليّةِ الكتابة. وكأنّها بذلك تريد أن تُهوّن على القارئ ظاهرة غير مألوفة انفرد بها أدونيس دوناً عن سائر الشعراء العرب، ونعني بذلك ظاهرة تعمّده تركَ نصوصه مفتوحة على الصياغة وإعادة الصياغة إلى ما لا نهاية. وهي ظاهرةٌ لم ينقطع النقّاد عن تقصّي تجلّياتها وأسبابها وعن محاولة إدراك الغرض منها. ومدارها سؤالٌ محيّرٌ: لماذا يُصرُّ أدونيس على تحوير نصوصه الشعريّة في كلّ حين؟ ولِمَ يحتفظ بحقّ تعديلها، كأن ليس لقارئه الحقّ -هو أيضاً- في «محاسبته عليها» لحظةَ وصولها إليه وتقّبله لها؟ لِمَ هذا الهروب المستمرّ إلى الأمام؟!
ثانيهما، وهو في وجه من وجوهه مناقض للأوّل تمام المناقضة، في الظاهر على الأقلّ، أنّ خالدة سعيد تعترف -رغماً عنها- بأنّ النصّ، نصّ أدونيس الذي لا ينفكّ عن تأكيد تجدّده/حياته عبر الكتابة المتكرّرة التي لا تنتهي، أو تكاد، ليس إلا صورةً من أدونيس/الأسطورة التي يكون فيها الكون/القول استئنافاً على كون/قول قديم لا فرق فيه بين «ماضٍ» و»آتٍ»، بل إنّ الأمر لا يعدو أن يكون سوى عودة مُستأنفة ومقالٍ جديد/قديم، قديم/جديد تماماً مثلما هو الشأن مع الأسطورة التي تتكرّر لكي تؤكّد من خلال تكرّرها معنى الخلود.
وهنا مكمن «الجرح» الذي لا ينفكّ عن النزيف، نزيف القول ونزيف الدلالة، ضمن دورة خطاب كأنّ أدونيس استعار فيها أحد أبيات المتنبّي الشهيرة بعدما حرّفه وأخرجه مخرجاً آخر جديداً يقول لنا فيه: «على قلق كأنّ الريح نصّي/ أقلّبه يميناً أو شمالا»! وظلّت فيه الناقدة خالدة سعيد، هي الأخرى، على قلق من النصّ ذاته رغم أنّها أنفقت فيه سنوات طوالاً من القراءة والمكابدة.
من «التاريخ»… نحو مطلق الدلالة
من التاريخ تنطلق خالدة سعيدة، وعلى علاماته الأكثر ثباتاً (أو هكذا نظنّ؟!) تُعوِّلُ. فهي تستهلّ كتابها بالإشارة إلى الطبعات المختلفة التي ظهرت فيها مجموعة «مفرد بصيغة الجمع» (من سنة 1973 إلى سنة 2014)، وتتوقّف بشكل خاصّ عند أهمّ القصائد التي سبق لأدونيس أن نشرها قبل ذلك، وهي أساساً: «هذا هو اسمي»، و»مقدّمة لتاريخ ملوك الطوائف» و»قبر من أجل نيويورك» (من سنة 1969 إلى سنة 1971). والأهمّ من هذا وذاك أنّها تورد في القسم الأخير من كتابها، تحت عنوان: «ملاحق» نصَّيْن من نصوصها النقديّة قديمَيْن سبق لها أن نَشرت أحدهما سنة 1961 على غلاف مجموعة «أغاني مهيار الدمشقي» في طبعته الأولى (و»لم يُعَدْ نَشْرُهُ بعد ذلك»، مثلما تقول في الصفحة 191 من العمل)؛ وسلف للثاني أن ظهر سنة 1965 على غلاف مجموعة «كتاب التحوّلات والهجرة في أقاليم اللّيل والنهار» (و»لم يظهر بعد ذلك» مرّة أخرى مثلما تشير في الصفحة 195 من الكتاب).
والذي لا شكّ فيه ولا اختلاف حوله أنّ هذه الإشارات التاريخيّة المتعدّدة، سواء منها ما تعلّق بمسارات تشكّل نصوص أدونيس الشعريّة وتناسلها، أو بانبثاق قراءات خالدة سعيدة النقديّة وأصولها الأولى تكتسي أهميّة بالغة وقيمة لا نظير لها. فهي تساعدنا على إدراك التحوّلات التي ما فتئت تطرأ على النّص في قُطْبَي الإنشاء والتقبّل وتؤكّد لدينا أنّه -على عكس ما نظنّ وما نعتقد- ليس مُعطًى جاهزاً ثابتا نهائيّاً بل هو انفتاح دائمٌ على جرحٍ ليس إلا جرحَ المعنى الذي لا ينفكّ عن نَزْفِ دمائه، دماء الدلالة.
ولهذا السبب بالذات، فإنّ خالدة سعيد سرعان ما طلّقت الرؤية التاريخيّة التي أوهمتنا في أولى صفحات كتابها بأنّها تنطلق منها وتعتمدها، وذلك حين أشارت إلى أنّ القرابة بين نصّ أدونيس «مفرد بصيغة الجمع» ونصوصه الأخرى السابقة («هذا هو اسمي»، و»مقدّمة لتاريخ ملوك الطوائف» و»قبر من أجل نيويورك») لا تقوم -كسائر القرابات المألوفة- على التواصل، ولا تتأسّس على الامتداد؛ لأنّ «الحاضر» فيها (أو ما نظنّه كذلك) لا يُكرّر الغائب، واللاحق (أو ما يُهيّأ لنا أنّه ذاك) لا يعيد المنقضي! بل إنّنا -مثلما تقول خالدة سعيد- إزاء قرابة من شكل آخر هي «قرابة المقابلة والتضادّ من جهة، والقرابة على مستوى جموح الصور والاختراقات الدلاليّة والحريّات الأسلوبيّة وحضورٍ للتناصّ يتميّز بالعنف، من جهة ثانية» (ص. 9).
وإذا كان هذا هو شأن نصوص أدونيس في أصل تكوينها: إعلاناً عن القطيعة، وانفصالاً صارخاً عن الرّحم، وقطعاً دمويّاً للمشيمة من أجل إثبات الذات ملءَ وجودها، فإنّ أيّة قراءة «موضوعيّة» لهذه النّصوص لا يمكن إلا أن تكون من جنسها، أي قراءة تُعلن عن «الذات»، «ذات القارئ/الناقد» متماهيةً مع النصّ، متفاعلةً معه، منفعلةً به؛ وأيضاً منفصلةً عنه ومتحرّرةً من سحره ومن كينونته الآسرة.
وذلك ما نجحت خالدة سعيد في إدراكه والتنبيه إليه، حين تساءلت في أوّل فصل من فصول كتابها: «هل الولادة بداية الرحلة أم نهايةٌ تَعِدُ بالبداية؟»، واختتمته بجوابٍ عن السؤال مفاده: «دائماً على شفى الجنون»؛ معترفةً بأنّ نصّاً مثل «مفرد بصيغة الجمع» -حتّى وإن قضّى المرء في تقليب دلالاته وفي تشقيقها نصف قرن أو يزيد، مثلما هي الحال، حالها- فإنّه يظلّ من النصوص المُلغِزَة التي تتأسّس فيها الهويّة على الهاوية، ويتحرّر المجاز من ضيق المعنى ويُحمَل الكون على سبيل الاستعارة التي لا حدود لها… وصولاً إلى مطلق الدلالة… إلى دلالة المطلق.
كتاب خالدة سعيد «جرح المعنى-قراءة في كتاب «مفرد بصيغة الجمع» لأدونيس»، كتابٌ محيّر تزعم صاحبته عبر صفحاته المائتَيْن أنّها تأخذك إلى طمأنينة الجواب، ولكنّها تُلقي بك -من فصل إلى آخر بل من صفحة إلى أخرى- في صميم السؤال: سؤال الأثر المفتوح»، «الأثر المتحرّك»، والنصّ الذي لا يستقرّ له قرار.