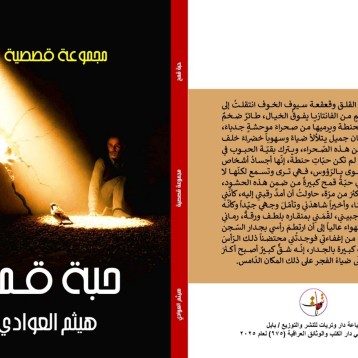د. نفلة حسن أحمد العزي
إن لغة النص هي المرتكز الحقيقي الذي تقوم عليه آصرة التواصل بين طرفيه – أي بين المرسل والمرسل إليه-، فكيفما يصوغ المنتج عمله تتكون ردة الفعل له أو عليه، وحينئذٍ يتشكل نوع من الحميمية أو النفرة التي تجعل طبيعة العلاقة تأخذ منحاها سلباً أو إيجاباً ، ولما كان بدء الأمر منصباً على الطرف الأول وهو المنتج أو باعث النص، أخذت النظريات النقدية القديمة تهتم بسياقات ذلك وتشيد به عبر تطبيقاتها الأدبية العامة فيما مضى، ثم جاءت النظريات الحديثة لتكسر هذا الطوق وتعيد بناء اللغة النصية على يد القارئ الناقد بثقافته ومرجعيته الفكرية التي تعدّت سلّم التحاور السطحي مع النص إلى درجة الاندماج الكاشف لبنيته العميقة فيما تحتويه من حزمات علاماتية قصية عن إظهار المعنى القريب.
وقد استوعب أصحاب الجيل الجديد من المؤلفين ما للقارئ من أهمية في تميز نصوصهم وفرادة أدبهم المنتج، فأذعنوا لواقع ما طرحه النقد الحداثي من ضرورة انتقاء اللغة وانتخابها في صوغ العمل وتشكيله، ولاسيما في النصوص السردية التي تستدعي من منشئها لغة فياضة أسلوباً ومعنىً .
إن إنتاجية النص لم تعد مقتصرة على مؤلفه فحسب، ولم يعد المتلقي خارجاً عن نطاق تلك الإنتاجية الفنية، بل هو مشارك فيها وعامل على تكوينها، ورسْم صورتها من جديد، وبذلك فإن دوره يعد إبداعياً هو الآخر، وأثره منعكس على ما تشهده الساحة الأدبية من نصوص مواكبة للغة العصر الذي هي فيه. ولم يكن مقالنا هذا من باب المناظرة بين النصوص القديمة والحديثة من حيث خصائص كل منهما اللغوية والفنية بقدر ما كان القصد من ذلك البرهان على دور المتلقي وأهميته في رواج بعض النصوص واتساعها في مقابل تحجيم غيرها. إننا نعي أن هاجس التطبيقات النقدية هو لباب مناقشات الفكر المعاصر، ولعل أبرز المحاور التي تجمل لنا القول فيما نريد، هي: شعرية العنوان، المتاهة والغموض، اختراق المحظور، لغة الغرابة والعجب، التهجين الفني.
عند الوقوف ملياً عند هذه المحاور ومطالعتنا لها عن كثب فيما تقدم به الكتّاب من نصوص، يتوضح لنا انه لا يبرأ الخطاب الأدبي في كثير من تراكيبه الفنية والسياقية من تحولات الذات المؤثرة والمتأثرة في تشكيل بنائه الابداعي، وذلك هو ما يَمْثُلُ شاخصاً أمامنا مع مجيء نظرية التلقي الحديثة، إذ أصبح دور المستقبِل في تحديد نمطية ذلك الخطاب يأخذ مداه الواسع فيما أثارته من أطروحات تعضد أهمية هذا الدور وتكرس قيمته في تنمية لغة الحداثة الأدبية.
ولنا أن نشير عند هذه النقطة إلى أن مفهوم الحداثة هو غير مفهوم المعاصرة، فالمعاصرة تعني أن النص كتب في العصر الذي نعيشه، فهو معاصر لنا، أما الحداثة فليست قريناً للجدة أو المعاصرة، ولذلك فهي ليست تاريخية فقط، فإذا كان الجديد أو المعاصر يشير إلى الزمن، فإن الحداثة تشير إلى حساسية ما، والى أسلوب ما معاً، يأنف الثابت ويسلّم بضرورة الاستجابة لدينامية الواقع ومتطلباته.
وما يجمل لنا القول الفصل في ذلك أن المعاصرة تنساق للذوق الزمني السائد عند هذا الجيل أو ذاك، وقد تحتوي الحداثة أو لا تحتويها، سواء ما تعلق منها بشكل النص أو بمضمونه، بينما الحداثة تعني الوعي الجديد بمتغيرات الحياة والمستجدات الحضارية والانسلاخ من أغلال الماضي والانعتاق من هيمنة الأسلاف، وهي ليست ظاهرة مقصورة على فئة أو جنس بعينه، بل هي استجابة حضارية للقفز على الثوابت، وتأكيد مبدأ استقلالية العقل الإنساني تجاه التجارب الفنية السابقة. وعلى الكاتب أن يضع في حسبانه أنه حينما يكتب نصاً ما، إنما يكتبه ليُقرأ، وما يختاره ينبئ عن طريقة وعيه وتفكيره بكل ما تقدم، وهو يكتب ليعبر عن مشاعره وتوجهاته الفردية التي هي جزء من تجارب المتلقين ومشاعرهم وتوجهاتهم؛ ولذلك ترى أحياناً كمّاً معيناً من القراء ينجذبون نحو (س) من الكتّاب، فينكبون على دراسة مؤلفاتهم بالثناء والإشادة، متناسين أن العملية النقدية إطارها العام هو الحكم بالجودة أو الرداءة على النص، أما بيان الجوانب الإيجابية فيه على حساب نظيرها السلبي فلا نعتقد أنه من كمال النقد.
والمقولة التي تشكلها نظرية التلقي اليوم تنادي بأن القارئ الحصيف هو قرين المؤول، ومن الممكن أن يستخرج من النص دلالات قد لا يقصدها المؤلف ، وذلك بالنظر الى أن التأويل هو من جماليات التلقي في الدراسات الأدبية والنقدية، وإن كان ثمة ما يغلف هذا التصور من إشكاليات تؤكد على أنه لا ينبغي تحميل لغة النص فوق ما تحتمل ، بحيث أن العين القارئة تبدو متكلفة في بيان رؤيتها الفكرية؛ كما لا ينبغي أن تكون القراءة خالية الوفاض من الامتلاء الثقافي والخبرة وخلفيات العلم الأكاديمي النقدي؛ لذا فقد أكدت النظريات الحديثة على أمرين هما: 1- نبذ الدور التقليدي للقارئ وإعطاء القارئ المعاصر دوراً فاعلاً، حاسماً في تحديد المعنى. 2- كون النص – في تصورها – لا يحمل معنى جاهزاً، فالقارئ هو من يملأ ثغرات النص وبياضاته، ويشارك – على أقل تقدير- في الكشف عن المعنى.
ولما كان وجود النص من أجل القارئ – كما أسلفنا- فقد غدت لغة النص هي أداة التحكم في كيفية جذبه إليها من خلال ما تتوسم به مفرداتها وتراكيبها الفنية من غموض أو إيهام أو جماليات تعبيرية موحية ومثيرة للفكر والعاطفة معاً، في حين أن كل مختص في هذا المجال يعلم أن الأسلوب المباشر والوضوح مع بساطة العبارة كانت هي الظاهرة السائدة في لغة ما سبق من نصوص أدبية رائدة.
ولو أدركنا الأمر ملياً وتمعنا الوقفة المستفهمة عمّن يؤثر في مَن ؟ أي هل المؤلف هو الذي يؤثر في المتلقي من خلال اللغة الحاملة للمعنى أو العكس؟ للاحظنا أنه لو كان المؤلف هو صاحب التأثير إذن لِمَ جاءت النصوص الحديثة معاصرة لذائقة القراء ومواكبة للنداءات التي تشجب النظرة السلبية للقارئ المستهلك؟! ولِمَ نجد بعض المؤلفين أنفسهم ينقلون لغتهم من طور إلى آخر إرضاءً لدوافع التجريب ومراعاةَ لحداثة العصر؟! ولِمَ ساد الانطباع بـأن المتلقي لا يعني بالكيفية التي يكوّن بها معنىً يندمج في إعادة بناء العمل الأدبي، بل العمل هو الذي يعدل من وضعياته في الشكل والأسلوب؟. في رأينا يكفي ذلك أن يكون دليلاً على دور المتلقي وأثره في تنمية اللغة الفنية المتعاقبة عبر أزمان قد تفاوتت فيها نوعية النـص المنتج.
دينامية العلاقة بين ثالوث العملية الإبداعية

التعليقات مغلقة