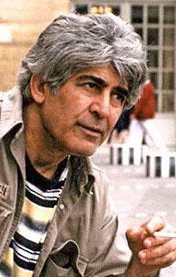د. نادية هناوي
التذوق الأدبي نوع من انتفاض المتذوق، أمّا طربا بتنسيق لفظي أو إعجابًا بانتظام دلالي أو تماشيًا مع انسجام إيقاعي. ومرتع التذوق الذهن ومادته الإحساس. وتوجه الذهن للإحساس هو استثارة لكوامن التذوق التي هي ليست محددة في لائحة ولا متموضعة في قانون، وإنما هي تتقولب من خلال إرادة جماعية، باستثناء حالات تجعل التذوق ينفلت عن المجموع، وكما يقال (لو تساوت الأذواق لبارت السلع)، وما انصهار تجربة ما في القصيدة؛ إلا تعبير عن إحساس خامر المبدع الشاعر أولا، فأنتجه شعرًا ثانيًا، ليتم تلقيه ثالثًا.
والإيحائية في الشعر هي عماد التذوق، ولا وجود لشعر جيد لا يرافقه تذوق، به تتوكد فاعلية القصيدة الإبداعية في توصيل مراميها الأدبية، التي فيها تتحقق أصالة الوعي الإنساني.
وصحيح أنَّ قناتي التوصيل والاستقبال( السمع والنظر) هما الحاستان الفيزيقيتان اللتان عبرهما يُستثار التذوق، بيد أنَّ دورهما مهم في انجاح القصيدة، ولأن النبر والتنغيم والإدغام للصوائت والصوامت هي محفزات سماعية سريعة وآنية، لذا يغدو التحفيز على التذوق متحققًا بشكل أسرع في القصائد الصوتية منها في القصائد الدلالية. من هنا تظهر أهمية إعادة النظر في معايير التذوق الأدبي للشعر وإدراكها بلا لبس أو إيهام. وصحيح أنّ الإلقاء وسيلة بها يبلغ الشعر غايته وهي التوصيل، لكنه ليس معيارًا وحيدًا به يقيّم الشعر، ليكون موجهًا التذوق نحو القبول أو عدمه. ولئن كان الشعرُ هو الفن الذي أداته الكلمة وغايته الجمال؛ فإنَّ عماد تذوقه ينبغي أن يكون نابعًا من حس مرهف صافٍ ونقي، لا يكتفي بمقاييس السلف؛ بل يواكب المستجد في الشعرية العالمية.
وهذا هو الذي سيسمح للشعرية العربية بالتطور، مخرجا إياها من عقدة التبجيل لما هو تقليدي ماضٍ. وهذا ما فعله رواد الحداثة الشعرية، متقدمين بالشعر نحو الأمام. ومعهم تقدم التذوق الشعري. وعلى الرغم من أنَّ الشعر العربي اليوم يشهد انعطافة ما بعد حداثوية، لكن على مستوى الإبداع فقط. أمّا على مستوى التذوق فلم يتجل ذلك بعد، إذ ما زال تذوقنا للشعر يتخذ من الرواد وما بعد الرواد نماذج يقيس عليها، واقفًا عند معايير حداثوية، مع أنّ الحداثة غدتْ ماضيًا ينبغي مغادرته إلى ما بعد الحداثة.
وما ينبغي أن نقتنع به هو ضرورة أنْ تظلَّ عجلة الشعرية دائرةً لا تعرف الثبات عند زاوية ما، فالثبات في الشعر لا يعني إلا التحجر والركود. ولو أردنا تحديد معايير التذوق الشعري، لوجدنا أنها تتوزع بين شكلين: الشكل الأول فيه المعايير عتيدة وشائخة، وأهم مواصفاتها الصلابة والخشونة والفحولية مع التمجيد للماضي وعدم الاكتراث للحاضر ولا للمستقبل، كما تتسم في الأعم الأغلب بالشمولية والتمركز والنخبوية. وأمّا الشكل الثاني فإن المعايير فيه جديدة فتية تتصف بأنها ناعمة ولينة. وهذا ما يجعل التذوق متطورًا يماشي نزعات الانفتاح، دامجًا الرسمي بالشعبي، ومداخلًا المراكز بالأطراف.
ويبدو أن الشكل الأول للمعايير هو السائد في ذائقتنا العربية، والسبب أنّ جذور الشعر عندنا راسخة تاريخيًا في العمق، وحتى الذي يتفرع على السطح منها هو الآخر متجذر ومتأصل في صورة مركزية مهيمنة وذكورية. وهذا ما جعل قسمًا من نقادنا المعاصرين يعتمد في تقييم التذوق على معيار المحاكاة للسلف الشعري وتجاربه ممثلا بقصيدة العمود السامقة، متعاملًا بتعالٍ مع القصائد الحداثوية كقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر وقصيدة الومضة والهايكو وغيرها من الأشكال الشعرية الجديدة.
ولا غرو أنّ مركزية الشعر التي تتعالى على كل ما هو جديد لن تُحقق له الدوامية، ومن هنا يصبح الالتفات إلى معايير جديدة في التذوق أمرًا مهمًا وضروريًا من منطلق أنّ الشعر لم يعد مركزًا أمام مدَّ السرد بأنواعه المختلفة، ولعل هذا الموجه في التذوق هو الذي جعل المتمسكين بالمركزية الشعرية يظنون أنَّ الشعر تراجع، ومعه تراجع التذوق، معتقدين أنَّ الشعر في أزمة وأنّ ما يقدم منه اليوم هو تهريج.
وقد يقود القول بوجود أزمة في التذوق الشعري إلى الاعتقاد بتحجر الشعر في قوالب قديمة، لكن ليس هذا فقط وانما أيضا اعتداد الشاعر بنفسه وعدم رغبته في التجديد، والذي نراه صحيًا للشعر أنه كلما تخلى الشاعر عن النظر إلى نفسه سيد التجربة، استطاع التخلص من العبودية للقصيدة فلا يرضخ لراسخ تقليدي بل يستجيب للمتغير الابداعي، وقد لمسنا في شعرنا المعاصر أذواقًا أدبية استجابتْ لقصيدة الرؤيا عند سعدي يوسف وادونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج وتفاعلت مع شعر أحمد مطر في لافتاته أو تعجبت بتدويرات حسب الشيخ جعفر ونثريات فاضل العزاوي وسركون بولص وتنافذ الأشكال عند كاظم الحجاج واسطوريات زاهر الجيزاني وخزعل الماجدي وهوس حسين مردان العاطفي ويوميات كاظم نعمة التميمي وتعتيمات علي جعفر العلاق وبساطة حسين عبد اللطيف التي جعلت الناقد عبد الجبار عباس يقف أمامه متعجبًا كيف ظل بعيدًا عن التأثر بأعلام الموجة الشعرية الجديدة.
وإذا تساءلنا هل يمكن للذوق الأدبي أن يستجيب لشعرٍ هو في نظر الحاضنة الرسمية جديد وغير راسخ؟ فالجواب سيكون موجبا إذا سلمنا أنّ التذوق الشعري ينبغي أنْ يكون منفتحًا وغير متعجل، وبهذا سنراه ينفر عن القصيدة المترفعة والعتيدة وينجذب نحو القصيدة ذات الرقة والنعومة والايقاعات الهادئة، وهذا بالطبع ما يتماشى مع ثقافة العصر السائلة ونزعته الناعمة في المساواة بين الهامش والمركز.
والتذوق الأدبي في مرحلتنا ما بعد الحداثية لا ينظر للشعر بوصفه أجيالًا وفئات، أو أوزانًا ولا أوزان، وإنما بوصفه قوة خفية تحطم السكون. وهذا ما فعله بوشكين الذي نقل الشعر الغنائي إلى الرواية الشعرية، وعدَّ النثر بناءً طليقًا من الناحية الإيقاعية والصوتية بالنسبة للكلام الأدبي.
ولا يتشكل التذوق من دون وعي يجمع أفق الشعر بأفق الفلسفة، فالتنظير للشعر هو الطريق الموصل إلى فهم التذوق، بعبارة أخرى أن التذوق للشعر هو جزء من التذوق للجمال بعامة، ولا يتأتى التذوق الشعري من مكون مرجعي واحد؛ بل هي مجموعة مكونات مرجعية توصف بأنها شائكة بين ما هو شعبي ورفيع وايديولوجي وميثولوجي..الخ.
ووجود الذائقة الجمالية دليل على تعافي الثقافة نفسها، ولا يخفى ما للثقافة النقدية من أثر في تربية التذوق الشعري وتخليقه على أسس صحيحة. وهذه مسؤولية ينبغي أن يضطلع الوعي النقدي بها، وبذلك يؤدي النقاد أدوارهم بوصفهم النخبة أو الصفوة التي تمارس التوعية على مسائل الثقافة والهوية. ولقد مارس نقاد كثيرون هذا الدور، رافعين من شأن القصيدة المعاصرة، موجهين التذوق الأدبي للشعر توجيها حداثيًا، آخذين به نحو آفاق جديدة، فيها من التجريب ما يبتعد عن إغراءات العمود واستقطابات الظروف المرحلية الاجتماعية والعقائدية والمناطقية، بعكس بعض النقاد الذين ظلوا قابعين في منطقة الذائقة الشائخة، منتقدين الجديد الشعري، واضعين العصا في عجلة تطور القصيدة المعاصرة، التي صارت تثير فزعهم وتقلقهم. وإجمالا، فإن استقطاب المشهد النقدي للرؤى والتصورات الكلاسيكية والدوران حولها والانغلاق عليها سبب من أسباب جعل التذوق الشعري متحجرًا وراكدًا. ولو تخلى المشهد النقدي عن دغماطيته، وناصر التطوير المعياري والجمالي للشعر عمودا وتفعيلة ونثرًا وتفاعلية رقمية، لارتقى بالتذوق الأدبي للشعر إلى رحاب تردم الأزمة بين تذوق أدبي شائخ وآخر فتي.