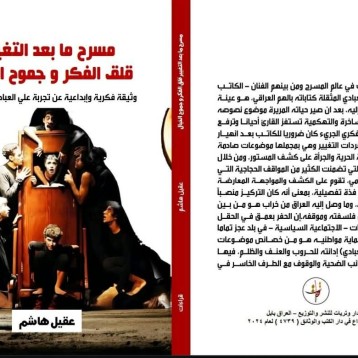ثقافية الصباح الجديد هذا اليوم مخصصة للحديث عن تجربة الراحل الاستاذ إسماعيل زاير في التشكيل
عدنان حسين أحمد
يشكل المعرض الأخير الذي أقامه الفنان التشكيلي إسماعيل زاير في العاصمة الهولندية أمستردام إنعطافة مهمة في تجربته الفنية على صعيد الشكل والمضمون من جهة، وعلى صعيد التقنيات من جهة أخرى. ويمكننا الجزم باطمئنان كبير بأن إسماعيل زاير قد غادر منطقة التوتر والإنشداد والعتمة إلى حيز الاسترخاء والمرونة والاستنارة الروحية. إذ كانت ثيماته السابقة تنطوي على انفعالات واضحة تكشف عمّا يعتمل في أعماقه من قلق مستمر، وهواجس مربكة، وسعي محموم في البحث عن شيء ضائع. وعلى الرغم من أن الفنان إسماعيل زاير قد قطع شوطاً مهماً في الإفصاح عن رؤيته الفنية عن طريق منجزه الفني إلاّ أن تنظيراته النقدية وقدرته في الانفتاح على الثقافة الأوربية وهضمها وتمثلها جيداً هي التي ساعدته كثيراً في تجنب العوائق والمصدات التي تعترض طريق الكثير من الفنانين الذين لا يتوفرون على رؤية نقدية تستطيع أن تفض اللوحة، وتدرك بعمق العلاقات الداخلية التي تقوم عليها البنية التحتية المعقدة للعمل الفني. إن المتتبع لتجربة إسماعيل زاير سيكتشف أنه أمام لوحة مغايرة فيها الكثير من علامات التناغم والانسجام والهدوء اللوني الذي يوفر للمتلقي متعة بصرية خالصة ناجمة في حقيقة الأمر عن شفافية خالقها الذي يبدو أنه قد قاطع الخطوط الفظة الخشنة، وتخلى عن عنف الفرشاة، وفجاجة اللون الصريح الذي يحيل الفوضى والارتباك أكثر مما يفضي إلى الهدوء والسكينة والتوازن. ولتسليط الضوء على المتغيرات الجديدة التي طرأت على مشروعه التشكيلي التقيناه في محترفه الفني في لاهاي وكان لنا معه هذا الحوار:
• بدأت ثنائية الكتلة والفراغ تأخذ بُعداً جديداً في لوحتك. فللفراغ وظيفة لا تقل أهمية عن وظيفة الكتلة أو ال ( Composition ). هل لك أن تتحدث لنا عن العلاقات والأبنية الداخلية التي توازن ما بين الكتل أو التكوينات السابحة في الفضاءات أو الفراغات التي تشكّل خلفية مدروسة من الناحية البصرية؟
- ثمة ترابط عضوي ودائم بين الفراغ، أو لنقل الفضاء، والكتلة. وببساطة يمكن القول إن أحدهما يتوقف عندما يبدأ الآخر. إذن ليس هناك مندوحة من إقامة علاقات بينهما وإدامتها والحرص على أن تكون علاقة متوازنة. أكثر أو اقل من ذلك سيكون ضاراً بهيكل العمل وتفريطاً بالرفقة السرمدية بين هذين المتضادين. الفنان أو المنشئ هو السيد في تنظيم تلك العلاقة وفي تعميقها أو تغييرها لمصلحة الرؤية الفنية لموضوع اللوحة المباشر. على مستوى حسي تتحكم الدربة والخبرة والمزاج الشخصي بنكهة التوازن هذه وتعطيها شحنتها المؤثرة على روح العمل. والكتلة التي تنوجد على حساب الفضاء تتحول مع كل تمدد إلى قوة مشاكسة وتحدٍ وتشعب حتى المراحل النهائية للعمل حيث يفرض استقرار شخصية اللوحة تنازلات وتضحيات بجزء من الكتلة لصالح الفضاء والفراغ. بالنسبة لي تبقى معاملة الفراغ هي الأصعب. ففي سياق هذه المعاملة يدخل الفنان إلى امتحان مقدرته على الاختزال والجرأة في القبول بتحديات إعادة التوازن على حساب الكتلة. في أحيان كثيرة أجد نفسي مضطراً لوقف الحوار الداخلي للوحة بحثاً عن مخرج لطغيان أحدهما على الآخر. مما يعني البدء مجدداً بمراجعة كل المفردات. وكما الأمر في عملية جراحية معقدة يشعر الفنان أحياناً بالغبطة لأن عمليات القص واللصق والمسح تجري بعيداً عن عيون المشاهد. في هذا الخضم قد يتطلب الأمر التضحية بكتل منجزة عن جسد اللوحة. وتفعل الطريقة التي أنظم بها علاقتي مع العمل الفني فضيلة المراجعة المتأنية لاحقاً لما أنجز من علاقات حيث انظر إلى اللوحة مثلما ينظر شاعر إلى نصه المفاجئ لاحقاً. ومع أنني سريع التعاطي مع العالم إلى درجة تجلب شكوى أصدقائي إلا أنني أخشى في العمل الفني الارتجال ويربكني تأمل شيء لا أستطيع وضعه في إطار مقنع حسياً وجمالياً. لهذا فأنني مستفيداً من خبرات مبدعين آخرين وطدت نفسي على ألا أمارس الرسم إلا وأنا صاحٍ تماماً ولست تحت تأثير أي شيء.البنية الداخلية مرتهنة للحالة المتصلة بالعمل وتتكرس في تقديري كصيغة يمكن رصدها عبر سلسلة من الأعمال المنجزة في وقت واحد، وحالما يفرض الزمن توقفات في الإنجاز تنبثق بنى جديدة تنسجم مع الحالة الجديدة أو تعكسها بالأحرى بصيغة بصرية. ولكن شخصية الفنان وثقافته ونسيجه النفسي ينتج على الدوام بنى من عائلة واحدة يمكن للعين الخبيرة أن تربط بينها لتشكل صورة أوسع للتجربة التقنية والحسية.
• تُعلن لوحات معرضك الجديد عن قطيعتها النهائية مع المناخات السوداوية التي كانت تهيمن على روحك وأعماقك في آنٍ معاً. ما هي المعطيات الفنية التي كانت وراء تخلّصك من الثيمات الكابوسية،والأجواء الرمادية التي كانت تغلّف قلقك وأرقك الدائمين؟
- لكل مرحلة في حياة الإنسان مزايا محددة تفرضها الظروف العيانية وطبيعة التجربة الشخصية والخبرة في مواجهة المحيط والتفاعل معه. في الماضي كانت حياة جيلنا السبعيني النشأة محتدمة للغاية واتسمت بطابع ساخن من الأحداث وعلاقة إشكالية مع المحيط والعالم، بل ومع الذات أيضاً. هذا عكس نفسه على المناخات التي تنفستها أعمال الكثير من أقراني بما في ذلك عملي الشخصي. وحيث أننا لم نكن نمتلك الوقت أو الأدوات اللازمة لتفكيك التوتر، بل كنا بالأحرى جزءاً منه وسبباً فيه، لذا نجد أن تلك المناخات التراجيدية ارتحلت معنا إلى اللوحة والى النص والى السلوك . هذا التوتر الوجودي وقع على ارض اكثر التهاباً واحتداماً من دواخلنا، وافرز سياقات إنفصامية في السلوك وفي الشكوى والبوح. ولكن مع مرور الشيخ الجليل « زمن « برأت الجراح واكتملت عدة الصبر المديد بعد عقود من المنفى والغربة والتوحد والتأقلم مع محيط مختلف ومتغير ومتحول وطقوس مماثلة في تنوعها. إذن عندما يرسم المرء في ظل هذه الظروف فإنه يضع حكمة المكان ومفرداتها الحسية على القماش. كنا نرسم نؤشر على استمرارنا في فعل مقاومة وعناد يومي يسجل بقاءنا أحياءً من خلال جرح الروح وأغانيها، أما الآن فقد هدأ الصخب ولم تعد اللوحة أو العمل الإبداعي كما كانت بل تحولت إلى شكلٍ من أشكال تمجيد اليقظة الوجودية وإمساك ذاكرة الإخاء الإنساني والسعي إلى التماهي مع اللحظة الراهنة. وبكلمات فإن لغة التعبير الفني ما كانت تتجسد عبر مفردات من صنع الألم والمعاناة حسب بل بالأحرى تجاوزه والعبور إلى المستقبل. عملياً وحياتياً تراجعت غيوم الألم السود والمفازات التي تعمق اغتراب الكائن البشري وبدأت ألوان اكثر ألفة بالتسلل عبر نافذة الحياة على ضيقها. وهكذا انسلخت لوحتي بالتدريج من دائرة الأزرق والأسود والبني وعائلة الألوان الكامدة.
• لم تغادر الملامح التشخيصية بعض لوحاتك على رغم انغماسك في المنحى التعبيري التجريدي الذي يعوّل كثيراً على العلاقات اللونية ضمن حاضنة الشكل المجرد بعيداً عن المضامين التشخيصية التي تتجسد فيها أشكال وموجودات العالم المادي؟
- للتشخيص قوة وجاذبية كبيرة في الذاكرة البشرية سواء على المستوى الأدبي والشعري أو الرسم. ودليل ذلك ما نراه من عودة إليه تشبه موجة حنين من قبل الكثير من الفنانين في الغرب بعد سنوات من التجربة التشكيلية التجريدية الناجحة. هذا الأمر ملموس في اكثر من مستوى. وتكفي إطلالة على المعارض والصالات الفنية الرفيعة لنرى قوة التشخيص كعنصر جاذبية بصرية. ولكني استعين بالخلاصات والمفردات التشخيصية من اجل تكثيف الشحنة الشعورية وليس على سبيل التعبير الموضوعي والمنهجي. على هذا المستوى لم تعد للتشخيص قيمة معاصرة كتقنية مستقلة ومكتفية بذاتها. فالظاهرة البصرية في غالبية التجارب التشكيلية المتقدمة لا تكتمل سمتها الدرامية من دون إشارة تشخيصية. والتبرير الحقيقي للعنصر التشخيصي يأتي من داخل العمل ومن التركيبة التي يقترحها الفنان. التشخيص لم يعد هدفاً فنياً، بل هو هدف تزييني وكما انسحبت اللوحة الكلاسيكية أمام حداثة الانطباعية والمدارس التي خرجت من رحمها فأن التشخيصية والواقعية تراجعت أيضاً واصبح التمسك بالعمل الواقعي، حتى بالمقاييس الانطباعية والتكعيبية، محض مراوحة ونكوص. هذه المدارس تعد من الناحية الفكرية مدارس رجعية ومحافظة وتفتقد الصلة بالحياة المعاصرة. فالفنان صاحب الاحتكاك المباشر واليومي بالحياة لا يكتفي بالفرجة على العالم وعكس ما يراه حرفياً أو ببعض التعديلات. وغني عن القول إن حجم مبيعات الإنتاج التشخيصي والواقعي في السوق الاستهلاكي الغربي ليست مقياساً كافياً. بالنسبة لي يكمن الحسم في الطريقة التي يجري بها معالجة اللوحة والقيمة أو المرجعية الجمالية التي تنطلق منها عملية الرسم في جملة عناصر منها تقنية العمل وتوجه الفنان الثقافي ومدى رؤيته لعناصر ماضيه وحاضره والجدية التي يستشرف بها مستقبله. الشكل يروح ويجيء ويتمدد ويتشارك مع تقنيات وملامس مختلفة بحيث لا يمكن تقديسه بل حتى إمساكه. خذ لوحات فنون الإنشائيين أو رسوم ما بعد الحداثة النيويوركية أو الأوروبية كنموذج على ما أقول.