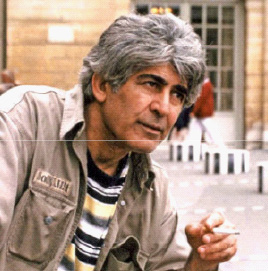علي حسن الفواز
من الصعب نزع الشعر عن الذاكرة الثقافية، والرهان على تمثلات أخرى لهذه الذاكرة، وحتى على الترويج لغياب صورته الافتراضية و(العًصابية) كديوان للعرب، فبقدر ماكرّسه الشعر طوال قرون من علامات وأمجاد، فإنه كان أكثر عرضة للخرق والتجاوز والتجدد، ولتأهيل لحظاته الفارقة، فهو بيت الاستعارة، والخفّة، واللذة، والإحساس بشغف السطو على اللغة..
مابين فكرة الديوان المُغلق، والفضاء المفتوح على الحياة، تتبدى صورة الشعر اليوم، في اسئلته وفي تحولاته، وفي طبيعة علاقاته الإجناسية مع المجاورات الثقافية، إذ كثيرا ما تتعرّض تلك الثنائية الى اختبارات صعبة، فهي جزء من لعبة التاريخ، ومن تحولات الشعراء أنفسهم، والذين تماهوا مع أوهام الاستبداد الشعري في ذاكرتنا، ومع الشغف بأغراضه، ومع طبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية، وعلاقة الشاعر بالسلطة وخضوعه لخطابها وأيديولوجيتها.. الميل القديم للمحكي لم يمنع الشعر عن ممارسة سلطته، فالمحكي يحتاج الى المكان، والإطار، والشعر ظل أكثر سموا وتمردا، فهو عالق بالفضاء، وبالحرية، بما فيها حرية القول، إذ كثيرا ما يضيق الشاعر بالمكرر والمهيمن، حيث يتكىء على فضاءات الخفّة في المجاز والاستعارة..
الحديث الرائج- اليوم- عن سلطة المحكي، وعن انحسار الشعر يبدو غير واقعي، ليس لطبيعة الشعر القارّة في وجداننا، بل لأنّ هذا الشعر هو الفن الأكثر بهاء، والأكثر قدرة على تمثّل لعبته في اللغة، وفي التلذذ بصورها، وبتشكلاتها البصرية، فالمحكي رغم سحره السردي يظل نسجا للواقع، ولحكاياته ووثائقه، وربما يسعى لأنْ يكون تدوينا آخر لتاريخه، وهذا ما يجعله أكثر افتراقا عن الشعر، الذي سيظل فناً متميزاً بفردانيته، وبخصوصية صناعته.. فضلا عن كون الشعر هو المجال الأكثر وظائفية في تمثلات الأجناس الأخرى، فهو حيويٌ في اغناء السرد والسيرة والحكي، بعيد عن سياسات دور النشر التي تراهن على صناعة النص الأكثر طبعا وانتشارا، والنص المُربِح في صورته التجارية..
الشعر والسلطة والجوائز..
يبدو أنّ تضخيم الاثارة حول(الموت الشعري) صار نوعا من البروباغندا، للتبشير بالأجناس الأخرى، ولفك سحر الأثر الشعري عن العقل العربي، إذ بات الذهاب الى السرديات محاولة فاضحة في برامج هذه الصناعة الضد، وبما يُعطي لها سلطة وأثرا، وقوة وإشهارات لها تموضعاتها الواضحة عبر شيوع ظاهرة الجوائز الباذخة، والتي لا أحسبها بريئة، إذ إنّ لرساميلها كثير من النوايا التي تفصحُ عن بياناتها الطاردة..
تنوّع الجوائز المحلية والاقليمية، وحتى العالمية التي تُمنح للرواية تحولت الى لعبة مكشوفة لفرض سلطة الرواية ذاتها، والتي قاد بعضها العديد من الشعراء، على مستوى التغيير في المغامرة الاجناسية، أو على مستوى الحصول على امتيازات تلك الجوائز المادية والرمزية، رغم أنّ توجهات هذه الجوائز باتت معروفة تماما، فهي تعمد الى كتابة مايشبه التاريخ المُتخيَّل للجماعات والأمم، والذي تعمل جهات معروفة و(مدسوسة) على تكريسه، بما فيها الجهات الداعمة للجوائز ذاتها، لاسيما ما يتعلق بالأطروحات الثقافوية والانثربولوجية التي تخصّ الهويات والجماعات وثقافات المقموع والمسكوت عنه، والحروب القومية والطائفية العلنية والسرية، والتوصيف الطوبوغرافي للمكونات الأقلية في المجتمعات الكبرى، ولعل ماقالته الروائية المصرية سهير مصادفة حول هوية كتّاب الرواية الآن يؤكد هذا الُمعطى، فهم ثلّة، يمكن أنْ تجمع الشاعر والناقد، (بل أيضاً السياسي ورئيس الجمهورية والملك والصحفي، ولا أستغرب هذا على الإطلاق؛ فالرواية أصبحت كتاب المكتبة وعمودها كما يُطلق عليها في الغرب).
هذه التسمية ستكون عدوانية في طرحِ أية مقارنة مع الشعر، وربما هي خادعة أيضا، فأشكال الكتابة خاضعة لعوامل التعرية والتحوّل والتجدد مثل أية ظاهرة تاريخية، لكنها غير خاضعة للموت، والمحو، وهذا سرّ كينوني موجود في فيزياء المعرفة التي ترفض موت(المادة) وأحسب أنّ تاريخ(الموضات) الثقافية زاخر بكثير من الكتابات التي سمّاها رولان بارت ب(المثيولوجيات) والتي قد تكون منافسة لأيِّ شكل كتابي، بدءا من الشعر والرواية والقصة وليس انتهاء بالأسفار والحكايات والكتب التي تخص الأزياء والموسيقى والرقص والرياضة والسيناريو وغيرها..
سلطة الناشر بدت أكثر من غيرها سطوة في تحديد هوية الكتاب المطبوع، فهي تفرض شروطها، ومكفآتها، إذ صار الشعر(مادة بائرة) وقليلة الاستهلاك، كما يقول البعض من الناشرين، وهذا مايعني العزوف عن طبع كتب الشعر، والاستعاضة عنها بكتب الرواية، والفكر، والأساطير والأديان، والذي يدفع الى توسيع مساحة الإعلان عنها، مقابل اهمال الاعلان الشعري، والترويج له، ولكتبه، وحتى للنقود التي تُكتب عنه..
الديوان العربي وتحولاته
أثارت الناقدة المغربية زهور اكرام جدلا حول توصيف هوية الديوان الثقافي العربي، والأسئلة التي تخص المرجعيات الشعرية لهذا الديوان، فهي تتساءل عن امكانية أنْ تكون( الرواية ديوانا للعرب) وهل أنّ وجودها هو الذي(يُحقق معادلة موضوعية، بين الشكل الروائي، والقدرة على تمثَل الوجدان العربي).
هذا التساؤل اقترن بالحديث عن علاقة الشعر بالذاكرة العربية، وبقدرته على المكوث فيها، وعن الطبيعة المغايرة التي جاءت بها الرواية الى هذه الذاكرة، فهي تقول: ( الكتابة في الشعر تعني الكتابة في المساحة العربية، وفي الزمن التاريخي العربي، لهذا تتشكل حرية مقبلة من الإحساس بالانتماء إلى زمن الشعر، في حين لم يكن الأمر كذلك مع الرواية، لأن الكتابة فيها كانت تحمل معها إحساسا بالتعبير في فضاء الآخر، ولذا كان التفكير، خاصة مع البدايات الأولى للممارسة الروائية العربية، يتجه نحو فهم هذا الشكل الأدبي).
هذا الطرح يفترض القيام بفحصٍ نقدي لهذا المعطى، فالكثير من التحولات الحادثة في الدرس النقدي، وفي نظرياته ومناهجه الحديثة تحولت الى مشكلة وعي، والى مفارقة في النظر الى المعرفة بوصفها نقدا، فعديد الدراسات النقدية المترجمة أخذت منحى الاهتمام بموضوعات السرديات، بوصفه المجال المعرفي الجديد، والذي توسّع الدرس فيه بعد الاهتمام الكبير باللسانيات، وأطروحات البنية والمتخيّل والأساطير، والسيميائيات وعلوم السرد، وغيرها، لاسيما بعد مقاربات باختين في التعدد الصوتي في الرواية، ودراسات جوليا كرسيفيا وجيرار جينيت ورولان بارت وغيرهم، والذي تحولت ترجماتهم للعربية مايشبه(الديوان المعرفي) الذي بات يستقطب الكثير من الحوارات، والكثير من الاهتمام الترجمي، والدعائي، مقابل قلة الاهتمام بالفهم العربي للشعر، وحتى للمحكي من الاسفار والسير والحكايات في موروثنا العربي، والذي باتت الدراسات عنه خاضعة –هي الأخرى- الى تقانات الجهاز المفاهيمي الغربي، وهو مايعني بقاء الشعر ضدا نوعيا للرواية والتي تقول فيها الناقدة زهور اكرام بأنها ظلت( جنسا أدبيا مقبلا من الزمن الأوروبي، فاحتاج الأمر إلى فهم زمن الرواية، ولذلك اهتمت المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بالتعريف بالزمن الثقافي الذي نشأت فيه الرواية، كما انشغلت بتعليم فن الرواية وخطابها، بدعم من مؤسسات الترجمة التي نشطت في نقل المعرفة الروائية إلى جانب العمل الدؤوب على ترجمة أغلب النصوص الروائية الأوروبية إلى العربية، وذلك من أجل استقبال واضح لثقافة الرواية).
روح الشعر…
النظر الى الشعر يظل- رغم التغايرات- هاجسا وجدانيا وثقافيا، ومن الصعب التغافل عن هذه الحقيقة الراكزة في اللاوعي الجمعي، إذ يرهن الشعر وجوده بالذاكرة، وبالقاموس، وكذلك بالتعاطي التاريخي لفهم الشعر وتداوله، فهذا الشعر ليس بعيدا عن شجون تلك الذاكرة، ولا عن مرجعياتها النفسية، فالشعر هو العمق الذي تستعيده الذاكرة دائما بوصفها غناءّ أو رثاءً، فضلا عن ما تؤسس عليها من أطروحات وقراءات، مقابل أنّ الرواية، والسرديات بشكل عام، لم تتحول الى مهيمنة قادرة على طرد الشعر أو حتى تهميشه، ليس لأن العديد من الروايات مازالت تُكتب تحت الهاجس الشعري، وأحيانا بلغته، بل- أيضا- لأن اللاوعي الثقافي العربي مازال شعريا، ورغم كل المحاولات التي تقوم بها مؤسسات ثقافية ومراكز غربية، تعتمد سياسات الاعلان والترجمة والجوائز الباذخة، وحتى القيام بجهود مدفوعة الثمن للترجمات التي تخص الروايات في امريكا واروبا واليابان بشكلٍ خاص، وحتى الترويج للدرس النقدي الذي يخصها على مستوى الكتب النظرية أو المناهج..
نّ(النسقية الشعرية) ستظل متوقدة بما تحمله، وما تثيره، والتي ستعزز المقولة التي تقول بأن الشعر نوعٌ من التفكير باللغة، وحتى التفكير بالوجود، وأحسب أنّ الأطروحات المتجددة لأدونيس، ولصلاح فضل ولعبد الملك مرتاض، وحتى لبعض الفعاليات الاعلامية مثل(شاعر المليون) سيكون لها أثر استعادي، ومُحفّز لتقبّل الشعري، والتشجيع على تلقيه، والاعلان عنه، وتشجيع الشباب على كتابته، وبفعل عوامل نفسية يدخل فيها النظر القومي للشعر، والنظر الجمالي له، وللتنوع الذي يمكن أنْ تتقبله الذائقة العربية وهي تواجه هذه البروباغندا الضخمة من المثيولوجيات التقانية، والتي باتت تغزو كل مساحات الوجود، وحتى تسطو على الذاكرة العربية غير المحمية أصلا..