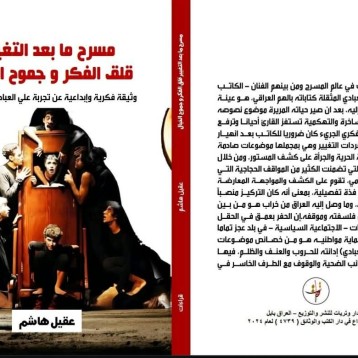شكيب كاظم
ينفتح الفضاء الروائي لرواية ( بين قلبين) الصادرة سنة ٢٠١٥ في ضمن سلسلة (سرد)، التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد؛ ينفتح فضاء الرواية على شارع الأميرات، بحي المنصور البغدادي الراقي الأنيق، و(ليلى) ابنة الأستاذ الجامعي (عاهد كمال الدين)، تسير متوجهة نحو بيت (زهير الماجد)، الذي لم تزره منذ مدة طويلة، تتعرض وهي تسير وحيدة في هذا الشارع الهادئ، إلى معاكسات شاب نزق، لا يلبث أن يطلق لسيارته العنان، بعد أن واجه صدوداً، لتنهال الذكريات- وهي في سيرها- بما يشبه الاسترجاع، الذكريات القريبة والبعيدة، منذ أيام الدراسة في كلية الصيدلة، حيث عقد الحب البريء النقي بين قلبين؛ قلب ليلى وقلب زميلها المؤدب (رياض الأمين)، الذي اغتنم إنهاءه الدراسة وتخرجه صيدلياً، فاصطحب أمه وأخته لدارة الأستاذ الجامعي الدكتور عاهد كمال الدين، المؤرخ، الذي يواجهه بتعال وجفاء، كونه مازال غض العود ليس بمكنته تهيئة عش الزوجية، لكن الأب المثقف دارس التاريخ- مما يؤكد ازدواجية الإنسان، وإن ثمة افتراقا بينا بين المظهر والمخبر-كان يرنو نحو (عصام) نجل الثري زهير الماجد، هذا الأب الوصولي، الأقرب إلى نهج المرابي، جعله الروائي (علي خيون) الذي سيجوس بمبضعه أدواء المجتمع العراقي، جعله يدفع ضريبة باهظة، إذ تتعرض دارته في حي المنصور إلى ضربة جوية، أثناء حرب كانون الثاني ١٩٩١- وما أكثر حروبنا!-تحيل الدار ركاما، ولم يعثر عليه إذ تشظى، سوى العثور على ساعته المربوطة على رسغه!
انهيار منظومة القيم
لقد دأب الكثير من الكتاب والروائيين، على تلافي توجيه النقد لتصرفات الناس، اغلب الناس، مجاملة لهم وهذا قصور فادح في عملية الكتابة التنويرية، التي تعنى بكشف الخطايا الخلقية، من أجل علاجها وتسليط الضوء عليها، لا أن ندس الرأس في الرمال.
الروائي علي خيون يوجه أصابع الاتهام إلى الناس، في محاولة منه لكشف هذا السلوك المجافي لأسس الحياة الرصينة وتعريته، الذين عاثوا فساداً ونهباً وتدميراً وحرقاً لمرافق الحياة في البلد، ما أن رأوا اختلال الأمن، واختفاء القانون والدولة، حتى انقلب (جزاع) الخادم في بيت زهير الماجد، وزوجته (صبرية) اللذين كان زهير وزوجته، يغدقان خيرهما عليهما، ما أن رأوا انفلات الزمام، حتى انقلبا إلى وحشين مفترسين، غادرا منزل زهير الماجد، ليستوليا على أحد البيوت المطلة على شارع أبي نواس، كما سرقا- يعاونهما (عباس) أخو صبرية- البيتَ الحكومي المجاور؛ جارهما الذي غادره حراسه لواذاً وهم يرون الحال الفوضوي، ولم تَسْهَ صبرية وزوجها واخوها حتى عن شبابيك دار الجار! فاقتلعوها، واقتلعوا المرمر والسيراميك الذي يكسو واجهة الدار!
وهذا الرجل الذي سحب من المصرف كل ما يملك، كي يعالج زوجته، يتوجه إلى ليلى في صيدليتها بحي المنصور، يشتري الدواء له ولزوجته، ما أن يغادر الصيدلية حتى يفجعه مرآى الزجاج الجانبي لسيارته المهشم بقسوة، والمبلغ الذي استولى عليه الفاعلون.
(بين قلبين) الرواية التي قسمها علي خيون إلى قسمين، يؤرخ الأول للحياة في بغداد منذ ١٥ تشرين الأول ٢٠٠٢، وحتى التاسع من نيسان ٢٠٠٣وتبخر الدولة العراقية، والثاني الذي شاء علي خيون أن يبدأ به بفاصل سنة؛ أي في ١٥ تشرين الأول ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٤، واندلاع الفوضى والانفجارات والاغتيالات وظهور الإنسان على حقيقته، لا يرعوي ولا يعف عن ارتكاب أوسخ الدنايا، فهذه (ناهد) ابنة (فاضل) المقاول، الذي شعاره من يتزوج أمه فهو عمه! أما من افِلَ فهو لا يحب الآفلين! والذي يدس نفسه في كل عهد وزمان، فيأخذ ما يشاء بشتى الطرق، ولكل مرحلة طريقها الخاص! وها هو يدس أنفه مع الجدد ويحصل على مقاولات مربحة، إنه كالمنشار! ناهد هذه تتعرف إلى الأستاذ الجامعي الدكتور عاهد، في تلك الحفلة التي أقامها زهير الماجد في دارته، فتوقعه في حبائلها، مشترطة عليه أن يسجل داره باسمها كي ترضى به زوجا، فيذعن الشيخ المسكين لطلبها وتستولي على الدار الفارهة، ناهد الخداعة هذه توقعها شرورها في شرك فاجر آخر عاشرها سفاحا وقتا طويلاً، ولا يقبلها زوجة شرعية إلا إذا سجلت باسمه نصف العقار، الذي ورثته ، لا بل سرقته من ذلك الأستاذ الجامعي.
ويواصل الروائي المبدع علي خيون، كشف أدواء هذا المجتمع الذي حطمته سنوات الديكتاتورية، والحروب طويلة الأمد، والحصار الذي أتى على كل قيمه، والمهم أن رأسه لم يتبخر! ألم يقل مرة وهو يتمشدق في قتال ثلاث وثلاثين دولة: اتبخرنا؟! نعم أنت لم تتبخر، لكن تبخر المجتمع العراقي، وتبخرت قيمه وفضائله!
يواصل الروائي علي خيون، توجيه عدساته المكبرة إلى هذه الأدواء وهذه الخطايا، واقفا عند وصولية ( لميس) ابنة ذلك الضابط الكبير، التي تتعرف في تلك الحفلة التي أقامها- كما ذكرت آنفا- زهير الماجد في دارته الأنيقة الفارهة، تتعرف إلى (أنور) المقدم الطيار؛ ونجل الأستاذ الجامعي عاهد وشقيق ليلى الصيدلانية، ويتقدم لخطبتها، وتشتعل الحرب؛ حرب سنة ١٩٩١، فيؤمر بتنفيذ عملية انتحارية بطائرته، غير أن طائرته تُسَقط ويقع في براثن القنابل العنقودية، ويخسر يده اليسرى، ويطول عليه الأمد أسيراً، حتى ظن معارفه الظنون، فتغتنمها لميس، لتتعرف إلى (سعيد) ابن فاضل المقاول الذي لا يحب الآفلين! لكن بعد لأي يعود رياض من الأسر ويراها في أحضان هذا السعيد!
لكن من أجل أن يكون العمل الروائي واقعياً، ومقبولاً ومتماهياً مع حقائق الحياة والأشياء، وإن الدنيا ليست دناءة وسقوطا أخلاقيا وانتهازية، بل ثمة جوانب إيجابية ومشرقة، ولولاها لأمست الحياة جحيما، ومن هذه الشخوص الإيجابية ليلى الصيدلانية، على الرغم من تلك الهفوة التي ارتكبتها مع ( عصام)؛ ابن زهير الماجد- الذي عقد عليها شرعا وأضحت زوجته- ضعفت أمام إغراءاته فأسلمت نفسها له، وما درت أن الحرب ستأكله وشيكا، وأمست حياتها كالمعلقة، فلا هي متزوجة وليست مطلقة.
ظلت ليلى نموذجا إيجابيا، تساعد الفقراء في صيدليتها، تحنو على ( نجيبة) أم زوجها عصام، بعد تلك الفاجعة التي حاقت بها، وظلت بسيطة حتى مع الخادمة صبرية
ولأن الحياة أمست لا تطاق، بعد هذا العصف القاتل الذي ضرب الحياة العراقية بعد ٢٠٠٣، فإن الروائي المتألق علي خيون- الذي عرف بأسلوبه المركز ولغته التعبيرية الراقية الجميلة- ولأن ليلى هذا النموذج الإيجابي في الحياة، ما عاد بمكنتها مواصلة الحياة مع هذا الركام المجتمعي، فلا مناص من أن يضع حدا لهذه العذابات، بعد فقد الزوج الحليل، فلا هو أسير ولا هو شهيد، وبعد استحواذ ناهد، ابنة المقاول فاضل ، على دار أبيهم الذي اقترن بها، وبعد تحطم شقيقها أنور المقاتل الطيار، تحطمه جسديا بفقده يده، ونفسيا بفقده خطيبته التي خانته، ما عاد يشدها إلى الحياة شيء.
تذهب إلى المصرف لاستبدال نقودها القديمة، فتلتقي مصادفة، ولعلها مفارقة؛ تلتقي برياض الأمين، زميلها السابق في كلية الصيدلة، والمتقدم لخطبتها، الذي لم يقبله أبوها لفقره! وقد وَخَطَ الشيبُ شعر مفرقه، رأت ولكن يا لهول ما رأت؛ مجموعة من المسلحين تهاجم سيارة زهير الماجد، الذي جلب- هو الآخر- نقوده القديمة كي يغيرها، تقتله وتسرق نقوده، ثم دوي انفجار هائل يضع حدا لحياة ليلى عاهد كمال الدين.
ويتألق الروائي والقاص العراقي المبدع علي خيون، وهو يصور تهويمات ليلى الأخيرة، منتقلة نحو ذلك العالم الأثيري، الذي ينتقل إليه الإنسان مغادرا حياته الدنيوية نحو اللا أين!
“اقول لكم من عل حيث لا يمكن أن تروني: إنني أموت، لكن موتي حياة!
هدأ المكان تماماً، ولاحظ الجميع أن رجلاً يحمل كيسا من النقود، يدور حول جسد ليلى المسجى في الشارع، تأمل وجهها، وألقى ما في يده مذعورا، وهو يهز يدها بقوة: -ليلى
عندئذ جثا إلى جوارها، وانخرط في البكاء، بينما تطوع عدد من المارة ليقدموا لهما المساعدة الممكنة، وسمع رياض أحدهم يسأله:
– أهي قريبتك؟ هيا، لننقلها بسرعة إلى المستشفى، ما فتئت تتنفس!
كان يتأمل مشدوها، المصحف الصغير الذي لاح لعينيه يتدلى من عنقها.
وتبسم، على الرغم مما هو فيه، لذكرى جميلة، جمعت بين قلبين”ص١٩٨