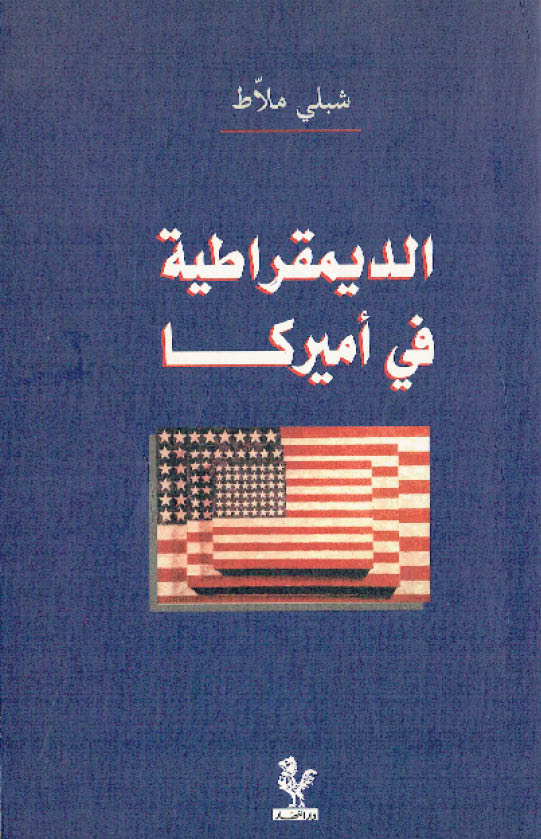يتناول كتاب “الديمقراطية في أميركا” للباحث والخبير شبلي ملّاط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، ألا وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة لإنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة.ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس دي توتكيفل الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحولات الجديدة في العالم الراهن وهي تحولات لابد من وضعها في إطارها التاريخي والإنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بلا عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم الإقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، ومحاربة الفقر، ونبذ الاستغلال الاقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط الإمبريالي أو الدكتاتوريات الأيديلوجية، ويعلي بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن الاجتماعي وتعزيز القيم الحضارية والانتصار للعدل والحياة.
تنشر “الصباح الجديد” حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.
الحلقة 3
شبلي ملّاط:
وعلى اساس ملاحظات القاضي براير يمكن بناء نظرة رديفة تعتمد على المحاذير التي سطرها من دون ان تتغاضى عن تقصير الرئيس او ان تضعه فوق القانون فحتى بعد اقرار المحكمة في كيلتون ضد جونس بان الرئيس خاضع للقانون كأي مواطن عادي . كان بامكان الرئيس المتهم ان يضع حدا فاصلا للعملية في مناسبتين بارزتين. وان يشخص المشكلة في سياق اخلاقي وقانوني مختلف. بدل اللجوء الى التلفيق التافه والتبرير الخجول فيعلن بشكل بسيط وحازم عن استعداده للامتثال للتحقيق كما قضت به المحكمة العليا ، مشترطا رفض الإجابة عن افعال خارجة عن اي نطاق جرمي بحسب قوانين البلاد فعلاقة جنسية بين شخصين بالغين اتفقا فيما بينهما على اقامتها قد تكون مستهجنه اخلاقيا او دينيا . لكنها لا تمثل جرما، وهي على اي حال لا تخص الرأي العام فلو ركز الرئيس على الخط الفاصل بين اموره الخاصة ومهامه الحكومية الرسمية ،لظل في منأى عن تطاول المحقق على شؤونه الخاصة ،محافظا في الوقت نفسه على الأبهة الملازمة لمركزه.
وفشل كلينتون في حفاظه على المكانة الرئاسية يتعدى الحرج التابع لفضيحة علاقاته الجنسية ، لا سيما عندما عمد في جوابه الشهير خلال التحقيق الى تأكيد ” توقف الامر على ما هو المقصود بكلمة “هو” it depends on what the meaning of the word is is” في ديباجة شهيرة تشكل اختصارا وافيا لنوعية الزعامة في ولاية كلينتون ، والجملة من تلك التي لا يرتقي اليها تراث اعلام الكتابة السوريالية في اوجها.
وليست متابعة الغرض السياسي بأكثر السبل صلفا وقساوة ، ومثل هذا الهوس السلطوي كان طاغيا عند المحقق الخاص كما عند الرئيس ، بدون ترتيب نتائج وخيمة على المسار الديمقراطي الذي رسمه قاضي القضاة جون مارشال marshall في قرار ماربوري ضد ماديسون الشهير سنة 1803: “فحكومة الولايات المتحدة قد وصفت مرارا وتكرارا بحكومة القانون لا بحكومة الاشخاص. ولا شك انها ستفقد الحق في هذاالوصف العظيم اذا امتنعت عن توفير الثواب الصحيح وعن ضمان الحق” واذا صح ان لا احد فوق القانون ، فأن الرئيس يتمتع بحق ثابت في الحفاظ على خصوصية حياته ، بما فيها اقامة علاقة خارجة عن العقد الزواجي مهما كانت هذه العلاقة مذمومة اخلاقيا. والمشكلة المزمنة المتأتية من فضيحة مونيكا غيت ، والتي تنذر بحلول دولة الاشخاص بدل دولة القانون والمؤسسات ، هي في محو الحد الفاصل بين حياة المسؤول الحكومي الاول ومكانة المنصب. فاستقرار المؤسسة الرئاسية ضاعت حصانتها في الرئاسة الثانية والاربعين بسب ضعف بيل كلينتون وحقد كينيث ستار عليه ، فيما صارت جمهورية المؤسسات عرضة للوهن في محيط الرئاسة الاقرب.
فمن اكثر مظاهر الوهن في المؤسسة الرئاسية ايلاما ترشيح زوجة الرئيس لمجلس الشيوخ قبل نهاية ولاية زوجها. ومهما كانت شخصية هيلاري رودام كلينتون مميزة ، لا سيما في التؤدة والكرامة اللتين اظهرتهما في خضم مصاعب حياتها الزوجية ، فقد فتح الانحطاط الاخلاقي خلال الولاية الرئاسية الثانية والاربعين بابا واسعا للتعسف في استعمال السلطة ، يطرح تساؤلات جدية عن وضع الساحة العامة في اميركا من حيث المبادئ الجمهورية الاساسية فيها ، وتجاهل الرؤساء وازواجهم حدود مناصبهم في النظام الدستوري الجمهوري والاسس التي بنيت الولايات المتحدة عليها. ففي تكاثر اعتناق الابناء والازواج ادوارا سياسية بارزة في كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ظاهرة مقلقة فيماخص مصير تفوق الجهد الذاتي على العصبية العائلية ، بعد قرنين من انتصار الثورة الشعبية الاولى في العصور الحديثة. وفي محيط الرئاسة ، تحتاج الزعامة الاخلاقية الى ثوب جديد يجعل المسؤولية الملازمة لمنصب الرئاسة مصونة من تطفل الازواج والابناء والاقرباء. وعلى هذا الاساس المبدئي باتت ضرورية تنقية القنوات السياسية في قمة الهرم ، لأن “الخلل يحدث عندما يفتقد المسار الثقة ، وعندما يخنق الذين في الداخل قنوات التغيير السياسي بحيث يتأكدون من انهم باقون في الداخل وان الذين في الخارج باقون في الخارج”.
واذا كان اختناق قنوات التغيير السياسي قائما بشكل واضح جراء سيطرة السلطة المالية على اللعبة وطغيانها على المساواة بين الناخبين ، فأن هذا الاختناق يتحول كارثة عندما يصبح المحيط الرئاسي “في الداخل” مكتظا بالابناء والازواج والانسباء ، فتغدو العائلة المقربة عنوان تصدر الحياة السياسية في الجمهورية المعاصرة.
وبات هذا الاتجاه مقلقا على جميع المستويات في الحياة العامة في اميركا في العقد المنصرم ، وليس تحكم الازواج والاولاد بالقنوات السياسية مقتصرا على الرئيس السابق ، وان كان سير زوجة الرئيس في ركاب الحملة الانتخابية في مجلس الشيوخ قبل ان تنتهي ولاية زوجها مدعاة مميزة للتساؤل عن تراجع الديمقراطية الجمهورية في الولايات المتحدة في عهد الادارة الثانية والاربعين.
والاسلوب الرئاسي في عهد كلينتون لا يشكل السبب الوحيد للتساؤل عن الجهد الحثيث للذين “في الداخل” كي يحتفظوا “بداخليتهم” ومراكزهم على حساب الاخرين. فاذا كان لابد من حشد دستوري كبير للحد من تعاقب الولايات البرلمانية للشخص الواحد من دون نهاية في الكونغرس ، فأن الامتثال الاول دائما يبدأ في القمة ، والرئاسة في القمة. اما “القيم الجمهورية” التي رسمها اباء الدستور في اول التاريخ الاميركي ، فهي الان بحاجة الى احياء دؤوب في مقابل التعسف في استعمال السلطة ، وعلى رأس القائمة الاصلاحية تقليص الدور العام لذوي العائلة المقربة والانسباء. والخطر في التغاضي عن هذه الظاهرة يقضي بالتساؤل عن تفوق النظام الملكي على النظام الجمهوري ، والسماح بارتباط اسبقية الوصول الى المناصب العامة بالنسب العائلي او الرابطة الزوجية قبل ارتباطها بالجهد الذاتي ، مع ان هذا الجهد هو ما تعتمدعليه فكرة الجمهورية اصلا. اما اذا عجزت الجمهورية عن احترام مبادئها الاصلية فلابد من احياء فلسفة النظام الملكي ، وهو اجدر بأقناع الناس ان تربع الانسان العادي على كرسي الحكم ليس مطروحا اصلا.
3. تقييم سجل الادارة الداخلي
طبيعة الانجازات الاقتصادية
بالعودة الى سجل الولايات المتحدة في ولاية الرئيس كلينتون ، لا بد من الاقرار بأن الارقام شواهد على صعود معظم المؤشرات الاقتصادية المعهودة. يبقى السؤال مطروحا حول اسباب هذا التفوق. فهل جاء هذا النجاح نتيجة السياسة التقشفية التي اتبعها زعماء الكونغرس في العهدين السابقين ، ام هي الادارة الاميركية تجني الحصاد الاقتصادي من انتصار اميركا في الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية ، ام ان السبب متعلق بطبيعة الدورات الاقتصادية وحتمية الصعود والهبوط في دنيا الاعمال؟ هذه الاسئلة مطروحة جميعها على المؤرخين لكن الامر الوحيد الاكيد هو ان الرفاه الاقتصادي الفريد في التسعينات سوف يبقى مرتبطا في التاريخ الاميركي باسم وليم جفرسون كلينتون.
تكمن الصعوبة التي سيواجهها الرؤساء المقبلون في قدرتهم على المحافظة على مثل هذا النمو الاقتصادي. وفي غياب تفسير شاف للمعجزة ، سوف يتبع خلفاء كلينتون سياسات حذرة ومحافظة ، ان بالنسبة الى مجلس ادارة المصرف المركزي وخياراته التقشفية ، او بالنسبة الى النظام الضريبي. وقد تنجح او لا تنجح الاستمرارية في النهج ، الا ان السياسات المقبلة محكومة سلفا بالامتثال لهذا النجاح- السابقة ان لجهة الاحاطة بشروط استمراره فيتأمن نجاح الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة ، ام لمجرد الامتثال لما يبدو ظاهرا وكأنه مفتاح نجاح الادارة الثانية والاربعين اقتصاديا.
الا ان الارقام الزاهرة قد تخفي تساؤلات عن حقيقة النجاح الاقتصادي خارج الخريطة المألوفة للمؤشرات المتبعة ، ومن بينها التغيير الجذري الذي طرأ على تركيبة القطاعات الاقتصادية نفسها. ان التقييم الاقتصادي الذي ثبت واستقر في النصف الاول من القرن العشرين هو تقييم يعتمد في مقاربته العامة macro على توصيف ثلاثي للقطاعات الاقتصادية- الصناعة والزراعة والخدمات ، في حين ان هذا التوصيف بات فارغ المعنى في ظل نمو السلع غير الملموسة ، كما في ظل الصفة التصنيعية الطاغية على القطاع الزراعي. فالزراعة تجند اقل من 3 بالمائة من اليد العاملة الوطنية في الولايات المتحدة ، وقد صارت محكومة في نموها بالاكتشافات البيو-تكنولوجية ، فيما باتت الصناعة تشمل منتوجات hardware وبرامج software تدخل نظريا في عداد “الخدمات” .