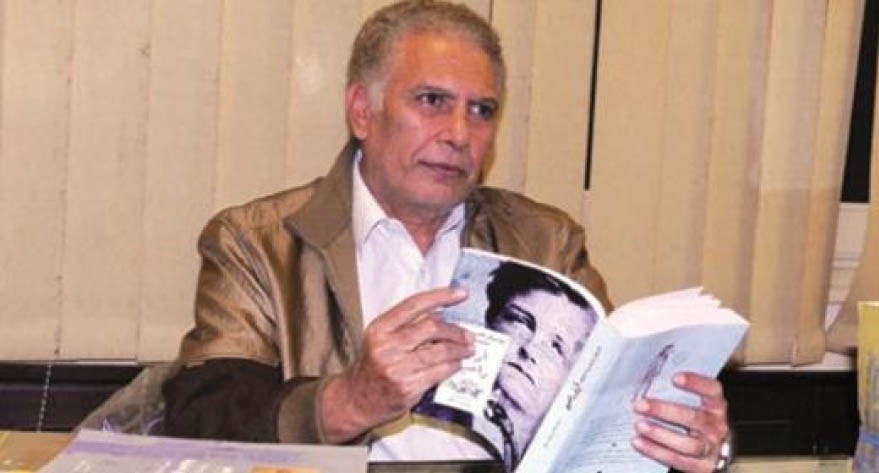ميشرافي عبد الودود
تحضرني للشاعر دائما في مخيلتي، أكثر منه في الذاكرة، صورة المشّاء الذي لا يتعب: قامة مستقيمة، مشدودة إلى الأمام قليلا، وقفص صدري مفرود، يتسع لحجم المفردات الهائلة، التي تكبر وتتكاثر، بفعل ضربات أنفاسه المتلاحقة، فيما تهشّ عصاه الشعرية، على الرؤى أو الأخيلة التي تختبئ كالحباحب المضيئة، بين أكوام الحجارة في ليل المدينة، التي تسدل جفونها الباكية على جراح الأمس. التاريخ يتعقب كمخبر سري خطواته الرشيقة والواثقة، ويحسب عليه أنفاسه القوية، في السكون المهيب، لِلَيلة خلت سوى من الأشباح.
هذا الكائن السديمي لا يوجد هنا للنزهة، لا يوجد بمحض الصدفة، إنما لأداء مهمة مستعجلة، تحت جنح الظلام، ويعود للتو أدراجه. المدينة النائمة شبه مدمرة بالكامل، ورحلة البحث عن جدار لم يتهاو بعد، تبدو شبه مستحيلة. لكن لا مجال هنا لفقدان الأمل، الذي يعيد الشاعر صياغته كخزاف، على مر العصور، من الحروف ذاتها لخميرة «الألم».
كما هو الحال دائما، يعثر الشاعر في الأخير، في لحظة اليأس الفارقة، على حصة من جدار، لا يزال واقفا، ويتحسس بعصاه، صلابته، وتماسكه، قبل أن يباشر تفريغ المفردات المجنحة، التي ترتسم دفعة واحدة، على الطلاء الشاحب. يتنفس الصُعداء بارتياح، ويستدير على الفور بخفة ساحر، أدى دورا استثنائيا، أمام جمهور لا يُرى، تاركا للعصا الهادية، أن تقود خطواته المتعجلة، غير مفكر سوى في مدينة الأشباح النائمة، التي ستستيقظ لا محالة، باستيقاظ جراحها، بعد بضع ساعات، بحلول الصباح لتفتح جفونها، على الحروف الكبيرة المضاعفة، التي تتسلق «الجدار الأخير»، الذي لا يزال منتصبا.
«الجدار الأخير» الذي لم يتهاو بعد، ولا يزال منتصبا، ليس شيئا آخر غير جدار اللغة. بعد سقوط جميع الجدران الحاملة للكتابة المقدسة، و»ضياع الخريطة»، وطرد الشعر من المدينة الحديثة؛ ازداد العبء على الشاعر في الأزمنة المضطربة: ليس كافيا أن يتعرف إلى «مبكاه الأخير»، ليس كافيا أن يقول الكلمات العالقة طويلا غصصا في الحناجر والصدور، الكلمات الناشبة منذ زمن مغصا في البطون والأحشاء، بل ينبغي تشييد الحصون اللغوية، ورفع القلاع البلاغية، بما يتيح لهذه المفردات الفادحة والفسيحة أن تتنفس داخل عمارتها، تنعم بهدوء نسبي، تواصل الحياة بشكل شبه طبيعي، ولو «بعلم أبيض مرفوع على الأسوار». الشعراء بشكل أو آخر يشكلون «خط الدفاع الأخير» بتعبير الشاعر المعاصر.
هذه الصورة الشمولية تنطبق تحديدا على هذا الشاعر المعاصر، «المشاء حافيا» داخل شروخ التواريخ ودهاليز الجغرافيات على السواء: رفعت سلّام الذي اقتحم المشهد الشعري المصري في سبعينيات القرن الماضي، وأحدث خلخلة ببنية القصيدة العربية.
بالرغم من أنني أمشي على أطراف أصابعي حتى لا أزعج أحدا؛ لا أصدر حفيفا، أو رفيفا، أو خشخشة، أو قعقعة، أو قرقعة، أو ما؛ ما شابه. كأنني مشاء سري، لا مشاء مرئي.
لا يمكن قراءة المجموعة الشعرية «أرعى الشياه على المياه» الصادرة عن دار مومنت، إلا كعمل فني بامتياز: الشعر هنا فن قائم بذاته بالتأكيد، لكن انشغالاته الجدية وانهماكاته الدؤوبة للبحث عن أشكال كتابية جديدة، تجعله يتبوأ مكانته بين «الفنون الجميلة». القصيدة الحداثية التشكيلية هنا لوحة صوتية متعددة صاخبة، وهندسة مدروسة للفضاء والزمن على السواء: صوتنة اللغة إمساك بالنبض الشعري بهدف التخلي على عنصر الإلقاء الزمني أو الغنائية الفجة التي لا تزال تطبع الشعر العربي. الاعتماد بشكل باذخ على تقنيات النثر الفني العربي أو فن البديع (من السجع والجناس والطباق والازدواج..)؛ تفجير للطاقات الإيقاعية الكامنة التي لا حدود لها في اللغة العربية، وخلق بالأصوات المتناغمة لفسيفساء تشكيلية حركية.
تشكيل بصري
ينضاف إلى التشكيل الصوتي التشكيل البصري المحكم عبر إعادة صياغة فضاء الصفحة على غير مثال، وتقسيم النص إلى «عمودين غير متساويين (يذكرنا بتقسيم التوراة في طبعاته الغربية)، تحتل كل منهما أصوات شعرية تنتمي إلى أزمنة غابرة ومضاعفة». ويشكلان رافدين يصب أحدهما في مجرى الآخر في لحظات الذروة، لكن من دون أن تختلط مياههما، أو هذا ما يحاول الشاعر إيهامنا به من خلال الاحتفاظ بالتمايز الطباعي بين العمودين. هذا النسق المزدوج للنص يوازيه نسق آخر للمتن والهامش «المنفي»، كما أن «اللغوي يتداخل مع التشكيلي» الذي يستدعي «رسوما رمزية محفورة في الذاكرة». القصيدة المرئية «كولاج ضخم» يتفوق ربما على باقي الفنون الأخرى في هندسة المجال البصري.
اللغة علبة أدوات مفرَغة من حمولتها المتعالية، ومجردة من سيادتها المطلقة وتمثلها الواحد. إنها اغتراب داخل اللغة المكتوبة واستيطان في عوالمها السفلية المقموعة والمتاهية؛ عبر تأزيم موروثها وترحيلها عن الهيمنة المركزية لانتظاماتها الذهنية المسبقة. من هنا يضطلع رفعت سلام بمحاولة تجريبية جبارة تتمثل في «إعادة كتابة المكتوب»؛ كجغرافية سرية وإسرارية تؤسس للقصيدة كخطوط انفلات للفعل المبدع والمقاوم لكل استبدادية ميتافيزيقية أو مرجعية ارتكاسية. بإمكان الشاعر أن يستعمل «مفردات القبيلة» وينقلب عليها في آن معا.
مجموعة «أرعى الشياه على المياه» تستدعي نصا من سفر الجامعة محاولة اختباره في محك وراهنية القصيدة. هذا التناص المحموم الذي سيرافق الخطاب الشعري محايثة للواقع واختبار للهشاشة الأنطولوجية للمعنى المطلق، و»معاينة فقدانه». النص يستمد شرعيته من خلال تأسيسه مرجعيته الخاصة؛ تلك المرجعية التي ستعيد كتابة سردية التاريخ الكوني؛ التي لا تعترف بالتسلسل الزمني ولا بالتصنيف السياسي، أو التراتبية بين الأجناس.
تحت «شمس منيرة سوداء»، شمس عنكبوتية، لا تسطع سوى على سمائنا العربية، منذ فجر التاريخ؛ يفتتح الشاعر هرج النص. والإحالة هنا، كما لا يخفى، على شاعر «على قلق كأن الريح تحتي»، الذي استطاع زحزحة جلمود الشعر العربي، المحطوط من عليائه، ودحرجته من جديد في المهاوي. هكذا تبدو قصيدة رفعت سلّام على الأقل: طوال مسيرته الإبداعية، على امتداد نصف قرن من الزمن تقريبا، منذ «وردة الفوضى الجميلة» حتى عمله الشعري الأخير «أرعى الشياه على المياه»؛ تمرّن رفعت سلام كحامل أثقال، على تحريك، رفع ودحرجة صخرة الشعر من منبتها – «الحجر الذي رفضه البناؤون» – ، والإبقاء عليها متدحرجة في المنحدرات الخطيرة. تلك لعبته الأثيرة، بينما تؤثر الأغلبية مواصلة لعبة الحجلة الكلاسيكية.
أعترف أنني لست من هواة البلاغة التقليدية، ولا الرومانتيكية؛ وخاصة إذا ما كانت عاجزة عن الإحاطة بفداحة الموصوف. موصوف لا يوصف. ولا تحيط به اللغات
المكتوبة والشفاهية.
من هذه الشمس العجوز التي تغزل آخر خيوطها الهزيلة، سوف يشكل الشاعر رفعت سلّام شباك قصيدته: القصيدة لديه نسيج هش معلق في الفراغ، سرعان ما يشتد تحت أنفاسه ولا يتلاشى. مهما بدت خيوطها المرئية واهية، فإنها تحافظ على تماسكها، وتستعصي على الانقطاع، مقاومة للتوتر، بشكل مثير للذهول: الهشاشة هنا ليست دليل ضعف، إنما دليل على المرونة. براعة الشاعر الذي «لا يحب الابتلاع السريع» أن يموِّه جيدا شبكته الشفافة في مسار الشمس؛ المضيئة للواقع الحقيقي والمتوهم في آن معا، ويتسلق كمظلي/عنكبوت الخيوط الواهنة، من زاوية خطرة إلى أخرى، محاولا دفع الفرائس إلى حتفها. تلك الفرائس التي تنجذب إلى الفخاخ المموهة بشكل تلقائي وأعمى.
القصيدة مأدبة كبيرة يفتتحها «الغراب الناعق» الذي يرفرف «مبهورا» فوق «أشلاء» حاضر تحول إلى موكب جنائزي: مهمة الشعر أن يحتفي «بالقيامة التي تزدهر» في الأسفل؛ حيث «رعب الحياة» و»نشوة الحياة» شيء واحد. ثمة شراهة عظيمة على امتداد النص؛ ليست «جوعا»، بل مجرد «شراهة لا تفنى» بحجم الواقع المتفسخ والمتحلل، ولا يعتريها أي اشمئزاز.
نزعة السقوط
والتلاشي في الفراغ
تهيمن لدى رفعت سلّام نزعة السقوط والتلاشي في الفراغ؛ مهما بدت الأشياء متماسكة وراسخة في بيئتها، فإن ثمة جاذبية أقوى منها، تجتذبها إلى الهاوية التي تنفتح بانتظارها: «صخب وعنف» العالم الشعري بمختلف كائناته – عمالقة وأقزاما – يوازيه قابلية للاضمحلال، للتحلل والامتزاج بذرات الهواء. كما أن قصيدة الوداعات الكبرى تسوس شعوبها وقبائلها مثلما «تسوق القطيع على الجرف إلى حتفه» بعد «قضمه ما يكفي من عشب الندم». حتمية السقوط قانون يسري على عالمنا «السفلي» المتهافت الذي يبدو كما لو «اجتاز الحساب» إلى «العقاب». مع ذلك فإن هذا السقوط لا يحيل على تفاحة آدم أو تفاحة نيوتن: ليس خطيئة بدئية ولا نظرية فيزيائية علمية. إنه لعنة التاريخ الذي لا تتسع الجغرافيا لفيضانه الدوري، المتعاقب على امتداد الفصول.
لماذا أهجِس كثيرا بالهاوية؟ أعرفها؛ هي خِلِّي
الوفي كظلي، كقطة تتمسح بساقِي. أراها –
ببصيرتي – كامنة، في مكان ما، في انتظاري،
لتمنحني – في لحظة ما – وردتها القاتلة.
هكذا فإن المجازفة التي يضطلع بها الشاعر هنا ليست ذات طابع دوغمائي أو إيديولوجي، بقدر ما هي اجتراح للوجودي، واختبار للهش والصلد معا، للزائل والأبدي فينا، وبالتالي الذهاب بالكتابة إلى أقاصي الفقدان: تجربة السقوط أو الانقذاف تعلمنا أن نزن أنفسنا، ونزن العالم في المثاقيل الملائمة. وهذا من شأنه أن يجعلنا نتقبّل وزننا الحقيقي، ووزن العالم الذي نعيش فيه. لعلها فرصة السلام المؤقت والمشروط لإقامتنا الأرضية، بعيدا عن أية مقايضة، سياسية، دينية أو أيديولوجية. «إرثنا غير مسبوق بأية وصية» كما يقول ريني شار.
هو صراطي المستقيم؛ تعبت في صياغته،
بعيدا عن العيون، هو صفعتي في قفا
العالم البليد (كأنه مدمن أفيون
أو حشيش) حتى يفيق إلى رشده.
الوزن الحقيقي للأشياء والذات، لا يتأتى سوى بتفريغ العالم المتضخم، والمتورم من «قيوحه»: التاريخ البشري سلسلة من الأخطاء الفظيعة، والشنيعة التي تكرس نفسها، كحقائق مطلقة؛ وينبغي التحرر من أعبائها و»خزعبلاتها»، فضح أساطيرها وأسطراتها. القصيدة بما أنها نقيضٌ للشعبذة وبديل لها؛ ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات مع الأعداء الكثيرين (الشاعر خارج عن القانون والأعراف السائدة، ومطلوب تقريبا لدى الجميع)، وتصفية النفس «الأمارة بالسوء»(سوء الفهم قبل كل شيء)، وإعدام «رمادها». هيمنة ضمير المتكلم على الخطاب الشعري على امتداد النص، لا يعني سيادة الذات المتكلمة، إنما سيادة لذات الكتابة المتوضعة في زخم تعدديات وصيرورات العالم، بخروجها عن سلطة المعنى ونسقية الأسلوب.
حَسْبُ الشاعر، هذا «الخصم الهش»، و»الخاسر الأبدي»؛ «بلزومه ما لا يلزم»، بوعيه الشقي أكثر من أي وقت مضى، أنه أعزل ووحيد في المعترك؛ أن يواصل الاستماتة البطولية اليائسة، لدفع مصير محتوم قبل الآن، لا تملك اليد العاجزة مقاومته أو ردا له، كما فارس الأزمنة القديمة. الشاعر الذي عاش سلفا هذه الحياة آلاف المرات «سيد الخسارات»، و»لم يعد له ما يخسره سوى الخسارة».
السفينة البشرية التي تحمل من «كل زوج اثنين»، تَقَرّر غرقها سلفا؛ لأن «من يبحر مع الكذب لن يصل إلى اليابسة». والقصيدة التي أضاعت مرساتها؛ آخر تلويحة للأيادي المستنجدة دونما أمل، قبل التحاقها بحطامٍ عريق، سيتحول عما قريب كباقي سفن التاريخ إلى رواق من المرجان في القيعان. لحسن الحظ ثمة «شاهد»؛ «الناجي الوحيد ربما» و»الأعمى» (لسخرية الأقدار)، منذ هوميروس الإغريقي إلى اليوم.
أيها القتلة:
لست القتيل
أنا الشاهد الأعمى الذي رأى كل شيء
الشرط الأعمى ضمان لأهلية الشهادة؛ فالاقتراب من حرائق التاريخ، وتدوين المشاهد المذعورة من بؤر التوتر؛ يدفع الشاعر الذي «يستدرك قصور المؤرخ» – كما في وصية سعد الله ونوس – ثمنهما باهظا جدا: رؤية كل شيء، تضحية بآخر قطرة نور في العين المنطفئة التي استحالت قزحيتها دفعة واحدة؛ إلى المصب البطيء لأفول شمس 25 يناير 2011 المستمر حتى هذه الساعة.