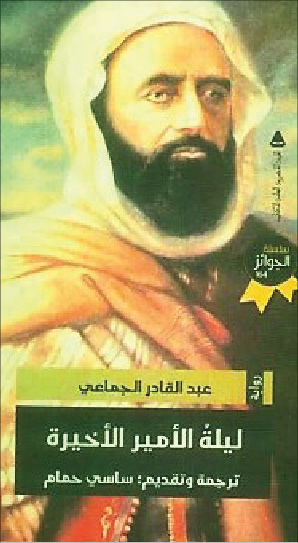طارق إمام
ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 1847، يستقل الأمير عبد القادر الجزائري رفقة سبعة وتسعين رجلاً وامرأةً وطفلاً من أنصاره البارجة الفرنسية «سولون» مستسلماً، بعد خمسة عشر عاماً من مبايعته أميراً للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. من «جامع الغزوات»، المرفأ الصغير القريب من الحدود المغربية، يُبحر الأمير عبد القادر مودِّعاً أرضه لمنفاه في فرنسا، ليستقبل الروائي الجزائري «عبد القادر الجماعي» البحر نفسه، في نصه الروائي «ليلة الأمير الأخيرة»، مبقياً قدمي بطله في المرفأ.
على عتبة هذه اللحظة التراجيدية يقف «الجماعي» ليُشيِّد «ليلة الأمير الأخيرة»، التي كتبها بالفرنسية ونشرتها دار «سوي» الباريسية، قبل أن يترجمها الكاتب والمترجم التونسي «ساسي حمام» للعربية لتصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.
تقارب «ليلة الأمير الأخيرة»، اللحظة المفصلية في حياة الرجل الذي سماه الفرنسيون «سلطان العرب»، والتي وإن لم تكن لحظة نهاية حياته، لكنها كانت اللحظة الأكثر مفصلية واحتشاداً، ليس فقط في سيرة رجل استثنائي، بل وبلد اختصر عنوان مقاومته في اسم بطل ملحمي سيتحول لاحقاً إلى التمثال الأشهر في قلب عاصمته. كان الأمير عبد القادر في التاسعة والثلاثين فحسب عندما انتهت مغامرته الشابة كمُخلِّص بعد سنوات من الكر والفر، حيث معارك استثنائية وهدنات لم تدم طويلاً، وتخلٍّ أخير ممن يُفترض أنهم الأنصار، لتبدأ حياة جديدة تستمر ستة وثلاثين عاماً حتى وفاته صيف عام 1883.
لا تتحرك رواية الجماعي في بنية خطية تعاقبية، بل تتقافز بين لحظات متفرقة، بحرية، في استرجاعات واستباقات تمنحها بنيتها المتشظية وفراغاتها المقصودة. يفعل الجماعي ذلك في سرد مقتضب وبلغة تغلب عليها الروح التقريرية تغزوها اختراقات شعرية متفرقة. قلَّما يسمح بالإسهاب عبر مشاهد قصيرة مكثفة تصل إلى ستة وعشرين مشهداً، تشكل بنائياً رواية قصيرة إذ يبلغ عدد صفحاتها 103 صفحات. بنيوياً، يُبئِّر السارد لحظة تسليم عبد القادر نفسه للسلطات الفرنسية، ليجعل منها محطة ثابتة يتحرك السرد حولها، يرتد منها للخلف للاسترجاع وللأمام للاستباق لكن دون أن يزحزحها عن مركزيتها كبؤرة الحدث الروائي.
عبد القادر وبوليفار: تقاطع روائي
مثلما توقف غابرييل غارثيا ماركيز في روايته التأريخية «الجنرال في متاهته»، التي قاربت خروج سيمون بوليفار الأخير باتجاه منفاه، أمام علاقة بوليفار بنهر ماجدلينا، في علاقة «شعرية» تتجاوز بعدها النصي لترتد إلى ماركيز نفسه وعلاقته الخاصة بنهر طفولته، يتوقف الجماعي أمام البحر الجزائري، هو المولود، كسلفه، في الغرب الجزائري. يتوقف أكثر من مرة عند هذه العلاقة، فالبحر هو، للمفارقة، مكان استقبال الغرباء ووداع أصحاب الأرض، وهو المكان الذي لا يعرفه من يطلون عليه ويعيشون على شرفه: «جلهم لم يعرفوا البحر من قريب ولم يلمسوا زبده الأبيض أو الرمادي ولم يستنشقوا روائحه ولم يعرفوا طعم ملحه، ولم يختبروا ضراوة أمواجه وصلابة صخوره، وانعكاساته المبهرة أحياناً». وحده عبد القادر، من بين أنصاره، يعرف البحر كقرينٍ لمطلع العمر وجسرٍ نحو «المقدس» ممثلاً في رحلة الحج التي تصب في «مكة»: وحده الأمير عرف في سن التاسعة عشرة من عمره هدوء البحر وغضبه عندما قصد مكة مع أبيه للحج. لقد انتهز فرصة السفر للحج، الذي دام سنتين لطلب العلم في الكثير من مدن الشرق».
سيقترب البحر عما قليل، وسيقترب الاقتراب الشعري منه: «في هذا اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر 1847، أصبح لهؤلاء المقادين إلى المنفى نظرة مختلفة للبحر، النظرة الحقيقية لهذا البحر، الذي سيركبونه بعد حين. حتى هذه الساعة بقي في نظرهم سراً عميقاً أزرق لا يمكن سبره، ممتداً إلى اللا نهاية. أمواجه ولججه تهديد دائم، غول ذو جلد بارد التهم الآلاف من البشر وبلع يونس. اسم ذكر في القرآن ست مرات، يمكن أن يكون رحيماً وكريماً لأنه يطعم الناس ويكون المطر لإخصاب الأرض. بحر غدار وقاس على ضفته عدو احتل المدن الساحلية». هذا البحر نفسه سيفقد صفته عما قليل ليتحول من أفق مفتوح إلى باب مغلق: «بعد قليل، عند غروب الشمس سيصعد سبعة وتسعون شخصاً من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ ويرحلون دون أمل في العودة. تتمزق الأمواج وراء السولون ثم تنغلق كباب سميك. في سجنهم الضيق العائم على هذا السهل السائل الرمادي الممتد المتموج، الذي ينفتح أمامهم إلى اللا نهاية، يستبد بهم الشعور بالوحدة، رغم هدير المحركات الحاد ورائحة المخازن وبين الضباط والنوتية والبحارة. يمتد أمامهم أفق يتأرجح مثل سعفة نخيل في الهواء». إنه البحر نفسه الذي قُتِل على ساحله جزائري فقير بمدية فرنسي لا مبالٍ في «غريب» ألبير كامو، وهو البحر الذي يتأمله الرقيب «جوزيف روير» كأنه يختصر وجوده، ليحوّله من عامل لبناء السفن إلى عسكري يمثل أحد شهود الاستعمار الفرنسي للجزائر، وأحد أكثر من اقتربوا من لحظة نفي الأمير عبد القادر عن أرضه.
تتقاطع «ليلة الأمير الأخيرة» مع «الجنرال في متاهته»، في أكثر من منحى آخر، موضوعياً ونصياً، تجعلها قابلة لقراءة سياقية، على اختلاف المعالجة الإجمالية للشخصيتين التاريخيتين روائياً. نحن أمام محررين، سلطتين مكانهما الظل، نواجه اللحظة نفسها في النصين: لحظة رحيل بوليفار مع عدد من أتباعه لمنفاه، عبر نهر مجدلينا، ولحظة رحيل الأمير منفياً مع أتباعه أيضاً عبر البحر المتوسط. ونحن في النصين أمام السلطة المغدورة وقد طعنها أنصارُها بالذات بل واتهمت بالخيانة فلم يتبق لها سوى بقايا مُصدِّقين أقرب لحاشيةٍ عبثية تُرجِّع صدى «سانشو» رفيق «دون كيخوت».
كلا عبد القادر وبوليفار يُضاء روائياً في لحظة الهزيمة كمخلِّص، وقد انتهت رسالته فيما لم ينته عمره بعد. كلاهما الشخصية المتصوفة والقارئة التي تخوض مكائد السياسة بحفنة كتب وأفكارٌ تطفو فوق الواقع. كلاهما يترك نصوصاً مكتوبة كأنه الشاهد الأول على ما جرى له، أو كأنه، بالأحرى، مؤرخ نفسه. الخيانة نفسها في الحالتين، والمستعمر سواء نطق بالإسبانية أو لهج بالفرنسية يمد يداً ليغلق الباب خلف فردٍ يُمثِّل جميع أشباحه.
فنياً، تنهض كلا الروايتين على رحلة، تمثل العصب السردي في النصين. الرحلة هي المبرر الفني لاستدعاء ماضيها ومستقبلها كونها حُبلى بالزمنين معاً، وكلاهما بالقطع تنطلق من التأريخي نحو التخييلي. في المسافة بين أرضين تتحقق البؤرة الروائية لليلة الأميرالأخيرة كما في «الجنرال في متاهته». إنها البؤرة التي يدور السارد حولها ليعود إليها، في موجات سردية تكاد تحاكي البحر الذي يمثل الدال الأبرز في نص الجِماعي. فصول «ليلة الأمير الأخيرة» أشبه بموجات تتقدم وترتد، مبتورة ومبتسرة في بعض الأحيان، مفاجئة وبلا رابط سببي يجمعها بما سبقتها أو بما ستتلوها، مثل صفعات سريعةٍ معبأة بمعلوماتية تقريرية تحتشد بالوقائع والتواريخ والأسماء، تتراجع كل منها لتفسح لأخرى سيلاً جديداً من المزق التوثيقية، لنجد أنفسنا، أمام نصٍ ملتفت للتأكيد على روحه التوثيقية.
مراوحة التوثيق والتخييل
تتخذ الرواية منحى وصفياً يقربها من الروح التسجيلية غير الروائية، حتى أنها تبدو في عديد فصولها تأريخاً وصفياً لا يتقدم بحدث قدر ما يستعرضه أو يكشف جانبه التوثيقي. من هذه الروح تتشكل الرواية، العامرة بتضمينات لشهود الوقائع، تحضر داخل اللحمة السردية كتعليقات سريعة ملتبسة بصوت السارد، فحين يصف السارد «الزمالة» المرافقة لعبد القادر يمزج صوته بتعليقٍ توثيقي: «تنتقل هذه الخلية العظيمة من نقطة ماء إلى أخرى، ومن مرعى إلى مرعى. لقد شبهها الجنرال (برايل) الذي شارك في تفكيكها بسفن نوح». في موضع آخر، تستخدم الطريقة نفسها لدى الاقتراب من الأمير: «من عادة عبد القادر عندما يخرج من خيمته أو يتجه نحوها يحرض جواده، فيعدو بسرعة مسافة عشرين أو ثلاثين متراً. شهد بذلك «ليون روش» مفسر ومترجم معاهدة «التافنة» التي كرست فترة من الهدوء بين المتحاربين».
في مواضع أخرى ينفتح التوثيق ليصل الواقعةَ الروائية بسياق ما يحدث في العالم في اللحظة ذاتها، مؤطراً إياها بلحظتها السياقية الأشمل كأنما يوسِّع من أفق عدسته فجأة ليعرض لقطة بانورامية للّحظة التاريخية: «بدأت الحملة العسكرية على الجزائر، في نفس السنة نشر ستاندال «الأحمر والأسود»، وقُدِّمت على خشبة المسرح الفرنسي معركة «هرناني» الشهيرة لـ»فيكتور هوغو»، واشتهر «هكتور برليوز» بسيمفونيته العجيبة، ودخل لامرتين الأكاديمية الفرنسية، وتعرض مؤلف البؤساء الذي يجابه عقوبة الإعدام إلى الإبعاد».
من هنا، يبدو السارد أقرب لكاتب تقرير، أو محقق، ينهض باستطلاع مدعوم بمصادره التاريخية وشهوده. ساردٌ/ مؤرخ عصري يعتمد بشكلٍ رئيسي على «التوليف» بين الأصوات المؤرِّخة في تقاطعها مع صوت السارد الرئيسي الذي يحافظ قدر الإمكان على لغة باردةٍ (تلائم مؤرخاً بدورها) قلما تنزلق إلى الانفعال وإن كان المؤلف الضمني، بلا مواربة، يقدم نصه كمنحاز ومتعاطف. تحتشد «ليلة الأمير الأخيرة» بالشهود، من الجنرال لامورسيير للقوّال بشير الوهراني، ومن المبشر شارل لفيجيري للشاعر أرتور رامبو. يحضرون بآثارهم، المتمثلة في تعليقاتهم المباشرة، حيث «وحدها الآثار تجعلنا نحلم»، مثلما تؤكد عبارة تصدير الرواية التي اجتزأها الجماعي من «روني شار».
عبر هذه البنية، تجمع «ليلة الأمير الأخيرة» مزق النصوص وبقايا التعليقات، غير مكتفية بكتب التاريخ المغبرة، أو الأقوال المتناقلة، بل وقصاصات الصحف الفرنسية المواكبة، كأنها تستحضر صورة الأمير عبد القادر الجزائري من أرشيف العالم لتعيد رسم وجهه، ولترى عن قرب العينين الزرقاوين لرجلٍ لا تعرف بلاده زرقة العينين، ولم يعرف هو نفسه تلك الزرقة سوى في بحرٍ أقلّه من منفى الأنصار إلى منفى الأعداء.