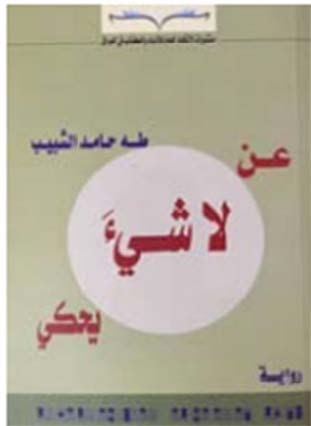القسم الثاني
د. سمير الخليل
فالشيء الذي لا يُرى لا يستطيع المرء أن يقطع ويجزم بوجوده، هذا يعني أنك لا تستطيع أن تقول عن الشيء هذا هو الشيء الفلاني إلا إذا حددت صفاته بالضبط، وإذا لم تقدر أن تحدد صفاته بالكامل، فوجوده ناقص في نظرك ونظر الجميع، والشيء الناقص شيء غير موجود، ولأن “الأعمى” لا يستطيع أبداً أن يحدد مئة بالمئة صفات الشيء، أي شيء، لأنه لا يراه، فهذا يعني أنه يتحدث عن شيء وجوده غير مؤكد بالكامل، يعني أنه يحكي عن لا شيء، والحكي عن اللاشيء حكي لا ينتهي، لأن هذا اللاشيء كبير جداً: ((قصدي تستطيع أن تؤشر على الشي وتقول هذا هو الشي، أما اللاشيء فهو غير واضح المعالم ووجوده غير معروف. هذا يعني أنك لا تستطيع أن تؤشر على اللاشيء وتقول هذا لا شيء. إذن نقدر أن اللاشيء ليس له حدود واضحة، معنى كلامي أني سأبقى أحكي لكم حكايتي هذه التي تدور حول لاشيء إلى أبد الأبدين)). (ص165).
أثارت تلك المسألة مشكلة مهمة تتعلق بجنس الرواية وموضوعتها النوعية. لو أخذنا كل الوقائع كما لو كانت وقعت بالفعل (وهي قابلة للوقوع في المجتمعات الفقيرة والمختلفة) فإنها ستكون غير مقنعة لحادثة رمزية، ولكن، ولو أن الأعمى “حمادي” قد حلم بها، إذن، فهو فرد واع قادر على الحلم، إن مشكلة “لا شيئتيها” هي أنها تبدو حكاية رمزية وحلماً لأن السارد أعمى، كما لو أن شخصية واقعية قد دخلت الى واقع رمزي تخييلي جداً لدرجة أنه لا يوجد تفسير له إلا أنه حلم، ربما تكون حكاية “حمادي” الأعمى هي تحقيقاً لرغبات مكبوتة، معظمها رغبات أيروتيكية: كتابة حلم يشبه السياق الحقيقي للحلم، بكل تناقضاته، وتغيراته الغريبة، التي تؤخذ كشيء طبيعي، شذوذه وتشتت ذهنه، ومع ذلك، ذات فكرة رئيسة تجري أحداثها من خلال الرواية كلها، مثلما تشير بعض التلميحات والتصريحات من أمثال: نومه في غرفة البنات منذ طفولته وحتى بلوغه ونضجه، مشاركاً أخته “حمدية” الفارعة الطول، الهيفاء، صاحبة العينين الزرقاوين والشعر الأملس الحرير سريرها، وليس أخته الأخرى “رضية” التي لا تنافس الأولى بجمالها ورائحتها الطيبة ورقة لمساتها، مع العلم أن هناك غرفة مخصصة للأولاد الذكور وفيها متسع له.
ثم علاقة حبه للحسناء العمياء “زهرة” صاحبة العينين الخضراوين والجسد البطن الأسيل، فقد إلتقى بها في إحدى جولاته في متاهة المدينة، وكانت تمتهن الإستجداء، وبمرور الوقت توطدت علاقته بها وأخذ يستدرجها الى الجلوس بقربه أمام الباب الخارجي لدارهم مثلما هي عادته في حراسة الدار. وهنا، وتحت جنح الظلام (كل إندفاعاته الأيروتيكية تحدث في ظلام الليل بالرغم من أنه أعمى يستوي عنده الليل بالنهار ولكنها تحدث بضغط الحلم والإستحلام)، وتسامح المجتمع في عدم مراقبته، يبدأ بتحسس كفيها اللدنين أولاً، ثم ساعديها، ثم فخذيها ليصل الى ذروة النشوة مما يؤدي الى فيضان الرطوبة اللزجة ما بين فخذيه. وحدث ذلك لمرات عدة، حتى بعد أن نبهته أخته “حمدية” الى أن “زهرة” هذه هي أمه وليست امرأة غريبة يستطيع أن يعشقها، وأمه هذه اسمها كذلك “زهرة” وهي تعودهما وتتفقدهما بين الحين والآخر لتطمئن على صحتيهما ومواصلتهما للحياة بعد تطليقها وهجران باقي العائلة لهما، ولكنه أبى أن يستوعب هذه المعلومة وواصل ممارساته اللمسية غير البريئة لكفي وفخذي “زهرة” حتى وصول الى لذة البلل. ولم يكتف بذلك بل تجرأ وفاتحها برغبته في الزواج منها.
كان المؤلف الحقيقي (نحن واثقون من ذلك) على دراية تامة بالمنطقة المحايدة ما بين العالم الواقعي وأرض التخييل، قد يلتقي الواقعي والتخييلي، ويطبع كلاً منهما بطبيعة الآخر. وما اكتشفه المؤلف من أنه الحقيقة البشرية أكثر تعقيداً وصعوبة مما يظهره أي تفاعل اجتماعي، فالحقيقة البشرية الصحيحة هي في الغالبّ تختلف عن الواقع الإجتماعي اليومي إختلافاً بيناً.
تعد “قوة العناد” أنموذجا واضحاً لقوة الشخصية، والعناد يقف وراء المبادرة الأساسية في الكتابة الروائية (من المؤلف الحقيقي) وفي سردها (من السارد العليم)، ومن غير “العناد” تبقى الرواية محض فعل لا يمكن تفسيره، لا بطريقة واقعية ولا سايكولوجية.
تبدأ الرواية بصيغة تحدٍ، لوصف حالة الشخصية المحورية وهو يتحلى بالعناد كفعل من أفعال الروح الحيّة، المتسامية، المتمردة على تقاليد المجتمع، وهو مبدأ فروسي بطولي من الأفعال المفارقة التي تميّز الإنسان المتعالي على ضعفه وهشاشته، وفي الرواية، هو شي تناقضي. فالعنيد في الرواية أعمى، مقهور، ومهجور، وجائع، وعمره قد وصل الى السبعين عاماً. ولأننا إزاء شخصية متميزة في كل شيء، فلا يوجد مصطلح آخر أكثر خصوصية نلصقه به غير “العنيد”. ولنقرأ هذا النص المستل من الصفحة الأولى للرواية :
((شباب المحلة يمرون به من حين لآخر، يسعفونه بلقيمات مما يأكلون في بيوتهم، إلا أن أحداً منهم لم يخطر بباله أن يسقيه خمراً، وحدنا نحن الأربعة من جلب له يوماً قنينة عرق صغيرة مع صّرة الطعام. وإذا إستساغ طعمه، بعد أن لاقى عنتاً في تجرّع الرشفات الأولى، طلب منا، وسط قهقهاتنا، ألا ننقطع عن زيارته، ثم وهو يضحك يجاري قهقهاتنا قال: ولكن إقسموا لي على ألا تخبروا أهل المحلة بما حصل الليلة، فإنهم سيقطعون عني الطعام)).(ص5).
مع مناقشة مبدأ العناد بوصفه هوساً ليس له دافع محدد، وحتى نضرب أمثلة على ذلك، فإن السارد السبعيني الأعمى والوحيد تماماً غير البعيد عن “جهنم العناد” أصبح، وبمساعدة الخمرة وتشجيع الندماء، سارداً مهووساً وشغوفاً بحكايته، يبرر بطريقة دبلوماسية ومرنة الدافع الموضوعي الذي يقف وراء عناده لتبرير مواصلته سرد حكايته، ليلة بعد ليلة، حتى النهاية، وليس هناك إثم أو ذنب يطاله نتيجة لعناده، لكنه –بالأحرى- نتيجه لإعترافه بعد كل تلك العقود من السنين، لم يشتبه به فيها بأنه: مغفل، حمار، قواد، مثلما كان فتيان المنطقة يوصمونه بها، فقد عاش وهو يشعر بالأمان، لأن أخته “حمدية” كانت تتحرك بأمان وقد ركبها “عفريت العناد” وهي تطارد حبيبها “حمزة” أينما حل وإرتحل، في جميع الجهات، وكل يوم تقريباً. إن كان بذاكرة أو بدون ذاكرة.
وحالما إنهار حاجز الأمان في داخل “حمدية” ازداد منسوب العناد لديه. فجملة (أنا آمن إذا كانت حمدية آمنة) بدأت تتقوض، وتقوض معها الأمان فمعرفته بأن أمان ً”حمدية” إنهار، وعنادها في متابعة قضيتها قد انهار بانهياره أشعره أنه مرغم على زيادة منسوب عناده لحمايتها، ورافق ذلك الإيحاء بالاعتراف بالرغم من كل المحظورات والمحاذير، ويعد العناد بالنسبة لـ”حمادي” الأعمى تناقضاً آخر، لأنه من غير المعقول بالنسبة إلى العناد وإن كان حقيقة أن العقل يحفزه. ففي الظروف الصعبة القاسية يتلبس العناد حتى الكائن القميء، ضئيل الشأن، المعوق والمريض، فالعناد ركن أساسي من أركان نظرية “التحدي والاستجابة” التي قُرأ تاريخ البشرية بكامله في ضوئها.
إن ما يجعل من (عن لا شيء يحكي) رواية موحدة ذات مغزى أكثر من كونها مجرد تأليف سردي بسيط ، هو إيمان الروائي “الشبيب” بأن الواقعية الحقيقية ليست مادية ولا اجتماعية، بل ثقافية، فالرواية تبدأ بدخول السارد إلى عالم “اللاعدالة في توزيع الثروات” الذي هو عالم الرواية ذاتها، ويلاحظ أن الخراب والتصحر الذي يحيط بالمنزل المقوّض (منزل الأسرة المنكوبة) يعد صوراً أنموذجية تضاف إلى صور الخراب والتصحر النفسي الذي يعصف بدواخل الشخصيات. إن تلك المناظر القاحلة تجسّد عالماً روحياً مرعباً معزولاً عن الواقع اليومي المعتاد، إنه البيت المقوّض نفسه، ولأنه واقع مجسد واستعارة أدبية في آن واحد فإنه يسبب صعوبة في تفسير السارد الذي يقوم بتهديم البيت بعد انتحار أخته (حمدية): ((ثم أهوي بالفأس مباشرة على الحائط واقتلع أول طابوقة منه، لا أدري أين تسقط، فالذي يقتلعها أعمى، ثم لماذا يهمّني أين تسقط الطابوقة التي اقتلعها من حائط الشرفة أو من حيطان الدار؟ فأنا، في واقع الأمر، ابتدئ الآن بهدّ الدار إلى الأرض، أهدّها كلها بالكامل إلى الأرض))(ص293). وبرر ذلك الإحساس غير المحتمل بأنه غير واضح بوساطة العاطفة الشعرية التي تتيح للفرد –عادة- تقبّل أكثر الصور الطبيعية صرامة من حيث الكآبة والفظاعة، علاوة على ذلك، فإن البيت ينشيء مثل ذلك الإحساس: ضيق في التفكير لا يمكن التخلص منه، وأنه لا يوجد حتى ثقب في مخيلته يستطيع التحليق من خلاله، وهنا يطرح السؤال الأنطولوجي الأساس عن البيت ومن ثم الرواية برمتها: ما الأمر الذي أراد “حمادي” أن يبرهن عليه من وراء تقويض البيت؟ هذا هو “اللا شيء الجوهري” الذي أراد السارد العليم ومن ورائه المؤلف الحقيقي أن يوصله إلينا.