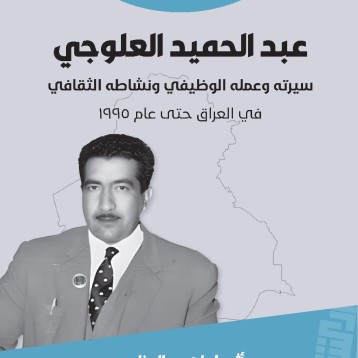إلياس الطرييق
الشرق والغرب لعلهما ليسا موجودين سوى في الخريطة، سوى في أذهاننا، أما الواقع فشيء آخر. لطالما كان الإنسان المشرقي مسكونا بأخيه المغربي والعكس صحيح. ومنذ قديم الزمان شد المشارقة الرحلة إلى بلادهم المغرب، كما شدها إخوانهم المغاربة إلى بلادهم المشرق. ومن هنا فإن الإنسان المغربي ظل ولا يزال مشدوها إلى المشرق العربي باعتباره آخرا مشوبا بملامح الذات، يمثل شطرها الثاني ثقافيا وروحيا وأدبيا.
«القاهرة من أبواب متفرقة» عنوان يذكرنا بقول يعقوب لبنيه عليهما السلام «لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة» وذلك في طريقهم ليمتاروا الطعام في مصر. عنوان يوحي بمشرقية القصد وبتناص نبوي قرآني موازي. عنوان حامل لمحمولات كثافة المعنى في صلتها بالمكان، وتعدد الفضاءات ورحابتها، يوحي للقارئ بأن المكان مشرع في وجه خطى الرحالة، وكأن المدينة فتحت سائر أبوابها لهذا الزائر، ودفعته نحو غواية الدهشة والاستكشاف والتيهان.
ادخلوها آمنين: «دخلنا مصر إذن، بي شعور جذلان بأن الملائكة تحلق فوق القاهرة من علو مغمور بعطر الأبدية. أتاني بما يشبه الهمس: ادْخُلْ تَصْفُ». هذا شرط من شروط الدخول، شرط الصفاء الذي من خلاله تستطيع أن ترى الأشياء المرئية، والأشياء لا مرئية تستطيع أن ترى انعكاساتها، تجلياتها، آثارها، تستطيع بعد أن تتخلص من أردان صورك المسبقة، أن تلتقط إشارات مثل هاته، هامسة، خافتة، تطلب منك التقدم، حث السير، وتميط اللثام لك عن مكنونات وأسرار الغرائبي، في الناس، المدينة، في المقيم، والعابر، في الثابت والمتحول. هكذا إذن لكل بقعة سحرها الخاص، كما لكل بقعة شرطها الخاص.
ينقلنا هذا المحكي السفري الوجيز في المسافة والكلمات إلى عالم ملون بألوان القاهرة الموغلة في القتامة والقدم؛ من قاهرة المعز إلى قاهرة الخديوي إسماعيل، من خان الخليلي إلى ميدان طلعت حرب حيث تختلط المشاهد بالروائح والأصوات والوقائع والغرائب أيضا. في بضع صفحات وملحق للصور نسافر إلى هذه المدينة المغسولة بالبرونز المحيل على متاحف المصريين القدامى والتي تختزل بلدا بأكمله يسمى مصر، مصر التي ورد ذكرها مرتين كاسم بلد وحيد في القرآن، وذلك لرمزيتها الكبيرة في الشرق القديم، وبوصفها مهبطا للعديد من الرسل والأنبياء. نرتدي بدلة السائح الهائم في تضاريس المكان، كانت مصر التي في خاطري: هكذا وصفها: «كنت ما إن أنزل صباحا من غرفتي بالفندق حتى أنخرط بروحي في الفضاء القاهري بأصواته التي تسيل وأمواج الأرض: أصوات بائعي الصحف ومناديل الورق، وهتافات سماسرة الكراء وأصحاب السلع المفروشة، وزعيق السيارات. وتحس بجسدك مع الوقت بطارية شحن تغتذي بحقل الصور الناقصة، بله بنهر من الحياة السيميولوجية ومباذلها المبهجة». هكذا هي مصر إذن؛ من خلال عاصمتها القاهرة، مدينة المباهج والضوضاء، ومدينة الإثارة التي تستطيع أن تأخذك من لبك، من ثنايا روحك، دون استئذانك.
في القاهرة تجسيد للغياب، واستعادة لأماكن في الذاكرة، استطاعت بسحرها الشرقي أن تفجر في الرحالة المسافر أشياء عديدة، وقدمت له أنباء عن الغائب والغياب: «أزعم أن القاهرة وسط البلد قد جعلتني أعيد اكتشاف فاس ومراكش مثلما يعيد الطفل تركيب أجزاء لعبته المهملة». البعد الصوفي في الرحلة واضح، يستمد وشائجه من روحانية المكان في الوعي الجغرافي للرحالة، الذي وجد في النزوع الصوفي إلى سيدنا الحسين ومسجد عمرو بن العاص، تخففا من تعب المدينة وإرهاق الوقت فيها، تجلى ذلك في التأثر الواضح بالعمارة الدينية الإسلامية، وكنيسة السيدة العذراء الملقبة ب»الكنيسة المعلقة». يقول صاحب الرحلة: «داخلتني رهبة، لأني لأول مرة أدخل كنيسة (…) ثم سرعان ما تفتحت نفسي لروحانية المكان الذي اغمره رائحة العطور، وتوقد الشموع في ركن منه، (…)، أشعلت شمعة اتقدت في عيني بـألوان عجيبة، ودعوت لي ولأهلي وللناس في كل مكان من العالم بالسلام والمحبة. ولعل هذا يترجم قيم المحبة والتسامح في كونيتها المطلقة دون تعصب أو طائفية، وهذا ما أكدته أبيات لابن عربي الشهيرة:
لقد صار قلبي قابلا كل صور
فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف
وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت
ركائبه فالحب ديني وإيماني
إننا بحاجة اليوم أكثر مما مضى إلى رحالة شبيه، متسامح، واسع النظرة والقلب، حيث يغدو الجميع بالنسبة إليه واحدا، والمختلف مؤتلف، والغريب قريب، والتعدد وحدة، والتنوع جمال ورحمة. لا تخندق ولا تحزب ولا تعصب، فالرحالة الواعي بحكمة التنوع في الخلق البشري هو الأقدر على لمس نبضاتهم، والغوص إلى أعماقهم، وبالتالي تقديم صورة مشرقة ومشعة، بله صادقة عنهم. رحالة يروي عطشه المعرفي والكوني باعتباره ذاتا غير منفصلة عن هذا العالم، عما يعيشه العالم، ويؤدي إما إلى خلاصه أو هلاكه. لا يمكن لأي خطاب أن يكون خطيرا ومقلقا اليوم، أثر من خطاب الرحلة، إذا هو تجرأ من الحياد، ونزع نحو الآخر لا باعتباره ذاتا مماثلة، وإنما ذاته مضادة، ويجوز سحقها، والسطو عليها فكريا وثقافيا.
في فصل بعنوان «عندما كان الزمن يكف عن السيلان» نقرأ: «كنت بين الفينة والأخرى أمد بصري في الصحراء، ويداخلني شعور غريب بأن الزمان يكاد يكف عن السيلان (…)، وحينا آخر قد يتحول إلى أمثولة عن العمى الذي يداهن حقيقة الصراع الذي يعتمل في دخائل النفس البشرية. مرت بذاكرتي كلمح البرق قصة موسى النبي، وشهودها، وسحرتها، وفرعون إذ يقول مستكبرا: «يَا أيُّهَا المَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرِي فَأوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أطَّلِعُ عَلَى إلَهِ مُوسَى وَإنِّي لَأظُنُّهُ مِنَ الكَاذِبِينَ» لعل هذه اللمحة تخفي الكثر والكثير؛ فهي من جهة إنباءٌ عن الغائب بالشاهد، واستحضار للغابر في الزمان عن طريق تمثل الحاضر وتأمله، وهذا من الدهشة بما كان، دهشة لها مفعول أشبه ما يكون بمفعول السحر، فيكون تأثيرها بالغا على العقل والحواس، وتستمر طويلا في الذاكرة لا تمحي، إنها نوع من القبض على المستحيل لا يمكنه الحصول إلا بالمعاينة والشهود، أي الحلول في المكان والتماهي لدرجة تتقلص فيه دورة الزمن فترتد على آثارها لتقف في الصحراء الشاسعة عند قصى موسى مع فرعون.
هي ذي القاهرة من أبواب متفرقة، رحلة مغربية إلى مصر تنضاف إلى سلسلة الرحلات المغربية الأخرى كرحلة محمد برادة، وعبد الكريم غلاب وآخرون، وإن كانت رحلة عبور ليس إلا وليست رحلة إقامة كما هو الشأن مع رحلتي محمد برادة وعبد الكريم غلاب، إلا أنها استطاعت التوغل في تخوم الإقامة، الإقامة في الزمن والنفاذ إلى عمق التجربة، مع استحضار البعد الصوفي والروحي للمزور إليه باعتباره مرتحلا لا يقل قداسة وربانية عن القبلتين الشريفتين، أرص مصر الشريفة الطاهرة المحروسة.
- كاتب مغربي