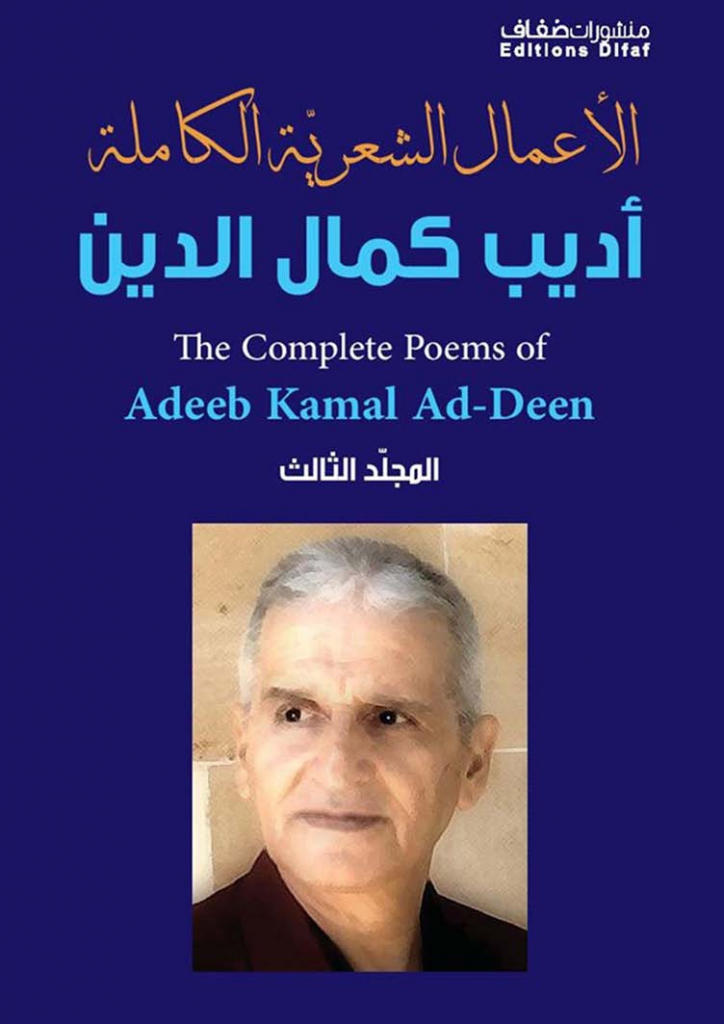في ديوان «أقول الحرف وأعني أصابعي»:
عبدالحفيظ بن جلولي*
تحتدم الصورة في عقل الشاعر، فيمررها بانتظام تشمله الفوضى والنغم، الضياء والعتمة وكل الأشكال التي لا يمكن لغير عقل الشاعر أن يتصورها، ولهذا كان الشعر على الدوام يمثل اللحظة التي يَعْبر فيها الشاعر إلى ذاته، إلى قصيدته التي يناور ويحاور من خلالها العالم، فهو بصورة أو بأخرى يحيل إلى ذاته، وتلك منظومة الإفضاء الشعري في قصائد «أقول الحرف وأعني أصابعي»- المجلد الثالث من الأعمال الشعرية الكاملة- للشاعر العراقي أديب كمال الدين.
بين الحرف والأصابع تنقال القصيدة: لا يمكن فصل الشاعر عن كورال القصيدة، وهي تتشكل في ريعان الصدى بين تهيؤ الشاعر في «أقول» وتشكيل حركة ما في «أصابعي»، لتخرج القصيدة معينة في إصاتة ما، وكأنها تتراقص في «مربد»، المكان لا يعين القصيدة، وحده شكل الشاعر يقف ظلا يبحث عنه «الحرف» الذي لا يعني في النهاية سوى شاعر عرف كيف يرسم منوال «أقول الحرف وأعني أصابعي». قد لا تكون القصيدة هوية الشاعر، لكنها تظل صورته التي انفلتت منه، ليقول بها ذاته، فردانيته في العالم، إنها تتشكل وفق نظام الأصابع في إحساسها المفرط بالأشياء: «ثمة خطأ في الأصابع»، هل تنشأ القصيدة مشوهة؟
تتمسرح الكلمة وهي تخض خيال الشاعر، تربك أصابعه، كما لو كان يلوح لشيء بعينه ويتبين أنه ليس هو، فترتبك هوية النص ليقول الذات في حقيقة قلقها وهي تراود الخيال، وليمة الكلمات، حين تفقد بوصلة المعنى فيعيد الشاعر رسم اتجاهه نحوها، القصيدة بمعنى من المعاني اتجاه الشاعر نحو ذاته، ليس بمعنى الهوية: «والرجوع إليكِ / يشبه قصيدة حب/ دون دموع أو أصابع أو حروف !»
يتجه الشاعر نحوه. ما تنسجه القصيدة هو اللاشيء الذي يشعره الشاعر، ومنه يستقي مادته، وفيه يشرك أشياءه لتحقق المسافة بين «أقول..» و«أصابعي»، أي بين الكلام باعتباره منصة العالم المتناهي إلى الظهور، والشاعر المهاجر إلى فراغه بعد انصرام القصيدة منه: «غير أنَّ أصابعي/ امتدّتْ إلى قلبي»، يبدو للشاعر أن القصيدة مسكنها القلب، لأنه لا يستطيع أن يغالب الإحساس الطاغي بالفردانية، الذي يعومه في لذة النشوة بالعالم وهو ينشطر، ويكشف عن جوهره في الكلمة، «أقول»، سر الشاعر الذي يذيب ما يحيطه ويشعل ما يشبه اللهب يضيء ما حوله، ريثما يتأكد حضور المتلقين، أقصد المتذوقين، الذين لا يرون في القصيدة شكلها، بل ذاك الذي أنجزه الشاعر «دون دموع أو أصابع أو حروف».
القصيدة تهرب بعيدا في الرقص:
التلبّس بطقس إنتاج القصيدة، مناخ تُستدعى فيه الحروف، كي تستمع عميقا إلى موسيقى الشاعر، وهو يعاين أمكنة العالم، ليجعل تفاصيلها تشبه أمسية نغم تكنس فيها الحروف حزن العالم، ليس معناه أنها سوف تنثر فرحا مكانه، قد تعيد أغنية الحزن نفسها، لكنها سوف ترقص على شجن مبتهج، يعكس فرح العثور على اسم متجدد للعالم والأشياء، إنه الرقص القديم الذي حرك الصحراء بمفرداتها، كي تشي بفراغها وتتحول إلى فضاء مهول من النغم، يتسرب متجددا إلى ذات الشاعر وهو يمنح هوية مختلفة للحروف: «وأنا النقطة: نبضكَ الذي يولدُ كلّ يوم/ في ثوبٍ جديد/ ورقصٍ جديد/ وعري جديد/ وموتٍ جديد/ حيّر الأولين والآخرين».
مسار القصيدة وجودي، تماما كما هي وجودية الشاعر، تتلمس القصيدة كينونة تتحدى بها ثبات اللحظات، فتجدد من تمظهراتها في مواجهة حقل الكلام، الذي تتغذى منه، ولهذا فالقصيدة لا تموت، لأن الكلام المعبر عن الموت غير مستقر عند مستوى الثبات النهائي، وهو ما قد يكشف الارتجال الشعري عند شعراء الرصيف المقولي: «وبدأت الحروفُ عاريةً تماماً/ ترقصُ وترقصُ وترقص/ رقصةً وحشيّة». لا تمتثل القصيدة لسكون لحظات الشاعر، إنها تلهو حين يكون حازما، وتموت حين يكون حيا، تتعرى حين يتستر، وخلال لعبة التبادل الكينوني، يبدو أن الشاعر وقصيدته، كما لو كانا في حفلة رقص صاخبة، لأن فردانية الشاعر لا تتحقق إلا بمصاحبته للكلمة الخالقة للمنتظم المقولي، حيث تتسلى الكلمة بسهو الشاعر وغيابه في الموجودات، فتثير جنونه غير المعني بالحضور، حينها لا يكترثان لشيء ويمارسان وحشيتهما بعنف وعمق.
يقود الشاعر أثر «الأصابع» ودينامية «الحرف» إلى حيث تسكن الرقصة تاريخ المعنى في الحكاية، إلى حيث يسكن «زوربا» هوية القفز على ألوان الغواية، فيكتب هوية المكان والزمن والحركة بمعيار فتنة الرقص: «سترقصُ إذنْ يا صديقي»، هل كان قرار زوربا بالرقص عفويا، أو كان مخططا له في رزنامة أنشطته الوجودية؟ يأتي زوربا معنيا بحضوره في فضاء مسكون به فقط، لهذا كانت المشاركة في حفلة الرقصة الفردية تعبيرا عن تواصل الأثر وتجاوزه إلى الآخر، لأن الحركة حملت هوية متجددة في الألم وفي الفرح أيضا، لهذا كان العالم كله معنيا بأمثولة الرقصة في مشهد عابر، كرّسه زوربا وأثث مشهديته الشعرية نيكوس كازنتزاكي:” سيحتاجكَ الوهمُ أو الموج (حسناً الموجُ أفضل) وسترفعُ قدمكَ إلى الأعلى/ ستبتسم..».
استدعاء زوربا، هو محاولة من الشاعر لاستدعاء طقوسية إنتاج اللذة، لذة الحكاية حين جعلت من الفضاء لونا من ألوان الحركة، امتد فيها الجسد الزُرْبَوِي، غير مكترث بوهم العالم أو بموجه. «الوهم والموج» اللذان يخلقان الفراغ، والقصيدة ليست فراغا، إنها فرح مأهول باليد وهي تترك أثرا في الفضاء، يستمر مغريا «القدم» كي ترتفع عن الأرض، وتهبط، فتضرب التراب معلنة عن نوع من التنبيه إلى ما يتركه الجسد من أثر في الفراغ، حينها يدرك الجمهور، أن المعنى في الكلمة لا يكمن في رسمها، ولكن في صوت وصدى يتركان أثرا: «رقصت عارياً كالسكّينِ وسطَ الظلام..»، ذلك هو أثر القصيدة، التي تهرب بعيدا في الرقص، غير مبالية بمن يرقبها، متعالية في قدم ترتفع عن الأرض وتشبه حد السكين، وهو يلامس الجسد في مشهد طقوسي يستند إلى وحشية الألم ليخلق وردة اللذة، ولم يكن ممكنا للشاعر أن ينتج هذه الطقس الراقص المنتج للشعرية لو لم يكن محملا بمشهدية إبداعية من كربلاء تاريخية.
تعبيرية الجسد ودراما الفضح:
يمكن أن يكون الشعر فعالية مسرحية، والمسرحة هنا بمعنى الحركة، إذ في المسرح تمنح تعبيرية الجسد معنى للمشهد، فكل الكلام على الخشبة (أقول الحرف) إنما يؤول إلى (وأعني أصابعي): «وكنتُ قربكَ ألبسُ قميصي/ القميص الذي لبستهُ طوال عمري/ حزناً عليك»، تنفلت هذه الكلمات في شعرية طاغية من سجن القصيدة إلى فسحة المسرح، باعتبار المشهدية الكربلائية، وتراتب الكلمات يكشف نوعا من الحركة، حركة حزينة لكنها قوية، القميص المستمر في التاريخ، إنما هو مسار لحركة جسد يتمثل الوعي التاريخي كمشهدية مصاحبة، وبالتالي يصبح الجسد ناقلا للوعي بالتاريخ وللدراما الإنسانية: «أم أنا طوطم افريقي/خُلِقَ ليبتهجَ بقرعِ الطبول؟»، فالألم الافريقي مازالت تنتجه الرقصة الطوطمية، وطبول الوعي بأهمية الجسد في استمرار إنتاج ذاكرة العبودية، فالجسد هوية تذكر في وعيها على حافة الوجود تاريخية العبور فوق جسر المأساة، التي قد تتدثر غشاء الملهاة، كما تترجمه الشابْلينية (شارلي شابلن) عندما تطل علينا من شاشة العالم تمسك بالجسد وحركة مليئة بالضحك في اهتزازها البندولي: «صباح الخير أيها الضحك/ صباح الخير أيتها القهقهة/ أيتهاالسخرية»، بهذه البداية تفتح قصيدة «صباح الخير على طريقة شارلي شابلن» صباح العالم على تعبيرية منفصلة تماما، عما يمكن أن تنتجه كلمة تعبير من وصف حالة أو كتابة واقع، إنها هنا جسد يمثل سياقا فعاليا يختزن حقيقة العالم وما تعتلج أعماقه به من مأساة/ملهاة: «صباح الخير أيها الكائن الصغير: بالقبعةِ المتحرّكةِ والعصا اللطيفة/ بالشوارب الهتلريّةِ والمشية المسليّة»، هو الشاعر حين يكتشف العالم من خلال الظلال التي تسكنه. الشاعر، يسكن قصيدة فوق أحلام المشي المخبأ في عبث العالم، بابتسامة وحركة بائسة تضحك على من يسيرون خلف أجسادهم كظل للمتعة واغتيال الحلم وحرمان الأرض من دفء الشمس، الشاعر، يتسلى بهؤلاء كما تسلّى الحسين والحلاج وشابلن ببلاهات الظل، الذي يسكن العالم وهم يضحكون عليه من علياء الألم، تماما كما يستهزئ الشعر بنعومة الواقع الزائفة.
٭ كاتب جزائري