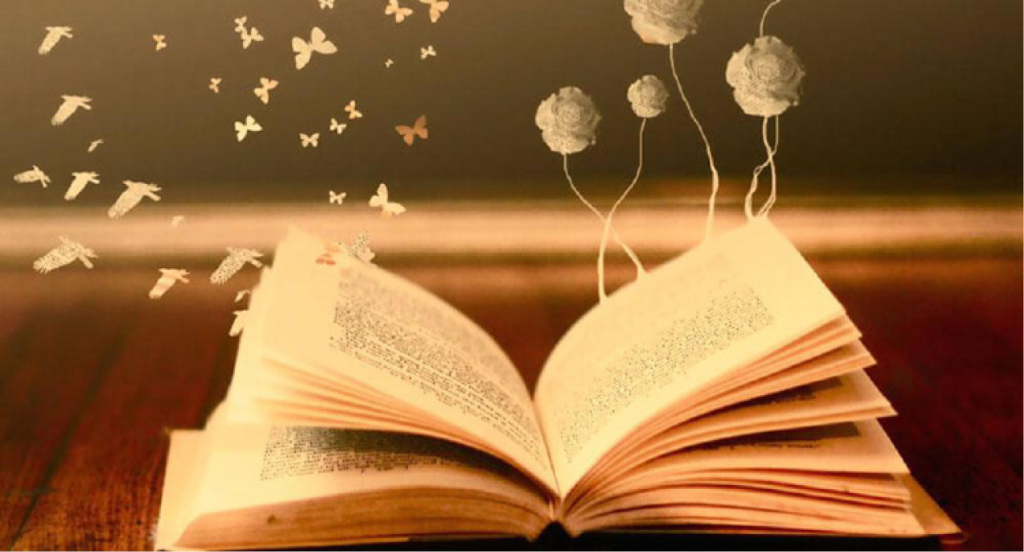هدى الهرمي*
يعدّ فنّ القصة واحدا من الفنون الأدبية الأكثر ترجمة لخلجات الذات الإنسانية، حيث عُرفت كتابة القصة القصيرة بإشكالياتها المختلفة والمغايرة للسائد نظرا لما تتميز به من قدرة على مواكبة الحياة رغم رمزيتها الفنية، لكنها تظل موازية للواقع ومتقاطعة معه، بتلك الرؤية الاستشرافية وتجسيد شواغل الطبيعة البشرية. وفي هذا السياق يقول القاص والناقد الايرلندي فرانك اوكونور صاحب «الصوت المنفرد» إن القصة القصيرة يمكن أن تعالج الحياة التي تبقى سرّا.
وهي تمثل لدى الروائي والقاص يوسف إدريس «بقعة الضوء الساطع» فهي بالنسبة إليه ملمحا مؤثرا من ملامح تجربته الإبداعية التي تراوحت بين القصة أولا ثم الرواية.
لكن من الملاحظ أن القصة القصيرة لم تجد لها مساحة نقدية في العالم العربي قادرة على استيعابها، كما هو الحال بالنسبة للرواية، وربما هذا يبدو جليّا في مسيرة الروائي العالمي نحيب محفوظ، وتواري القصة القصيرة، رغم ريادته وسابقيته في كتابة هذا الفن منذ بداية أعماله، وذلك بفعل غياب النقد.
وطالما لوحظ هذا النقص في التطرّق إلى القصة القصيرة، وإذا ما وُجد النقد فلا يمكن اعتباره أكثر من كونه نقدا انطباعيّا لا يرتقي إلى مصاف النقد الأدبي، بل مجرد محاكاة للظروف الاجتماعية والفكرية أو حتى الذاتية للقاصّ دون مراعاة لمنهج (أكاديمي).
لذلك وحسب الإشارة إلى معيار النقد وأهميته، لأن من أهمّ أهداف المنهج هو الإضاءة أو بالأحرى الكشف عن الجوانب الفنيّة المحاطة بالنص السردي، من أدوات لغوية ومدى تأثيره على المتلقي ليتخطى الأحداث أو بما يسمى الحبكة، فيصبح منهجا فكرا ورؤية متكاملة تغذيها لغة متفردة وطريقة مبتكرة لصياغة أسلوب حميمي خلاّق، وأيضا طرح شواغل القصة وأسئلتها إزاء فعاليات التقنية المستخدمة وإظهار جماليات القصة كنص أدبي.
لقد شهدت الساحة الثقافية مؤخرا العديد من الإصدارات القصصية القصيرة، ويُعدّ الأمر مهمّا وملفتا للنظر، في زمن طغت عليه مقولة «العالم يعيش عصر الرواية» ممّا يترجم عودة القصة إلى الواجهة واهتمام الروائيين وحتى الشعراء بكتابة القصة رغم توجه العديد من النقاد للتخصص في نقد الرواية. ويشير القاص والروائي الكويتي طالب الرفاعي إلى عودة فنّ القصة خلال السنوات الماضية، وأن مصدر حيوية هذا الجنس الأدبي هو قدرته على تجسيد الهمّ الإنساني اليومي العابر إضافة إلى تشبّع السوق بنتاج الرواية.
إن الثيمة المحورية التي تنهض عليها القصة القصيرة هي الاستقصاء الحسّي والفني والفلسفي والاجتماعي، وهذا يستوجب أيضا تقنية خاصة والأخذ بمبدأ القاعدة التي تقوم عليها وحدة الحدث والحبكة مع اعتماد التكثيف والاختزال.
وأبرز ما يميزها هو الخلاصة أو الذروة. وهذا يعني أن ما يناسب القصة القصيرة لا يناسب الرواية، مع الاشتغال على المفارقات ونسج منطق خاص.
وقد أشار القاص والناقد الارجنتيني انريكي أندرسون امبرت إلى قيمة التركيز في القصة القصيرة مقارنة بالرواية على صفتين «الإيجاز والأهمية الأساسية للحبكة». ناهيك أن القصة القصيرة كفنّ تعبّر عن صخب الحياة المعاصرة، ولذلك وجب إبراز هذا الجانب المهمّ من خلال الدراسة والنقد في خضم الزخم الوافد من شتّى الأجناس الأدبية كالشعر والنثر والهايكو وأيضا القصة القصيرة جدّا، حتى لا يحصل طفو نوعي أدبي على الآخر.
ومن هنا، يصبح الأمر الأكثر إلحاحا، هو التطرق إلى سؤال الأزمة التي تحاصر القصة القصيرة وأنه بقدر من التأخر في خوض مسألة النقد ورصد أبعاده ومناهجه. لذا توجب على الناقد أن يكون مُطّلعا على المناهج النقدية، وأن يختار منها الملائم لتحليل القصة، وتقديم رؤيته الأكاديمية. فقد آن الأوان أن تكون له سبله الخاصة في تناول هذا الجنس الأدبي، بجرأة لازمة للتجاوز والتغيير والبحث عن منافذ ومداخل جديدة دون سقوط في منحدر التبعية الغربية أو الاستكانة إلى الموروث.
إن الناقد ملزم أمام المتلقي – على الأقل – بتوضيح جماليات القصة بنظرة خالية من التبجيل والتقديس لأي مرجعية أو طرف، فقط التوجه إلى هذا المنتوج الفنّي وتحقيق معادلة النقد في إظهار النص الأدبي وتمحيص الجيّد من الرديء، وبالتالي إبراز تقنياتها ولغتها وفعاليات التقنية المستخدمة لسرد القصة المتخيلة والتطرق إلى رمزيتها وتأويلاتها.
- كاتبة تونسية